
الرؤية الرأسمالية للذكاء الاصطناعي: الربح، السلطة، والسيطرة
رزكار عقراوي
المقدمة
يُعدّ الذكاء الاصطناعي من أحد أبرز ابتكارات الثورة الرقمية الحديثة، حيث وفر إمكانيات هائلة لتعزيز الإنتاجية، وتطوير العلوم والخدمات العامة، والمساهمة في حل العديد من التحديات التي تواجه البشرية. وقد أحدث تحولات جوهرية في مختلف المجالات، مما جعله ركيزة أساسية في تطور المجتمعات الحديثة.
الذكاء الاصطناعي هو فرع متقدم من علوم تقنية المعلومات، يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري من خلال الحوسبة الفائقة والبرمجيات الذكية. يعتمد على خوارزميات متقدمة وتقنيات تعلم الآلة والتعلم العميق لتحليل البيانات، والتعرف على الأنماط، واتخاذ القرارات بشكل مستقل أو شبه مستقل وفقًا للمدخلات والمعطيات المدخلة إليه.
كما يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة وإعادة تدوير البيانات الضخمة التي ينتجها المستخدمون والمستخدمات، مما يمنحه قدرة متزايدة على التكيف والتطوير الذاتي. تُستخدم هذه التكنولوجيا اليوم في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الطب والرعاية الصحية، حيث تساهم في تشخيص الأمراض وتحليل البيانات الطبية، والتعليم من خلال تطوير أنظمة تعليمية تفاعلية، والصناعة، والاقتصاد، والإعلام، والنقل، والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استخدامها في المجالات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك الرقابة والسيطرة الفكرية والسياسية وتطوير الأسلحة.
عند الحديث عن أنواع الذكاء الاصطناعي، يمكن التمييز بين عدة مستويات من التطور، وذلك حسب طبيعة المقارنة. النوع الأكثر شيوعًا اليوم، مقارنة بالذكاء البشري، هو الذكاء الاصطناعي الضيق، والذي يُستخدم لأداء مهام محددة مثل الترجمة الفورية، التعرف على الصور، أو تشغيل المساعدات الصوتية، او التدقيق اللغوي وتوليد النصوص وغيرها. هذا النوع يعتمد على بيانات محددة ويعمل ضمن نطاق معين دون القدرة على تجاوزه.
أما الذكاء الاصطناعي العام، فهو مفهوم أكثر تطورًا ويهدف إلى إنشاء أنظمة قادرة على التفكير وحل المشكلات في مجالات متعددة بنفس الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري. أما الذكاء الاصطناعي الفائق، فهو مستوى نظري مستقبلي يُتوقع أن يتجاوز قدرات الإنسان في التحليل والإبداع واتخاذ القرار، لكنه حتى الآن لا يزال ضمن نطاق الخيال العلمي والدراسات الافتراضية، أو لم يُعلن عنه بعد، وذلك كما هو الحال مع العديد من التطورات التكنولوجية التي عادةً ما تطور وتُستخدم سرًا في الأغراض العسكرية والأمنية قبل أن تصبح متاحة للجمهور. فالتاريخ يشهد أن الإنترنت والعديد من التقنيات المتقدمة الأخرى لم تُكشف للعامة إلا بعد سنوات من استخدامها في الأوساط العسكرية والاستخباراتية والصناعية المغلقة.
هذه التقنية لا تعمل في فراغ، وانما تتأثر بتوجهات الشركات والحكومات التي تطورها، مما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعتها الحقيقية والجهات المستفيدة منها. واستنادًا إلى ذلك، فإن هذه التكنولوجيا لا تتطور بشكل محايد، وتعكس البنية الطبقية للنظام الذي أنتجها. فالذكاء الاصطناعي، كما هو مطور اليوم، ليس كيانًا مستقلاً أو محايدًا، وانما يخضع بشكل مباشر لهيمنة القوى الرأسمالية، التي توجهه بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية.
وكما أشار كارل ماركس وفريدريك إنجلز في البيان الشيوعي:
"لم تترك البرجوازية أي رابطة بين الإنسان وأخيه الإنسان إلا رابطة المصلحة العارية، والتعامل النقدي القاسي... لقد جعلت الكرامة الشخصية قيمة تبادلية، وحوّلت كل شيء، بما في ذلك المعرفة، إلى مجرد أداة للربح."
وهذا ينطبق تمامًا على الذكاء الاصطناعي، فعلى الرغم من دوره وأهميته الكبيرة، فقد تم تسليعه الآن ليكون أداة لتعظيم الأرباح وتقوية السيطرة الطبقية. إن التطوير الحالي للذكاء الاصطناعي لا يمكن فهمه باعتباره مجرد تقدم تقني، بل هو جزء من منظومة السيطرة الطبقية التي تسعى من خلالها الشركات الكبرى والدول الرأسمالية إلى تعزيز الأرباح، وتركيز الثروة، وإعادة إنتاج علاقات الإنتاج القائمة.
فالخوارزميات التي تدير هذه الأنظمة موجهة أيديولوجيًا لخدمة مصمميها، حيث تُسخَّر لتعظيم الإنتاجية، وتعزيز تفوق الشركات الاحتكارية، وترسيخ القيم الرأسمالية. وهكذا، تتحول هذه التقنيات إلى أدوات جديدة لاستغلال القوى العاملة وإدامة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بدلًا من أن تكون وسيلة لتحرير الإنسان من شروط الاستغلال.
لقد بات الذكاء الاصطناعي سلاحًا مركزيًا في يد رأس المال، حيث يُستخدم لتقليص الحاجة إلى العمالة البشرية، مما يؤدي إلى تفاقم البطالة أو دفع شغيلات وشغيلة اليد والفكر إلى قطاعات أخرى، وتعميق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن احتكار هذه التقنيات يمنح الشركات الكبرى قدرة غير مسبوقة على التحكم في الأسواق، وإعادة تشكيل الرأي والوعي العام، وفرض رقابة رقمية شاملة على الأفراد والمجتمعات، مما يكرّس نظامًا تصبح فيه الجماهير إلى حدّ كبير، إما مستغلة كبيانات ويد عاملة رخيصة، أو مُهمشة بفعل الأتمتة.
وإذا استمرت هيمنة النظام الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، فإن النتيجة من الممكن أن تكون مجتمعًا شديد الاستقطاب والتفاوت، حيث تملك الطغم التكنولوجية الرأسمالية القوة الشبه المطلقة، بينما يُدفع شغيلات وشغيلة اليد والفكر نحو مزيد من التهميش والإقصاء.
الرؤية الرأسمالية للذكاء الاصطناعي
أداة لتعظيم الأرباح واستغلال البيانات والمعرفة في ظل الرأسمالية
تعظيم الأرباح على حساب العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية.
في ظل النظام الرأسمالي الحالي، يُوجَّه استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، نحو تعظيم الأرباح، حيث تُستخدم هذه التقنيات كأداة رئيسية لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف. لكن ذلك يكون غالبًا على حساب شغيلات وشغيلة اليد والفكر، إذ يُستبدلون بالخوارزميات والأنظمة المؤتمتة، مما يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة منهم وارتفاع معدلات البطالة، أو دفعهم إلى الانتقال إلى قطاعات أخرى في ظروف غير مستقرة
تشير التقديرات الأحدث إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان واسع للوظائف في السنوات القادمة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على المهام الروتينية والقابلة للأتمتة. فعلى سبيل المثال، في عام 2023، أعلنت شركة "آي بي إم"، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أنها ستوقف التوظيف في نحو 30% من الوظائف الإدارية (مثل الموارد البشرية)، تمهيدًا لاستبدالها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا يعني أن آلاف الوظائف سيتم إلغاؤها نهائيًا، لأن الشركة ترى أن المهام الروتينية التي كانت تُنفّذ بواسطة البشر يمكن أن تُدار آليًا بشكل أكثر كفاءة وربحية.
وفي بداية عام 2024، قامت شركة "دروبوكس"، المختصة بخدمات التخزين السحابي، بتسريح نحو 16% من موظفيها، معلنةً أن القرار يأتي ضمن خطة "إعادة هيكلة" تهدف إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي كمجال استثماري رئيسي. أوضحت الإدارة أن عددًا من المهام التي كانت تُنفّذ من قبل البشر أصبحت الآن قابلة للأتمتة، ما يجعل الإبقاء على العاملين فيها "غير ضروري".
هاتان الحالتان تعكسان بوضوح تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وزيادة مخاطر البطالة بين شغيلات وشغيلة اليد والفكر، في ظل ضعف أو غياب سياسات حمائية تضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك حسب موازين القوى الطبقية في كل بلد، ودرجة تطوّر حقوق شغيلات وشغيلة اليد والفكر، ودور وقوة النقابات واليسار.
في المقابل، تُوجَّه مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الأتمتة نحو زيادة أرباح الشركات الكبرى بدلًا من تحسين الأجور أو تقليل ساعات العمل. أما من يحتفظون بوظائفهم، فيجدون أنفسهم مضطرين للعمل في بيئات غير مستقرة، حيث تفرض معظم الشركات سياسات قاسية لزيادة الإنتاجية، مستغلة التكنولوجيا لفرض ضغوط إضافية على القوى العاملة. هذا التركيز على الربح يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الطبقية والاقتصادية، حيث تُترك الغالبية العظمى من المجتمع لتحمل عبء التغيرات التي أحدثتها هذه التكنولوجيا، بينما تستأثر الطغم الرأسمالية بالفوائد والأرباح.
استغلال البيانات في ظل الرأسمالية الرقمية
إلى جانب استغلال شغيلات وشغيلة اليد والفكر في أماكن العمل التقليدية، وسّعت الرأسمالية الرقمية، من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نطاق الاستغلال ليشمل البيانات الشخصية، وسلوك الأفراد، وتفضيلاتهم، حيث تحوّلت هذه البيانات إلى سلعة تراكم الطغم الرأسمالية من خلالها الأرباح، دون أي تعويض مباشر للمستخدمات والمستخدمين الذين يُنتجونها. تُستخدم هذه البيانات في صياغة سياسات وبرامج سياسية واقتصادية، وتوجيه الاستهلاك، بما يضمن إعادة إنتاج الهيمنة الرأسمالية.
على سبيل المثال، كشفت فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" عام 2018 عن كيفية استغلال وبيع بيانات عشرات الملايين من مستخدمي ومستخدمات فيسبوك دون علمهم، بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال استهدافهم بإعلانات سياسية مصمّمة بناءً على تحليل ملفاتهم السلوكية.
كما تحقّق شركات مثل جوجل، وأمازون وغيرها عشرات المليارات سنويًا من الإعلانات المستهدفة، المعتمِدة على تحليل البيانات التي تُنتَج مجانًا عبر تفاعلات المستخدمين والمستخدمات. ففي عام 2021، بلغت إيرادات فيسبوك من الإعلانات الرقمية وحدها 117 مليار دولار، تم تحصيلها دون أي إشراك فعلي للمستخدمين والمستخدمات في تلك الأرباح.
يمثّل هذا النمط من الاستغلال شكلًا غير مباشر من العمل المجاني، حيث يُنتج الأفراد، دون وعي، قيمة اقتصادية هائلة تستولي عليها الشركات الاحتكارية، التي لا تكتفي باستغلال البيانات، وانما تهيمن على البنية التحتية الرقمية نفسها، فيما يشبه شكلًا جديدًا من الإقطاع الرقمي. وكما احتكر الإقطاعيون الأراضي في العصور الوسطى، تحتكر الشركات التكنولوجية الكبرى اليوم المنظومات الرقمية، فارضةً شروطها على المستخدمات والمستخدمين، ومانعةً أي سيطرة فعلية لهم على أدوات الإنتاج الرقمي.
في الاقتصاد الصناعي، كان الاستغلال يتم عبر دفع أجور لا تعكس القيمة الحقيقية للعمل. أما في الاقتصاد الرقمي، فبات السلوك البشري وبياناته ذاتها مصدرًا للقيمة. كل نقرة، وكل بحث، وكل تفاعل، تتحول إلى مادة خام تُكدّسها الرأسمالية الرقمية دون أي اعتراف قانوني أو تعاقدي. لم يعد الاستغلال الرقمي مقتصرًا على شغيلات وشغيلة اليد والفكر ذوي الأجور المنخفضة، وانما بات يشمل المستخدمات والمستخدمين أنفسهم، الذين يتحوّلون إلى شغيلات وشغيلة رقميين غير مرئيين.
تُخفي الرأسمالية الرقمية هذا الاستغلال خلف خطاب "المجانية"، الذي يوهم المستخدمين والمستخدمات بأنهم يحصلون على خدمات مفيدة دون مقابل، بينما يتم في الواقع استخراج بياناتهم وتوظيفها لتحقيق أرباح ضخمة.
تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" تُحفّز على قضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع المحتوى، بينما تجمع وتبيع بياناتهم للمعلنين دون أي مردود لصالح المستخدم-ة. وينطبق الأمر كذلك على برامج "الحماية المجانية" مثل "AVG"، التي تجمع معلومات حساسة تحت ستار "تحسين الخدمة ومكافحة الفيروسات"، لتبيعها لاحقًا لشركات التسويق والإعلانات.
تحليل البيانات لا يُستخدم فقط في الإعلانات، وانما في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقات جديدة تُعزّز هيمنة الشركات الكبرى على المعرفة، وكذلك في الاقتصاد، والعلاقات الاجتماعية، دون أن يملك الأفراد أي قدرة على التحكم في بياناتهم أو المطالبة بجزء من القيمة والارباح التي يُنتجونها.
والأخطر من ذلك، أن هذا النموذج يمحو الفاصل بين وقت العمل ووقت الفراغ، حيث تتحوّل كل لحظة يقضيها الفرد في الفضاء الرقمي إلى إنتاج مستمر للبيانات، حتى في لحظات الترفيه، والتفاعل الاجتماعي، والممارسات الثقافية والاجتماعية. وهكذا، أصبح الإنترنت ذاته مصنعًا رقميًا يعمل على مدار 24 ساعة، ولكن تحت منطق الرأسمالية والإقطاع الرقمي، حيث لم تعد الشركات الرقمية تقدّم مجرد خدمات، بل تتحكّم في القواعد التي تنظّم الفضاء الرقمي نفسه، فارضةً على الأفراد العمل داخل منظومتها الاحتكارية، دون أي سيطرة على أدوات الإنتاج الرقمي أو حتى وعي باستغلالهم.
فائض القيمة الرقمي وفائض القيمة التقليدي
فائض القيمة هو جوهر الاستغلال الرأسمالي، أي الفارق بين ما يُنتجه العامل-ة من قيمة، وبين ما يحصل عليه من أجر. لكنه ليس مفهومًا ثابتًا، بل يتغيّر شكله وفقًا لنمط الإنتاج القائم. ويمكن التمييز اليوم بين نوعين رئيسيين: فائض القيمة التقليدي وفائض القيمة الرقمي، يختلفان في أسس العلاقة الإنتاجية والاستغلال.
أولًا: فائض القيمة التقليدي
في النمط الصناعي التقليدي، يتم انتزاع فائض القيمة من جهد شغيلات وشغيلة اليد والفكر في مواقع الإنتاج مثل المصانع، المزارع، المكاتب، وسلاسل الخدمات. يعمل هؤلاء وفق عقد عمل مباشر، ويتلقّون أجرًا يقل كثيرًا عن القيمة الفعلية التي يُنتجونها. رأس المال يمتلك وسائل الإنتاج، ويُوظّف قوة العمل لتحقيق الربح من خلال السيطرة على وقت العمل.
مثلًا، في مصانع إنتاج الأجهزة الذكية التابعة لشركات عالمية كبرى مثل آبل وسامسونج، يعمل مئات الآلاف من الشغيلات والشغيلة في دول جنوب شرق آسيا لساعات طويلة، مقابل أجور منخفضة لا تكاد تغطي نفقات المعيشة الأساسية، بينما تحقق هذه الشركات أرباحًا ضخمة. في عام 2023، بلغت أرباح آبل أكثر من 100 مليار دولار، معظمها ناتج عن بيع منتجات تُنتَج بجهد مكثّف وظروف عمل استغلالية.
ثانيًا: فائض القيمة الرقمي
أما في النموذج الرقمي، فإن فائض القيمة يُنتزع بأساليب أكثر خفاءً وتعقيدًا. لا يعتمد هذا النمط فقط على العمل المأجور، بل على الأنشطة اليومية للمستخدمات والمستخدمين داخل الفضاء الرقمي. كل نقرة، بحث، إعجاب، مشاركة، أمر صوتي، أو استخدام لتطبيق، وغيرها تُنتج بيانات تُستخدم لتوليد أرباح هائلة من الإعلانات، تدريب الخوارزميات، تطوير المنتجات، وتحليل السلوك، فضلًا عن الاستفادة منها في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الفكرية، وحتى العسكرية والأمنية.
هنا لا يوجد عقد عمل، ولا أجر، ولا حتى اعتراف بالدور الإنتاجي. فالرأسمالية الرقمية لا تشتري وقت العمل، وانما تستخرج القيمة من الحياة اليومية ذاتها، وتُخفي هذا الاستغلال خلف واجهة "الخدمة المجانية". وحتى حين تُقدَّم بعض الخدمات مجانًا أو بأسعار رمزية، فهي غالبًا محدودة الإمكانات، وتُوظَّف أساسًا كأدوات لجمع المزيد من البيانات والمدخلات عن المستخدمات والمستخدمين، بهدف تعظيم الأرباح وتعزيز السيطرة.
من الأمثلة الواقعية على هذا النمط من استخراج فائض القيمة الرقمي، يمكن الإشارة إلى المنصات الاجتماعية، حيث يُنتج المستخدمات والمستخدمون محتوى مجانيًا يجذب تفاعلات ضخمة، تُباع لاحقًا للمعلنين، وتدرّ أرباحًا هائلة للمنصات، بينما يحصل معظم صنّاعات وصنّاع المحتوى على حصة ضئيلة جدًا، إن وُجدت أصلًا. وينطبق الأمر كذلك على خدمات مثل خرائط جوجل - مابس، التي تعتمد على البيانات الناتجة عن تنقّل المستخدمات والمستخدمين واستخدامهم للتطبيق، بهدف تحسين الخدمة وبيعها لاحقًا للعملاء التجاريين، دون أي تعويض لمن وفّروا هذه البيانات. أما المساعدات الصوتية، مثل أمازون أليكسا وأبل سيري، فتقوم بتسجيل وتحليل الأوامر الصوتية لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو بيعها لشركات الإعلان والتسويق، دون أن يكون لدى المستخدمات والمستخدمين أدنى وعي بأنهم يشاركون بشكل مباشر في إنتاج فائض القيمة الرقمي.
ثالثًا: مقارنة تحليلية بين النموذجين


 الضباب يحجب الرؤية ويخطف شخصاً على جسر الشعلة
الضباب يحجب الرؤية ويخطف شخصاً على جسر الشعلة
 تشخيص بلا علاج.. ملف الطيران المدني بين وضوح الرؤية وأنعدام التنفيذ
تشخيص بلا علاج.. ملف الطيران المدني بين وضوح الرؤية وأنعدام التنفيذ
 الحربي: عالمية أبو طالب نتاج الرؤية والدعم اللامحدود
الحربي: عالمية أبو طالب نتاج الرؤية والدعم اللامحدود
 التعليم: العراق يقترب من مرحلة الريادة إنسجاماً مع الرؤية المستقبلية
التعليم: العراق يقترب من مرحلة الريادة إنسجاماً مع الرؤية المستقبلية
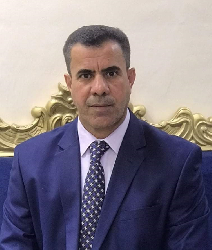 التعليم الأهلي .. بين الرؤية والربحية
التعليم الأهلي .. بين الرؤية والربحية
 تحذيرات من تدنّي الرؤية جراء تصاعد الغبار
تحذيرات من تدنّي الرؤية جراء تصاعد الغبار
 الرؤية الرمزية في رواية "زمن الأرجوان"
الرؤية الرمزية في رواية "زمن الأرجوان"
 التربية: أول قسم للذكاء الإصطناعي في العراق
التربية: أول قسم للذكاء الإصطناعي في العراق
