
الانخراط النصي وتجربة القراءة في كشك خانم
عادل الثامري
في منعطف حاسم من تاريخ النظرية الأدبية المعاصرة، قدّمت ريتا فيلسكي في Uses of Literature (2008) تصوراً ظاهراتياً يعيد الاعتبار لتجربة القراءة بوصفها حدثاً وجدانياً ومعرفياً، متجاوزةً النزعة التأويلية الشكّية التي فصلت بين القارئ والنص. تقترح فيلسكي أربعة أنماط للانخراط النصي – التعرّف، الافتتان، المعرفة، الصدمة – تتداخل لتكوّن شبكة من الاستجابات الجمالية والمعرفية التي تعيد تشكيل وعي القارئ بالعالم.
تمثل قصيدة النثر العراقية، التي نضجت في تسعينيات القرن العشرين في ظلّ حروب ومنافي وانكسارات، مجالاً خصباً لتطبيق هذا النموذج. فهي تجمع بين الوعي التاريخي المأزوم والحساسية الجمالية العالية، وتتحرك بين الحداثة والتراث، وبين الذاكرة الجمعية والتجربة الفردية.
في هذا السياق، تبرز قصيدة "كشك خانم" للشاعرعادل مردان مثالاً مكثفاً لهذه الشعرية المركّبة. فهي تنسج من شذراتها لوحات منمنمة تتقاطع فيها الأسطورة والتاريخ والاستشراق، وتستدعي مدناً وشخصيات مشحونة بالذاكرة والغياب. من خلال هذا النسيج، تتيح القصيدة للقارئ أن يتعرّف، يفتتن، يدرك، ثم يُصدم؛ فتتحول القراءة إلى تجربة إدراكية متوترة تجمع بين الجمال والوعي النقدي.
تهدف هذه الدراسة إلى استثمار مقاربة فيلسكي لفهم شعرية قصيدة النثر العراقية كما تتجلّى في نص عادل مردان، دون تطبيق آلي للنظرية، بل بقراءة تكشف تفاعل الأنماط الأربعة في إنتاج تجربة جمالية وفكرية مغايرة.
التعرُّف
يُعدّ التعرُّف، في تصور ريتا فيلسكي، لحظة انخراط أولى يكتشف فيها القارئ ذاته داخل النص، لا عبر التماهي البسيط، بل من خلال استذكار وجودي يرى فيه انعكاس هويته الفردية والجماعية. في قصيدة "كشك خانم" ، يتجلى هذا التعرّف منذ السطر الأول:
"منمنمةٌ باكيةٌ في فضاءِ المشرق / سقطَ الموتُ على الحاجب / رفرفَ جفنٌ أخضر / غفا نهدُها بين يدي شاتوبريان."
هنا يتقاطع الجمال بالحزن، والشرق بالأنوثة، والذات بالنظرة الاستشراقية. فالقارئ الشرقي يرى نفسه في صورة "الشرق المجروح"، الذي صار موضوعاً للرؤية لا فاعلاً فيها.
ويتجلّى التعرّف على جغرافيا الذاكرة حين يستدعي الشاعر مدناً مثل سمرقند، بخارى، القسطنطينية، فاس، قرطبة. فهذه الأسماء ليست إشارات مكانية، بل علامات على مجد مطمور وذاكرة حضارية نائمة:
"نامت قرونٌ على سجادةِ الحائط / نامت غزواتٌ أندلسيّةٌ على الأطلسي / أهجعي يا سمرقند قريرةَ العين."
النداء الحزين «أهجعي» يحوّل المدن إلى كيانات منطفئة؛ لحظة تعرّف على الذات من خلال فقدانها. وفي المقطع:
"أقواسُ النصرِ تجلسُ مغبّرةً في المتحف / والعباءاتُ تُهرعُ في استدارةِ الشوق"،
يتحوّل المجد إلى أثر، والبطولة إلى غبار متحفي، فيتحقق التعرّف عبر الغياب لا الحضور.
أما الرموز التراثية فتعيد إنتاج الذاكرة الجمعية في سياقات مغايرة: " شهرزاد تتوضأ بفجرها الأخير" لم تعد راوية الخلاص، بل رمزاً لأفول الحكاية؛ و«القينة نامت في قراب السيف» تكثيفٌ للتوتر بين الفن والعنف. كما يحضر التناص مع ابن بكّار في «فسقية القياس»، حيث تتحول شهقته الأخيرة إلى استعارة للانطفاء الجمالي والحضاري.
وتبلغ لحظة التعرّف ذروتها في الوعي بالفقد، وهو ما تسميه فيلسكي التعرّف السلبي (negative recognition). فالأفعال: نامت، غفا، أهجعي، سقط الموت، تشي بإيقاع جنائزي يرثي التاريخ أكثر مما يستعيده.
"من يحمل الأضحيات إلى المحراب؟ / ترك عمامته على الزبرجد / نام طفلُ الثلج على دكّة الخان."
هنا، تتجاور الرموز الدينية والجمالية في مشهد فراغ روحي، فيما تختم القصيدة بفقدٍ نهائي:
"القباب الحمر تركتها في قرطبة."
القباب، بوصفها أيقونة العمارة الإسلامية، تصبح رمزاً لترك الهوية في الماضي، وتتحول القصيدة إلى مرآة كبرى يرى فيها القارئ العربي ذاته وهو يتعرّف على وجوده من خلال ما انقرض منه.
ان التعرُّف في قصيدة "كشك خانم" هو تعرُّف مزدوج: تعرُّف على العظمة المفقودة وتعرُّف على الانكسار الراهن. القارئ العربي/العراقي يرى نفسه في مرآة النص كوارث لحضارة عظيمة وكضحية لتاريخ من الهزائم. هذا التعرُّف المؤلم هو ما يؤسس للانخراط الأعمق مع النص، ويمهد للأنماط الأخرى: الافتتان بالجمال المفقود، والمعرفة بأسباب الانكسار، والصدمة من المفارقات الحادة بين الماضي والحاضر.
الافتتان
إذا كان التعرّف في القراءة، كما رأينا، يقوم على استحضار الذات داخل النص من خلال الذاكرة الثقافية والتاريخية، فإنّ المرحلة التالية من الانخراط تتجاوز فعل التذكّر نحو الانخطاف الجمالي. فبعد أن يعثر القارئ على ملامحه في النص، يُسلم نفسه إلى غواية اللغة، إلى ما تسميه ريتا فيلسكي الافتتان، تلك الحالة التي تُعلَّق فيها المسافة النقدية ويُستبدل التحليل بالتذوّق. في هذا المستوى، لا يعود الأدب مرآةً للهوية، بل فضاءً للدهشة.
الافتتان، في جوهره، هو التجربة التي يذوب فيها القارئ داخل النص، إذ تُصبح اللغة نفسها موضوع انبهار. في قصيدة "كشك خانم" ، يتحقق هذا الافتتان منذ الصورة الافتتاحية:
"منمنمةٌ باكيةٌ في فضاءِ المشرق."
النصّ يُقدَّم كلوحةٍ شرقية تتأرجح بين الزخرفة والبكاء، بين الحُسن والفقد، فيخلق الشاعر بذلك جمالاً مضاعفاً؛ جمال الشكل الذي يُخفي مأساة المضمون. اللون والضوء والحركة يتداخلون في مشهد شعري يذكّر بفنّ المنمنمات الإسلامية التي تجمع بين البهاء والدقة والسكينة.
يتجسد الافتتان هنا في الاستغراق البصري، إذ تتحوّل القصيدة إلى عرضٍ للعين أكثر منها خطاباً للفكر. فالألوان والأسماء والمعمار والمواد النفيسة – الزبرجد، المشرفيات، القباب، الخيزران – تخلق شبكة من الصور التي تثير حسّ اللمعان والندرة. ومع ذلك، لا ينفصل هذا البريق عن الحزن؛ فكل جمال في القصيدة مشوب بالغياب. يقول الشاعر:
"نامت قرونٌ على سجادةِ الحائط / نامت غزواتٌ أندلسيّةٌ على الأطلسي."
إنها فتنة المدن النائمة، ودهشة الحضارة التي تحوّلت إلى متحف. هنا يلتقي الانبهار بالحسرة؛ وهو ما يمكن وصفه بالافتتان المأساوي، إذ يتأمل القارئ الجمال لا ليتمتّع به، بل ليحزن عليه.
كما تستدعي القصيدة رموزاً أنثوية تعبّر عن التحوّل من الفعل إلى الأثر: شهرزاد التي "تتوضأ بفجرها الأخير" لم تعد راوية الخلاص بل شاهدة النهاية، و"القينة نامت في قراب السيف" تُلخّص تناقض الفن والحرب، اللذّة والموت. هذه المفارقات الجمالية تُنتج انفعالاً غامراً يتجاوز الفهم العقلاني، ويقع تماماً في منطقة الافتتان التي تصفها فيلسكي بأنها توقيف للعالم (Aesthetic Arrest)؛ أي تجميد للحظة الزمنية كي يُعاين القارئ الكارثة في هيئة لوحة جميلة.
الافتتان في «كشك خانم» ليس تزييناً للخراب، بل إعادة صياغة له في هيئة فنّ. فالشاعر لا يرثي الماضي بل يرمّمه باللغة، واللغة نفسها تتحوّل إلى أداة مقاومة رمزية تحفظ ما تبقّى من الحضور. إنّ هذا النصّ يعلّم قارئه كيف يفتتن دون أن يُخدع، وكيف يرى في الجمال بقايا العالم الذي أُبيد.
وهكذا يتحوّل الافتتان إلى شكل من المقاومة الجمالية، حيث ينهض الشرق الموشّح بالدموع من رماده، لا كقوة سياسية أو دينية، بل كقيمة فنية خالدة. في هذا المعنى، يكمّل الافتتان فعل التعرّف، إذ لا يكتفي باستعادة الذاكرة، بل يمنحها حياة ثانية داخل اللغة.
المعرفة
إذا كان التعرّف يؤسّس للارتباط الهويّاتي، والافتتان يخلق التجربة الجمالية، فإنّ المعرفة تمثّل النمط الثالث من أنماط الانخراط النصيّ عند ريتا فِلسكي، وهي المعرفة التي تنشأ من التجربة الوجدانية والجمالية مع النصّ لا من التحليل الخارجي له. إنها "معرفة خبروية" تتولّد من فعل القراءة ذاته، حين يتحوّل الجمال إلى وعي، والانفعال إلى تفكير.
حين يخرج القارئ من لحظة الافتتان الأولى، يبدأ في إدراك ما وراءها من وعي ثقافي ومعرفي. فالمعرفة، في تصور فيلسكي، هي لحظة تنبثق من داخل التجربة الجمالية نفسها، لا من تحليلها الخارجي.
في قصيدة «كشك خانم ، تتجلّى هذه المعرفة في إعادة التفكير بعلاقة الشرق بذاته وبالآخر، وفي تحويل التاريخ من سجلّ للأحداث إلى مادة للتأمل. حين يقول الشاعر:
"تقدّم الإمامُ إلى المنبر / وتركَ عمامته على الزبرجد / نامَ طفلٌ ألثغ على دكّةِ الخان / من يحملُ الأضحياتِ إلى المحراب؟"
إنّ تجاور الإمام والطفل، الزبرجد ودكّة الخان، يولّد معرفة تأملية تتجاوز الصورة إلى معناها الثقافي: المقدّس فقد طهارته، والبراءة تُترك على العتبة. القصيدة لا تعظ ولا تفسّر، بل تضع القارئ أمام تجربة إدراك أخلاقيّ غامض، تنهار فيها المسافة بين العبادة والزخرف، بين الطقس والمصلحة.
وفي مقطع آخر، تتخذ المعرفة بعداً سياسياً وثقافياً صريحاً:
"الوصيّ يُطعم طواويسه في السقيفة / أعدّي الحمّام للقنصل / محاربٌ برتغاليّ يبحث في أرخبيلك / زيتٌ من الدنمارك يدهنون بهِ ظهركِ الذليل"
تتحوّل القصيدة إلى معرفة نقدية بالتاريخ والهيمنة، تكشف انتقال الاستعمار من الغزو العسكري إلى الغزو الرمزيّ للجسد والثقافة. إنها لا تدين، بل تفكّك العلاقة بين الشرق والغرب بوصفها شبكة من الرغبة والاستغلال والاستيهام. إنّ المشهد هنا قراءة شعرية لتاريخ الاستشراق والاستعمار، لكن بلغةٍ رمزية مفعمة بالإيماء. فالشرق الأنثوي («ظهرك الذليل») أصبح سلعةً تُدهن بزيتٍ أوروبيّ، أي أنّ الجسد والثقافة معاً أصبحا موضوعاً للاستعمال. في هذا التوصيف تتجسّد المعرفة بوصفها نقداً جماليّاً؛ نقداً لا يتخذ نبرة خطابية بل ينبع من الصورة ذاتها.
ويبلغ الوعي المعرفي ذروته حين يقول الشاعر:
"مدنٌ مبنيّةٌ على النسخ
في فسقية القياس يشهق ابن بكّار"
تختصر هذه الصورة الكثيفة رؤية الشاعر للعالم: المدن، أي الحضارات، تُبنى على النسخ وليست أصلية؛ كلّ شيءٍ يُعاد إنتاجه ضمن قوالبٍ جاهزة، حتى المعرفة ذاتها أصبحت قياساً مكروراً. القصيدة هنا لا تكتفي بوصف العالم، بل تكشف آلية اشتغاله، مظهرةً كيف أن التقليد والتكرار هما أساس الوجود الثقافي الحديث.
وفي مشهد "المهراجا المنحني في شركة الطيران"، يتجسّد التحوّل من السيادة إلى التبعية، ومن الرموز الإمبراطورية إلى الطاعة البيروقراطية. أما صور "نامت قرون على سجادة الحائط" و"نامت غزوات أندلسية على الأطلسي"، فتقدّم رؤية "مرثوية" للحضارة النائمة في متحف الذاكرة، يصبح فيها الماضي ديكوراً للهوية لا مصدراً للفعل.
تقدّم «كشك خانم» معرفة شعرية بالحاضر عبر استدعاء الماضي، لا بوصفه زمناً منتهياً، بل كآليةٍ دائمة لإنتاج الانكسار. فالنوم المتكرر في النص استعارة للجمود التاريخي، والاستعمار ليس حدثاً بل نمطاً من الوعي. المعرفة هنا ليست يقيناً بل انكساراً، معرفة موجعة تولد من الجمال لتفضي إلى الوعي، وتعيد إلى القارئ إدراكه للعالم بوصفه سؤالاً لا جواباً.
الصدمة
تمثّل الصدمة، في تصور ريتا فِلسكي، ذروة التجربة القرائية، فهي لحظة انقطاعٍ ودهشةٍ ينهار فيها أفق توقّع القارئ أمام حدث لغويّ أو جماليّ يبدّل إدراكه للعالم. ليست الصدمة انفعالًا عابرًا، بل تحوّلًا إدراكيًا يفكك ما استقر في الوعي من صورٍ ويقينيات. فالجمال في هذا السياق لا يثير الدهشة فحسب، بل يكشف عن هشاشة المعنى، ويحوّل اللغة إلى ساحة اضطرابٍ وانكشاف.
في قصيدة "كشك خانم"، تبدأ الصدمة من المفارقة الزمنية بين الماضي والحاضر، حين يرسم الشاعر صورة المهراجا المنحني في شركة الطيران، وفيله يجرّ خرطومه على الأرض. يتقاطع المجد القديم مع الواقع المبتذل، فيتبدّى التاريخ وقد أُعيد إنتاجه داخل حداثةٍ تجاريةٍ تفكّك رموزه. هنا تتحول المفارقة إلى انهيار في المعنى، إذ يُستعاد الشرق المهيب بوصفه كاريكاتيرًا لنفسه.
ثم تتجسد الصدمة في التوتر بين الجمال والعنف، كما في قوله:
"سقط الموت على الحاجب"،
"جناح أسود ساكن على مرمر الدم"،
"زيت من الدنمارك يدهنون به ظهرك الذليل".
يتجاور الرقيق والعنيف، فـ"المرمر" و"الزيت" يقابلان "الموت" و"الذلّ"، ويغدو الجمال أداةً لكشف التمزق الحضاري لا ستراً له. القارئ مأخوذ بصنعة الصورة لكنه مأزوم بمعناها؛ فالمتعة الجمالية تنقلب إدراكًا مؤلمًا بأن الفن ذاته قد يصبح لغةً للألم.
تبلغ الصدمة أوجها حين تنفجر الأسئلة الوجودية في جسد النص:
"من يحمل الأضحيات إلى المحراب؟"
"إلى أيّ جهةٍ تريد أيّها الحاخام؟"
هنا يتحول الشعر إلى مساءلةٍ للمقدّس والمعنى معًا. فالمحراب الخالي والقرابين الغائبة يرمزان إلى عالمٍ فقد صلته بالروح، بينما نداء "الحاخام" يفكك الحدود الرمزية بين الأديان والهويات، ليكشف أن الجميع تائهون في فضاءٍ بلا قبلة. إنها الصدمة المعرفية التي تهز سلطة المقدس وتعيد القارئ إلى حالة من اللايقين الخلّاق.
وفي سلسلة صورٍ لاحقة – "نامت قرون على سجادة الحائط"، "نامت غزوات أندلسية على الأطلسي"، "القباب الحمر تركتها في قرطبة" – تتكرّر الصدمة على نحوٍ مرثويّ: فالتاريخ لم يمت فجأة، بل غفا ببطء حتى صار أثراً جمالياً. الحلم بالنهضة يتحوّل إلى زينةٍ على جدار الذاكرة، والشرق يطلّ من وراء الزجاج كتحفةٍ متحفية لا كقوةٍ حيّة.
يدرك القارئ أن الجمال الذي افتتن به في البداية هو ذاته علامة الفقد. القصيدة لا تدهشه فحسب، بل تُربكه، وتجعله يرى في لغتها الأنيقة ما لا يُطاق من الحزن. وهكذا تتحقق الصدمة كما تراها فِلسكي: انكسار الإدراك وانفتاحه في آنٍ واحد، انطفاء الصورة القديمة وولادة وعيٍ جديدٍ أكثر هشاشةً وصدقًا.
إنّ عادل مردان في «كشك خانم» لا يكتب عن الماضي ولا عن الشرق بوصفهما موضوعين، بل عن انهيار وعينا بهما. الصدمة هنا مزدوجة: صدمة التاريخ الذي تكلّس، وصدمة اللغة التي لم تعد قادرة على الطمأنينة. لكنها في الوقت نفسه لحظة وعيٍ جديد، تُرغم القارئ على أن يرى الجرح في الجمال، وأن يدرك أن كل انبهارٍ أصيل لا بد أن يمرّ عبر الألم.
الخاتمة
تتجلّى في قصيدة "كشك خانم" الأنماط الأربعة لانخراط القارئ عند ريتا فِلسكي، من التعرّف الحنين إلى الافتتان الحسي، ثم المعرفة النقدية وصولاً إلى الصدمة الوجودية. لتنتج تجربة قرائية متعدّدة المستويات، تجمع بين الحسّ الجمالي والوعي الثقافي والفلسفي. تبدأ القصيدة بلحظة تعرّفٍ حنينية يستعيد فيها القارئ ماضيه الضائع، ثمّ تنتقل إلى افتتانٍ حسيّ يُغريه بسحر اللغة والصورة، فإلى معرفةٍ نقدية تكشف بنية التمثيل الثقافي، وأخيراً إلى صدمةٍ وجودية تعيد تعريف المعنى والجمال.
إنّ هذه الرحلة ليست مجرّد تتابعٍ نفسيّ في وعي القارئ، بل بنية عضوية في القصيدة نفسها. يكتب عادل مردان نصّاً يتحرّك داخله من الحنين إلى الفتنة إلى الوعي إلى الخراب، تماماً كما يتحرّك القارئ في تجربته الجمالية. وهكذا يتحوّل الشعر إلى مختبر إدراكيّ تُختبر فيه العلاقة بين اللغة والوعي، بين الذات والعالم.
تكشف هذه القراءة أنّ قصيدة النثر العراقية في تسعينيات القرن العشرين لم تكن مجرّد تمرينٍ لغويّ، بل تجربة معرفية وجمالية معاً، تُعيد صياغة علاقة الشرق بذاته وبصوته. فالشاعر في هذه القصيدة لا يستعيد الشرق كرمزٍ من الماضي، بل يكتبه كحالةٍ فكرية وشعورية تتأرجح بين الحنين والنقد، بين الأثر والأسطورة، بين الغواية والانكسار.
القصيدة لا تستعيد الشرق كرمز من الماضي، بل تكتبه حالة فكرية وشعورية، بين الحنين والنقد، بين الغواية والانكسار، وبين الأثر والأسطورة. وفي هذه التجربة، يتحوّل الشعر إلى وعي مزدوج: وعي بالعالم ووعي بالقراءة، حيث تصبح اللغة مساحة لاكتشاف الذات والتاريخ معًا.
ويسدل النص الستار بسؤال مفتوح: من نحن بعد أن أصبحنا أثراً في متحف لغوي؟ هذا السؤال، بما يحمله من دهشة وصدمة وتأمل، يعبّر عن ذروة الانخراط النصيّ، حيث يتحوّل الشعر إلى تجربة معرفية وجودية، تعيد للقارئ إدراك الجمال والواقع في آن واحد.


 تحت شعار لا مستحيل أمام كفاءة المهندس العراقي.. هكذا إعيد إعمار الجسر المعلّق في بغداد
تحت شعار لا مستحيل أمام كفاءة المهندس العراقي.. هكذا إعيد إعمار الجسر المعلّق في بغداد
 سردية الماء في رواية المنسيون بين ماءين للكاتبة ليلى المطوّع
سردية الماء في رواية المنسيون بين ماءين للكاتبة ليلى المطوّع
 تعلّق في زمن الرماد
تعلّق في زمن الرماد
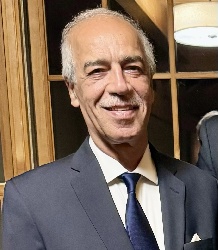 هل يأتي الإصلاح في مقاطعة الانتخابات؟
هل يأتي الإصلاح في مقاطعة الانتخابات؟
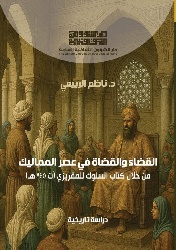 القضاء والقضاة في عصر المماليك من خلال كتاب السلوك للمقريزي ( ت ٨٤٥ ه ) لناظم الربيعي.. دراسة تاريخية
القضاء والقضاة في عصر المماليك من خلال كتاب السلوك للمقريزي ( ت ٨٤٥ ه ) لناظم الربيعي.. دراسة تاريخية
 أسرار قدرة عوينة على إقناع خصومه التقليديين وهو في المخابىء
أسرار قدرة عوينة على إقناع خصومه التقليديين وهو في المخابىء
 بيان ضد الخطاب الطائفي في الدعاية الانتخابية
بيان ضد الخطاب الطائفي في الدعاية الانتخابية
 بداية موفّقة للعراق في إنطلاق دورة الألعاب الآسيوية للشباب
بداية موفّقة للعراق في إنطلاق دورة الألعاب الآسيوية للشباب
