


محـــراب الذّاكـــرة.. قراءة في قصيدة المقهى لحميد سعيد
سناء يحفوفي
يتسرّب خيطٌ واهٍ من بين أسوارِ المقهى يشبهُ رجعَ وَتَرٍ بعيدٍ، يفتحُ شقوقَ الذّاكرةِ فتنهضُ منها ظلالٌ معلّقة. هناك، في الرّكن الموحى إليهِ بصمتٍ يتجاوزُ الخفوتَ، مع وقعِ الخطواتِ، تتكاثفُ الهمساتُ حتى تغدو هيئةً شفيفةً للرّوح. فيما تنصهرُ تفاصيلَ المكانِ في نغمةٍ مكتومةٍ تعيدُ ترتيبَ الزّمنِ وتبني للذّاكرةِ معراجًا خاصًّا، حيثُ اليوميّ يتحوّلُ إلى أسطوريّ، والاعتياديّ ينكشفُ كأثرٍ غائبٍ في وجدانِ الشّاعر. وكلُّ نبرةٍ تختزنُ ما تراكمَ في الرّوحِ، لتعيدَ صياغةَ الكيانِ في هيكلٍ خفيّ. وفي خفاءِ هذه الظّلال، يختبئُ وَتَرٌ خامدٌ يرتقبُ لحظةَ الانفجارِ الدَّاخليِّ للشَّاعرِ، بركانٌ ينبثق من صمتِ المكانِ والذَّاكرةِ، يكشفُ عمقَ التّجربةِ، ويهيئُ النَّصَّ لرحلةٍ وجوديّةٍ رمزيّةٍ يتجلّى مع كلّ حركةٍ لاحقةٍ في المكان.
في فضاءِ المقهى، حيثُ ينهضُ المكانُ بحضورِ الشّاعر ويتنفّس وجوده: يتّسعُ بأنفاسِ الآخرينَ، يحتفظُ في عمقِهِ بصمتٍ أصيل. حينها، يتراءى الحاضرُ نهرًا صاعدًا من تراكمِ الأيّامِ: يفيضُ بما أودعتْهُ الذَّاكرةُ، يصوغُ لحظةَ العبورِ بينَ الغربةِ والأنسِ، وكل لحظة تحمل ما أودعته الذّاكرة.
»في المقهى« محرابُ الرّوحِ، ينبلجُ مسرحٌ للغربةِ الثّانيةِ؛ لا يعودُ الغريبُ غريبًا عن المكانِ وإنّما غريبٌ فيه. فالمقهى عند »سعيد« يستحيلُ معراجًا إلى الدّاخل، وكلّ تفصيلةٍ عابرةٍ - صحيفةٌ مهملةٌ، كوبٌ يتركُ أثرَهُ على الطّاولةِ، رائحةُ قهوةٍ عالقةٍ - تنقلبُ إلى أداةِ كشفٍ لعمق الذات، ليتولّى المقهى نفسَهُ كتابةَ النّصِ مع الشّاعر، ويعيدُ إليه ما غاب؛ إذ، يشكّلُ حاضنةً للذّكرياتِ والخيالِ، حيثُ تتفاعلُ العناصرُ اليوميّةُ مع العمقِ النّفسيّ للذّات.
تفاصيل صغيرة
هذِهِ القصيدةُ تُفتَحُ على بوّابةِ الاعترافِ: يستعادُ العمرُ عبرَ تفاصيلٍ صغيرةٍ، وتُغزَلُ اليوميّاتُ في نسيجٍ رمزيٍّ يتجاوزُ المقهى، ليغدوَ مسرحًا لوجودٍ معلَّق، حيثُ الذّكرى تصوغُ ذاتَها من جديدٍ في لغةٍ مثقلةٍ بالرّؤى. معلنةً أن الغربةَ تعاشُ وتتجدّدُ مع كلّ جلوسٍ مع الذّات، فيتقدّمُ الشّاعر عبرَ الزّمنِ حاملاً إلينا الحكايا، كما يحملُ العودُ نغمةً لا تكتملُ إلّا بلمسةِ عاشقِ الصّمت.
« قبلَ أنْ يزدحمُ المقهى،
انتهى من صحفِ اليومِ التي غصّت بأنباءِ الوفياتِ
ومن قهوتِهِ. .
طالبًا من نادلِ المقهى. .
بعضَ الماءِ، كي يأخذَ في الموعدِ أقراصَ دواءُ. «
تبدأ ذاكرةُ المكانِ بالتّحرّك منذ مطلعِ القصيدةِ، تتسلّلُ في كيانِهِ لتُعيدَ الرّوحَ إلى ما عَبَرَهُ العمرُ من بهاءٍ أو خذلان. فحينَ تنشطُ سورةُ الحياةِ في المقهى، تتحوّل كلّ حركةٍ يوميّةٍ إلى نبضٍ يحتضنُ ما يحتدمُ في الذّاكرة؛ فينفتحُ الفضاءُ على بعدٍ رمزيّ يستوعب ذاكرةَ المكانِ، حيثُ تتشابكُ تفاصيلُ الرّوتينِ مع صدى الغيابِ والحضور.
المكانُ يمدّ الشّاعر بمرآةٍ تكشفُ له مستوياتِ ذاتِهِ: الحواسُّ، الذّكرياتِ المتراكمةِ، والبوصلة التي توصلُ الماضي بالحاضرِ، والغربة والحنين. فحينَ يطوي صحفَ الوفيّاتِ ويستدعي الماءَ لأقراصِ الدّواء، يكونُ قد فتحَ دهليزًا ما بين الحياةِ والموتِ؛ فتتحوّلُ الصّحفُ إلى مرايا تعيدُ إليه ما انطفأَ من ذاتِه، بينما يصبحُ الدّواءُ رمزًا لجسدٍ منهكٍ. عندها، يغدو المقهى صديقًا يرافقُ قلبَهُ، يُصغي لنبضِهٍ وجسدِهِ، يشاركُ الشّاعرَ إحساسَهُ وينسجُ معَهُ إيقاعَ وجودِهِ.
« اقتَحَمتْ عُزْلَتَهُ.. ذاكرةٌ تذبلُ كالوردةِ أحياناً
وكالنَّهرِ تفيضْ
يبدأ النّهرُ مع الضّوء ..
وتبدو السُّفنُ السُّودُ التي خبَّأها اللَّيلُ . .
على مقربةٍ من ثرثراتِ الصِّبْيَةِ الآتينَ ..
من أقصى الحكاياتِ ومِنْ أدنى الوعودْ
كبروا . . واكتشفوا النّهرَ. . لَكَم كان حيِيًّا »
تتماوجُ من بين ثنايا الدّهرِ ذاكرةً تخونُ النّهرَ حينًا وتفيضُ بالنّورِ أحيانًا، فتنهضُ لتوقظُ الماضي من كبوتِهِ. يعودُ الشّاعر إلى الأمسِ، يشاركُ الضّوءَ في جريانهِ والنّهرَ، يواجهُ غربتَهُ المتمثّلةَ في سفنٍ سودٍ يخرجُها اللّيلُ من بينِ سراديبِه. وحينَ يتقاطعُ المشهدُ مع الصّبيةِ وحكاياتِهم، ينفتحُ النّهرُ على طفولةٍ تنمو وتكتشفُ أنَّ الحياةَ مرآةٌ تحتضنُ الأسرار. صدى الطّفولةِ يمدّ السّؤالَ: أيعودُ إلينا النّهرُ بما أخفاه؟ هذا السّؤالُ يتحوّلُ إلى مرآةٍ للذّاتِ، يُعيدُ من خلالها الشّاعر ترتيبَ المسافاتِ بينَ الذّاكرةِ والحاضرِ؛ النّهرُ يفيضُ، وفيهِ مجرى الزّمنِ المتشظّي، حيثُ الماضي يترصّدُ داخلَ لحظةِ الحاضر.
لحظاتُ الغيابِ تُصدرُ أصداءً، والأحداثُ المعلّقة تصيرُ مواضعَ للتَّأملِ. يحتضنُ المقهى الرّوح والتّجربة، والسّنونُ تنسجُ حكاياها على صفحةِ ماءٍ. هناك، على مدرّجاتِ الخيالِ تنهضُ الذّاكرةُ بقلبٍ معلّقٍ بما اجتناهُ على طولِ الدّهر.
»نسِيَ النّهرُ ثمارَ اللَّيلِ . .
إذْ يقطفَها العاشِقُ من دونِ رَقيبْ
أتُرى يذكُرُ ما كانَ مِنَ الماءِ .. إذا مرَّ بنا . .
يَسأَلُ عنَّا
وفرِحْنا بهداياهُ وما خَبَّأ من سحرِ المسرّاتِ. . وَكُنا ..
نتوارى من خَطايانا . . إذا جاءَ إلينا. . خَلْفَهُ . .
صِرنا بعيدينِ. . فَهَلْ يسأَلُ عنَّا؟ «
ذاكرة الليل
تجري القصيدةُ بينَ صورٍ تتوهَّجُ ثُمَّ تخفُتُ، وفي عُمقِها سؤالٌ لا يتراجعُ: أيُّ معنًى للحياةِ حينَ تغدو المُدُنُ مُجرَّدَ روايةٍ عنها؟ يتبدَّى النَّهرُ وقد فارقَ ذاكرةَ اللَّيلِ، تاركًا على الضّفافِ ثمارًا قطفها العاشقُ على غَفلةٍ، سرٌّ يتوارى في الأعماقِ لا يمنحُ نفسَهُ إلَّا للغريبِ لحظةَ انكشافٍ. هكذا، يوقظُ السّؤالُ جُرحًا قديمًا: جُرحَ اللِّقاءاتِ المؤجَّلةِ، وتُبرزُ عطايا النَّهرِ تماوُجاتٍ؛ كلُّ موجةٍ تُعلِنُ عن سُرورٍ غامرٍ، وكلُّ خفّةٍ في جريانهِ تكشفُ سِحرًا متماهٍ مع الغياب، ليتوارى الشّاعرُ خلفَ خيباتِهِ كما أنَّ الخطيئةَ ظلًّا يرافقُهُ. عندها يتجلّى السؤالُ: مَن يَسألُ عنّا؟ سؤالٌ يستحيلُ قَوسًا مشدودًا، يربطُ بينَ ماضٍ مُتفَتّحٍ على طفولةٍ بريئةٍ، وحاضرٍ يفيضُ بغيابٍ مُتراكِمٍ.
هكذا، يصبحُ النَّهرُ نفسُهُ مرآةً ثانيةً للغربةِ، مرآةً تكشفُ عن ذاتٍ مثقلةٍ بما اختزنتهُ. والمقهى يتجاوزُ كونهُ مكانًا عابرًا لاحتضانِهِ لتلكَ الأسئلة؛ إذ يفتتحُ دهليزًا آخرَ لمواجهةِ الذَّاتِ بذاتِها.
»طافَ في مملكةِ اللهِ. . رأَى ما لا يُرى
رافَقَتْهُ لغةُ الأسئلةِ الأولى إلى حيثُ مَضى
كلَّما حاوَلَ أن يفتَحَ أبوابَ الرّضا
وقفتْ بينهُما نارُ الغضا
طافَ في ما تَفْتَحُ الألفةُ من حالٍ. .
وما يغلقُهُ الشكُّ ..
أكانتْ مُدُنا تلكَ التي مرَّ بها ؟ «
في مملكةٍ لا يطالها البصرُ، يعبرُها الشّاعر متّكئًا على لغةِ الأسئلةِ الأولى، وأبوابُ الرّضا مُغلقةٌ بجمرٍ خفيٍّ. هكذا، يتداخلُ الجمرُ والنّارُ، العبورُ مشروطٌ بالاحتراقِ؛ إذ، لا تجلٍّ دون لهب. وما لا يُرى يتخفّى في هيئةِ حفلٍ صامتٍ، حيثُ الأرواحُ تكشِفُ أسرارَها لتعودَ فتسترها بالمسوحِ.
»كما الرُّهبانُ في حفلٍ . . رآها
كلّ ما تَكْشِفُهُ الروحُ تُغطّيه المسوحُ
كانَ يخافُ البحرَ . . ينأى عنهُ في اللَّيل . .
وما شارَكَهُ في صَخَبِ الموجِ إذا جاءَ النَّهارْ «
في هذه المشديّة، يتحوّلُ المقهى إلى بحرٍ آخرَ: صاخبٌ في النَّهارِ مخيفٌ في اللَّيلِ، غيرَ أنَّ الصّمتَ فيه أشبهُ بقوّةٍ خفيّةٍ، ليعودَ المقهى ويمتلئُ بانعكاساتٍ متشظّيةٍ بالحضورِ. والأسئلةُ الجارحةُ تتفتّحُ كطعناتٍ تستيقظُ في نحرِ الذّاكرةِ، تذوي في هيئةِ وردةٍ، قبل أن تمتدَّ لتفيضَ بهيبةِ النّهرٍ. والغريبُ، الّذي يمضي نحو شيخوخةٍ مربكةٍ، يستبقي في قلبه الحنينِ، محاطًا بوردٍ خلاسيٍّ، مرسلًا من نخيلِ الطّفولةِ إلى قفارِ الغربةِ.
ليلٌ مشتعلٌ بالغيابٍ، يولد من فناءٍ يفتحُ على صلاةٍ، والنَّهرُ الفراتيُّ سرٌّ متوهّجٌ بالانتظارِ. والبنيّ -من أشهر أسماك نهر الفرات- المجلوبُ على موجةٍ يقتربُ ساخرًا، يحمل طابعَ الرّفضِ والاختطافِ، فيما الغيابُ يتكدّسُ حتى يصيرَ سُكرًا وارتباكًا. وحين يمضي النّهرُ إلى نجمتٍهِ الأمّ، يبقى الفقدُ وحده يجرّنا إلى الحرمانِ، وعطاياهُ الغائبةُ لا يخلفها إلا بردُ الشّتاءِ، كأنَّ آخرَ ما يُطفأ هو جمرةُ الطقسِ، ليتركنا في فراغٍ مشتعلٍ بغيابِ السرّ.
وحينَ يزدحمُ المقهى بأفواجِ الرَّمادِ، تبلغُ القصيدةُ ذروةَ الاعترافِ لشاعرٍ يرى نفسَهُ وأقرانَهُ المفكّرينَ والكبارَ الذين استنزفتهم الحياةُ، جالسينَ في المقهى وقد تآكل بريقُهم، فصاروا رمادًا حيًّا؛ هذا ليس موتًا، إنّما اشتعالُ الذّاكرة وما تركَ في النّفسِ من أثر. جلسوا في المقهى مجتمعينَ في لحظةِ انطفاءٍ جماعيّ، يعاقرونَ صمتَهم ووعيَهم. تلكَ اللَّحظةُ، تتفجّرُ من الدَّاخل حيثُ يضطربُ الخيالُ ويجرُّ الرّوحَ إلى عرباتِ الزّوال.
هنا يسدّدُ السؤالُ ضربتَهُ، ارتطام بجدارة: إلى أيّ مدى يصبح ُالعابرُ تابعًا لما يتخلّقُ في داخلِهِ؟
»بعدَ أن يزدَحِمُ المقهى بأفواجِ الرّمادُ
تلِدُ اللّحظة بركاناً ثقيلَ الظلِّ مِنْ نسجِ الخيالْ
أيجاريها . . ويجري خَلفَها ؟!
لا ..
هل رأى فيها الَّذي كانَ بِهِ ؟!
لا ..
غادَرَ المقهى إلى الشَّارعِ لا يبحثُ عَنْ شيءٍ . .
غدا سوفَ يعودْ. . «
اللّحظةُ التي تلِدُ بركانًا هي في حقيقتِها انتفاضةٌ داخليةٌ: استعادةٌ للشَّبابِ والطُّفولةِ، اندفاعٌ للذّكرى من بينِ الرُّكام. كأنَّ الجالسَ في الرَّمادِ لا يزالُ يحملُ جمرًا مخفيًا، ينفجرُ للحظةٍ ويذكّرُهُ بما كان. ولكنْ، هذا البركانُ سرعانَ ما يثقلُ ويغلقُ عليهِ الأفقَ، فيعودُ إلى إدراكِهِ المريرِ ويستفيقُ من كبوتِهِ، ويغادرُ إلى الشّارعِ الَّذي هو امتدادٌ للمقهى، وهو يعيدُ تردادَ صدى اللَّحظةِ؛ العودةُ التي يعلنها مواجهةٌ مؤجّلةٌ، تتربّصُ بالغريبِ في الغدِ، إذ لا يغادرُ حقًا إلا ليعودَ إلى دهليزِهِ، محمولًا على وعدٍ يتجدَّدُ معَ كلِّ احتراق.
أمّا تكرارُ «لا» مرّتَين، فهو إيقاعٌ داخليٌّ أشبهُ بضربةِ قلبٍ متردّدةٍ، ونَفَسٍ يُقطعُ ثم يُعادُ، يعكسُ مقاومةَ الشّاعر لذاتِهِ: رفضَ أن يرى في الرّمادِ ماضيَهُ، ثم امتنعَ أن يعترفَ أن ما فيهِ قد انتهى. الإيقاعُ هنا رفضٌ مزدوجٌ، لكنّه في النّهايةِ يظلُّ هشًّا أمامَ اليقينِ، يشبهُ ارتجافَ اللّّحظاتِ الأخيرةِ قبلَ التّسليم.
»غدًا سوفَ يعود» هي عودةٌ إلى الدَّائرةِ نفسِها: المقهى، الرّّمادُ، الذّكرى، ثم مواجهةُ العجزِ: إنّها دورةٌ وجوديّةٌ تتجدَّدُ معَ كلّ نفَسٍ لا تنتهي.
غدًا سوفَ يعود...
□ كاتبة وباحثة لبنانية


 إستبعاد فرض حظر في يوم الإقتراع والأمن يدخل حالة إنذار قصوى
إستبعاد فرض حظر في يوم الإقتراع والأمن يدخل حالة إنذار قصوى
 الصدر يستنكر صمت الدول إزاء ما يحدث في السودان
الصدر يستنكر صمت الدول إزاء ما يحدث في السودان
 عملية طارئة تنقذ مريضاً مسنّاً في مستشفى عام
عملية طارئة تنقذ مريضاً مسنّاً في مستشفى عام
 شغفي الذي يحمل وجعه
شغفي الذي يحمل وجعه
 الأمر والالزام في النقد : ايف سيدغويك و فريدريك جيمسون
الأمر والالزام في النقد : ايف سيدغويك و فريدريك جيمسون
 هل ستتخلى امريكا عن سياستها في العراق ؟
هل ستتخلى امريكا عن سياستها في العراق ؟
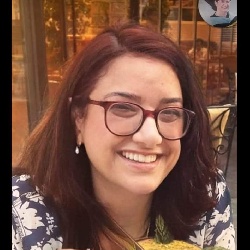 قراءة نقدية لقصيدة يعاتبني الشوق للشاعر رياض الدليمي .
قراءة نقدية لقصيدة يعاتبني الشوق للشاعر رياض الدليمي .
 مفاهيم تعيين مارك سافايا ما بين تداعيات الوضع في العراق وتداعيات الوضع في الولايات المتحدة
مفاهيم تعيين مارك سافايا ما بين تداعيات الوضع في العراق وتداعيات الوضع في الولايات المتحدة
