


الجد الكبير ...بين ضلال الطريق وصوابه في قصص عبد الامير المجر
حسين حمزة الجبوري
لقد تناول السرد العراقي رمز " السلطة المتعالية " وما تحمله من دالات مهمة في أبعادها الميتافيزيقية – والوجودية ، وكان القاص عبد الامير المجر قد وقف عند هذا الرمز في قصتين من قصصه الأخيرة ، الأولى قصة " عودة الجد الكبير " التي هي دعوة أو "إبلاغ " من والد الشخصية لولده بالاستعداد لحضور تجمع العائلة في صالة كبير " آل رحمن " للقاء الجد الكبير " عبدالرحمن " بعد عودته من الموت ، مما أثار استغراب شباب العائلة ، ما بين الشك من هذه الدعوة ، وأمر العودة للحياة مرّة أخرى التي لا تتحقق إلا في عصر المعجزات وبين السخرية و الانتظار في الوقت نفسه ، وهكذا لبى أبناء العائلة جميعا الدعوة التي بدت ضرورية لمعرفة أصلهم ، ولكن الجد "عبدالرحمن " لم يحضر في موعده ، وطال انتظارهم له ، وقد انتاب الجميع النعاس ، فناموا قرب بعضهم في زحمة الصالة بالحضور ، وفي نومهم " حلَّ " عليهم طيف الجد الكبير ، ولكنه صعقهم بخبر فاجع ، وعجيب ، بأنه كان عقيما ، ولم ينجب أحدا من أجدادهم ، على الرغم من أنه تزوج من نساء عدة ، مما دعاه لتبني أطفالا من مشارب شتى ، ولقد عاش هؤلاء الأطفال وكبروا دون أن يعرفوا أنهم ليسوا أخوة ، و" هكذا التأم شمل العائلة التي عاشت وراحت تتوالد وتكبر وتتوزع بين الأماكن الكثيرة .." كما يقول الطيف ، أو الرؤيا التي هي في القاموس " ما يراه النائم في نومه " وهي " كشف تجلّي الذّات الإلهية للصوفيين "..ولكن لم يكن هؤلاء من الصوفيين ، إنما كانوا يبحثون عن ذواتهم وأصلهم ، ومصيرهم أو أنهم يبحثون عن حقيقة الوجود ، وهذه الحقيقة فعالية حركية لا تتوقف ، ولاسيما أن الإنسان وحده هو الذي يسعى إليها ، والكائن وحده هو من يبحث لمعرفة كينونته من خلال علاقاته المتناقضة مع موجودات العالم الأخرى ، لتكون هذه الموجودات نافذة يطل من خلالها على كينونته بما يصاحب هذه العلاقات من توترات يراد منها كشف الحقيقة ، وقد لعب الفن والسرد في هذه الساحة المهمة لكشف حقيقة الذات ، و ماهيتها ، ولكن " الكشف " ربما يتم تزييفه وتحريفه بإرادة سلطة عليا بما فيها السلطة الميتافيزيقية أو سلطة النظام الأبوي للحفاظ على سطوته وقوته ، مما يحجب الحقيقة ، ولهذا كان نيتشه يهاجم جميع وسائل التزييف و الخداع ، و لاسيما في الأخلاق بأبعادها الميتافيزيقية – الدينية بما تحمله من تبعات مختلفة تعيق سعي الإنسان للتحرر من ربقة التبعية لمنبع متعال ، ولاسيما ان " الجد الكبير " هو أساس المتعالي ، و منبعه الأبوي ، وهو الذي يعيق أي تحول أو تحرر من جحيم تزييف هذه السلطة للحقائق فهي تفرض حضورها على الجميع ، وهي التي تقمع حرية الكائن ، ومن ثم كان " الطيف " اختراع – ميتافيزيقي - و خدعة من خلال أساس " الطيف " بما يحمله من أبعاد تخيلية – شعرية ، ومن ثم فهو رهين توهمات مختلفة ، و لكن شباب العائلة حاولوا ان يجعلوا من هذا الطيف حقيقة ، مستغلين ما كشفه من التشكيك في الأصل وهذا يسندهم في التمرد على ما يفرضه الاباء أو السلطة المتعالية عليهم بوصفهم من " الأصل " واحد ، مقابل ذلك كانت السلطة الأبوية تستند إلى قوة هذا " الأصل " وحقيقته استنادا إلى الشبه بين ابناء العائلة ، وصورة الجد الكبير عبدالرحمن المعلقة في صدر الصالة ، وهذا الشبه – عندهم - يدحض " الطيف " ، ويكذبه ما دام هو طيفا متخيلا ؛ ولما كانت العائلة ، والقبيلة هي الأخرى متعال بقوانينها ، وقيمها التي تحبط وتعيق إدراك الذات لذاتها من خلال استقلاليتها – إذ إن الآخرين هم الجحيم - أو بتعبير هيدغر أن " الهُمْ " يفرض على الكائن ضروراته ولاسيما ان الموجود / الكائن يدرك أنه : مقذوف إلى العالم دون أي اختيار من قبله وينبغي تشكيل وجوده من خلال حريته التي يسعى إليها لاختيار طريقه للوصول إلى هذه الذات وكينونته ، ولكن السلطة المتعالية تعيق حريته وبحثه عن حقيقته ، لأن السلطة على نحو عام لها رغبه في منع السؤال ، بل تحريمه ، ومن ثم لا تقبل البحث عن كينونة رعيتها لمعرفة ما في هذا الموجود من خوف من الحاضر و المستقبل ، والقلق الذي هو شعور عميق عند الموجود ، وما تحسه الذات المقموعة والمتوجسة من زيف " الأصل " وهنا كان " الاختلاف " عميقا وبدت الأسئلة أكثر شمولا ، ولكن سلطة عائلة" ال الرحمن " لم تنتفض على الأصل الأبوي - الغيبي ، وأن أُثيرت فيه الشكوك ، لأن هذه السلطة تعد قبول الواقع القائم حتى وان كان تزييفا ضرورة للعلاقة البشرية التي كانت قائمة بين أبناء العائلة حتى لكأن العلاقات البشرية وضروراتها ، تقبل الزيف على حساب الحقيقة ، لهذا ظلت العائلة تحتفل بهذا اللقاء من كل عام ، وكائنهم قبلوا " الخديعة " ولكنهم لم يقبلوا " الخسارة " وقد بقيت آصرتهم العائلية المتوهمة قائمة على " الأصل " المتوهم ، لأن المتعالي هو ركن ركين من أركان تجربتهم الحياتية ، والروحية مع أنهم ضلوا طريقهم إليه ، أو قبلوا بهذا الضلال للوصول إلى حقيقتهم ، وهكذا يبقى الإنسان يطرح اسئلته في الضلالات كلها ، وهو يبحث عن طريق اليقين أو " ما لم ينوجد بعد " ، ومن ثم يبقى في بحث مستمر عن كينونته و مصيره . أما القصة الأخرى للقاص عبد الامير المجر ، فهي قصة " حارسان " ..إذ يجد الطفل نفسه ، وقد تاه عن عائلته وأصله ، وهو الآن يبحث عن طريق الوصول إليهم ، وقد بدت الحكاية مثل الحلم – كما في القصة السابقة – فوجد الطفل نفسه بين عملاقين " يكاد يلامساني واشعر إن كل واحد منهما يريد أن يستأثر بي لوحده .." وعلى الرغم من أن الطفل في البداية صدق نوايا العملاقين في إيصاله لطريق أهله ، وشعر بالاطمئنان معهم ، ولكنه سرعان ما وجد نفسه في ورطة ، فقد كان العملاقان مثله لا يعرفان الطريق ، ويعيشان الضلالة ذاتها ، والتزييف نفسه بل والوعود الكاذبة عينها ، فهما يتخبطان في الطرق والمفازات دون دليل يوصلهم ، فهل هذه هي الأخرى رحلة الى الوهم أم هي رحلة البحث عن اليقين ؟!! لكأن النهج الميتافيزيقي يفرض هذا السؤال في هذا التيه الطويل ، ولهذا ظل الطفل يسأل عن طريق أهله أو إلى أصله ، ولكن العملاقين كانا متنافرين ، يعيشان لحظات من الاختلاف العنيف ، فان طرح العملاق الذي على اليمين رأيا خالفه الآخر الذي على اليسار ، فيرد العملاق الأول على الآخر بالضرب ليردها هذا الآخر عليه فتقع ضرباتهم على رأس الطفل وجسده ، على هذا " الإنسان الحائر – الضال " الباحث عن مصيره ، فيفقد الطفل وعيه ، وحين يستعيد هذا الوعي يجد نفسه معهم في تيه آخر ، وهكذا تستمر رحلة الحلم " التوهم " وحين يستريحون جميعا ، يجد الطفل العملاق الذي على يمينه " يتهجد وكنت أرى الدمع ينهمر من عينيه بصمت ، " واما الذي على يساره فكان " مشغولا بتأمل ذرات الرمل التي راح يتفحصها وأحيانا ينفخها " و يبدو ان هذه الثنائية للعملاقين يمكن ان تحيلنا إلى ثنائية الدين – والعلم ، التي شغلت الثقافة والفكر والأدب طويلا وما زالت ، فعملاق اليمين –هو رمزا للدين و عملاق اليسار رمزا للعلم وهما في ضلالاتهما الكبرى ، فضلا عن هذه الرمزية ، فأن هذه الرحلة تحمل أيضا في طياتها رحلة الوجود نفسه ، أو أنها رحلة زمن الكائن الكوني في هذا الوجود الغامض ، وقد احجم الطفل عن طرح السؤال الوجودي الممنوع ، لأن سؤاله يثير غضب العملاقين ، وينشب بينهما الصراع فيكون ضحيته ، ولكن بعد التحول السريع في الزمن السردي ، يجد الطفل نفسه بعيدا عن العملاقين فلقد اختفيا عن المشهد السردي تماما ، وسرعان ما يجد الطفل نفسه ، وقد صار شابا يافعا ، في مواجهة مصيره ، وبحثه عن حقيقة الوجود ، فكأن التيه " الأول " انتهى ليجد نفسه في طريق يسعى فيه لأن يسترد حريته ووعيه ، وهو يبحث عن كينونته ، ومن ثم لم يعد الشاب راغبا في العودة إلى أهله ، أو هذا الضلال ، فهذه الأرض واسعة وهو يريد أن يسعى فيها ، ليواصل أسئلته دون قيد من احد للوصول إلى الطريق الذي يهديه إلى آفاق طريق الذي " لم ينوجد بعد "- بحسب هايدغر - وهو رصد فيما يظن أنه سعى في طريق الآتي من الزمن ، و المستقبل الذي هو شاغل الفن – أصل العمل الفني – إذ إن الفن هو الذي " يؤسس للوجود من خلال الكلام " / ينظر إنشاد المنادي -62-63/ والفن عموما ومنه القصة والشعر هو الذي يرصد " مالم ينوجد بعد " في الوجود الذي ما يزال في غائبا ، ويحاول الفن أن يستنبطه من خلال ما يرصده الفن في سعي الموجود إلى ما ينتظره في المستقبل ، فهل ما يزال هذا طريق في أفق المستقبل ،أو أنه ما يزال يتبلور في مكان آخر، وإن سعي الكائن / الموجود ما يزال يتعثر في الوصول إليه ومن ثم يحاول مرات للوصول ؟! تلك أسئلة الموجود / الكائن التي تظل قائمة في كل زمان و مكان . وقد تبنى عبد الامير المجر هذه الأسئلة بقصدية شعرية في قصتيه ولاسيما أنه ترك نهاياتهما مفتوحة ، ويبقى سؤال " الأصل " قائما ، وسؤال شباب عائلة ال رحمن في الأصل والخديعة مطروحا ،و طريق الطفل- الشاب قائما أيضا ، وهذا يعني أننا جميعا نبحث عن طريق الذي " ما لم ينوجد بعد ". في الشعر والحياة.


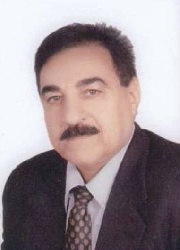 لا تعولوا على الأجنبي لأنه يستعبدكم
لا تعولوا على الأجنبي لأنه يستعبدكم
 حشد إعلامي عالمي غير مسبوق شارك في إفتتاح المتحف المصري الكبير
حشد إعلامي عالمي غير مسبوق شارك في إفتتاح المتحف المصري الكبير
 عبد الكاظم البطاط.. أسطورة الصمود والزهد في خنادق الأهوار
عبد الكاظم البطاط.. أسطورة الصمود والزهد في خنادق الأهوار
 الملف غير التقليدي لمبعوث ترامب الجديد
الملف غير التقليدي لمبعوث ترامب الجديد
 الكاتب المجري لازولو الحائز على جائزة نوبل 2025. . الحياة دائمة التصحيح
الكاتب المجري لازولو الحائز على جائزة نوبل 2025. . الحياة دائمة التصحيح
 عبد الحميد يتحدّث بثقة في دورة الألعاب الآسيوية: إعتمدنا على النوعية وليس الكمية وبعض الإتحادات أثبتت جدارتها
عبد الحميد يتحدّث بثقة في دورة الألعاب الآسيوية: إعتمدنا على النوعية وليس الكمية وبعض الإتحادات أثبتت جدارتها
 إجتماع تنسيقي يضع خارطة الطريق لكأس السيدات 2029 في أوزبكستان
إجتماع تنسيقي يضع خارطة الطريق لكأس السيدات 2029 في أوزبكستان
 في نقد نظرية الإئتمان الفلسفية للفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن
في نقد نظرية الإئتمان الفلسفية للفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن
