
الثقافة واللاجئون.. من سردية المعاناة إلى الفاعلية السياسية
عصام البرّام
في السنوات الأخيرة، لم تعد قضية اللجوء مجرّد ملف إنساني يطفو على سطح نشرات الأخبار كلما تجددت الحرب أو اشتدّت الأزمات، بل غدت مساحةً ثقافية وسياسية معقدة، يتداخل فيها البُعد الرمزي مع اليومي، ويقترن فيها الألم بالتخييل، وتنهض فيها أسئلة الهوية والاندماج والتمثيل جنباً إلى جنب مع أسئلة السلطة والمشاركة والفاعلية. فقد تحوّل اللاجئ، في كثير من الخطابات السائدة، إلى رمزٍ للعجز، وإلى مرآة تعكس هشاشة العالم الحديث وعدم قدرته على منع الانهيارات، غير أنّ هذه المرآة تحمل أيضاً قدرة على إعادة تشكيل العلاقة بين الثقافة والسياسة، بين من يروي الحكاية ومن يُروى عنه، بين مركزية الصوت وغربته. هنا تحديداً يتبدّى التحوّل: من سردية المعاناة التقليدية إلى مساحات تتفتح فيها الفاعلية السياسية، ويستعيد فيها اللاجئ دوره بوصفه فاعلاً لا موضوعاً، وصاحب خطاب لا مجرد ضحية.
اللاجيء خارج الزمان والمكان
إن الثقافة، سواء كانت في صورة الأدب أو السينما أو الفن أو الإعلام، لعبت دوراً مركزياً في صياغة الصورة الأولى عن اللاجئ. في البداية، كانت الصورة تميل إلى التشييء؛ جسدٌ متعبٌ على الحدود، أمّ تحمل أطفالها في الطين، رجلٌ يعبر البحر كمن يعبر قبره المؤجل. هذه الصور، رغم صدقها وقسوتها، أسهمت في تكريس اللاجئ ككائن خارج الزمان والمكان، وكأن وجوده مؤقت، ناتج عن خلل استثنائي في النظام العالمي. هكذا صار اللاجئ معطى بصرياً وأخلاقياً يثير التعاطف لكنه يُفرغه من القدرة على الفعل. كانت هذه المرحلة الأولى: مرحلة سردية المعاناة، حيث تُختزل التجربة الإنسانية الهائلة إلى لحظة عبور، أو نظرة خوف، أو استعطاف يطلب النجاة.
لكن الثقافة نفسها، بتعدد أصواتها وقدرتها على إعادة إنتاج الرموز، كانت أيضاً الجسر الذي عبر عليه اللاجئون نحو استعادة صوتهم. فحين بدأ كتّاب وشعراء وفنانون من خلفيات لجوء يروون قصصهم بلغاتهم الخاصة، تغيّر المشهد جذرياً. لم تعد الحكاية تروى من الخارج، بل من الداخل، من رحم التجربة ذاتها، بكل ما فيها من تناقضات: الحنين والغضب، الضعف والقوة، الفقد والرغبة في بناء مستقبل جديد. هذه النصوص والفنون لم تكتف بكسر الصورة النمطية، بل فتحت باباً واسعاً لتفكيك العلاقة بين الهوية والسلطة، وبين الذاكرة والمكان، وبين الإنسان وحدوده.
في هذا السياق، تصبح الثقافة ساحة صراع، لكنها أيضاً ساحة تَخَلُّق. فالصوت الذي كان غائباً أو مُغيّباً، يصبح جزءاً من المشهد العام، ويتحوّل اللاجئ من متلقٍّ إلى منتج، من موضوع للخطاب إلى صاحب خطاب قادر على مساءلة العالم الذي لفظه أو احتضنه. إنها لحظة تحرر رمزية، لكنها ذات أثر سياسي يتجاوز الرمز، لأن الخطاب هو الخطوة الأولى نحو الفعل، والنص الذي يكتبه اللاجئ ليس مجرد اعتراف، بل هو إعلان حضور، وكتابة وجود، وتأسيس لمجال مشترك بين الذات والعالم.
اللاجئون منتجون في عالم الثقافة
على المستوى المجتمعي، تكشف الثقافة عن قدرة اللاجئين على إدخال عناصر جديدة إلى فضاء الحياة اليومية في البلدان المضيفة. ليس الأمر مجرد أطعمة جديدة أو احتفالات شعبية، بل هو تفاعل ثقافي يعيد تشكيل المفاهيم، ويسهم في خلق مساحات مشتركة. فالفنون التي يقدمها اللاجئون، سواء عبر المعارض أو المسرح أو السينما، لا تحمل خطاب الألم فقط، بل تقدم رؤى جديدة للعالم، وتطرح أسئلة تتجاوز حدود الجغرافيا التي انطلقوا منها. وهنا تتجلى الفاعلية السياسية بأحد أشكالها: فحين يتحول اللاجئ إلى مشاركٍ في إنتاج الثقافة، يصبح مشاركاً في إنتاج المعنى، وهذا شكل من أشكال القوة؛ لأن من ينتج المعنى يمتلك القدرة على تغيير النظرة وإعادة توزيع الأدوار داخل الحياة العامة.
لكنّ هذا التحول لا يحدث في فراغ. فالمؤسسات الإعلامية والسياسية ما زالت تميل إلى استخدام سردية المعاناة لتثبيت أنماط معينة من التمثيل. فهي سردية سهلة، مفهومة، قابلة للاستهلاك السريع، لكنها في الوقت نفسه تقود إلى تهميش التجربة اللاجئة، وتثبتها داخل إطار لا يسمح لها بالتطور. إنها سردية تجعل اللاجئ «آخر» دائماً، وتمنع عنه اكتساب شرعية سياسية أو اجتماعية. وفي المقابل، تعمل الثقافة النقدية، في الأدب والفن والخطاب الأكاديمي، على تفكيك هذا النمط، وتقديم اللاجئ كذات معقدة، لها تاريخ وذاكرة وصوت وخيارات.
وفي قلب هذا كله، تظهر مسألة الهوية بوصفها إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في تجربة اللجوء. فاللاجئ يعيش حالة ازدواجية: ليس ابناً كاملاً للوطن الذي غادره، ولا مواطناً كاملاً للوطن الذي وصل إليه. يعيش بين لغتين، بين اسمين، بين سرديتين. وهذا التوتر، رغم قسوته، ينتج طاقة إبداعية هائلة، لأن الذات تستكشف مناطق جديدة من المعنى، وتعيد تعريف نفسها من خلال ما فقدته وما اكتسبته. هنا يصبح الأدب، مثلاً، مجالاً لإعادة كتابة الذات، لتحويل الفقد إلى معرفة، والرحيل إلى احتمال جديد للوجود. ومن هذه النقطة تحديداً تنطلق الفاعلية السياسية: من الاعتراف بالذات ومن القدرة على التعبير عنها علناً.
ذاكرة اللاجيء ونتاجه الثقافي
يتطور الوعي السياسي للاجئين كرد فعل على محاولة تغيير مصيرهم من الخارج. فالسياسات التي تنتج خطاب الخوف أو خطاب الرحمة لا تمنح اللاجئ أي سلطة، بينما يمنحه الفعل الثقافي سلطة تشكيل صورته. إذ يستطيع الفنان أو الكاتب أو المخرج أن يقلب الصورة رأساً على عقب، أن يُظهر التعقيد في موضع كانت السردية السائدة تريد التبسيط، وأن يكشف عن القدرة في موضع أراد الخطاب الرسمي إظهار العجز. هذا التغيير في التمثيل ينعكس لاحقاً في الفضاء العام، في النقاشات السياسية، في نظرة المجتمع، وفي قدرة اللاجئين أنفسهم على المطالبة بحقوقهم.
ولا تقل أهمية الذاكرة في هذا السياق، فاللاجئ يعيش في علاقة معقدة مع ماضيه؛ فهو محتفظ بذاكرة وطنٍ غالباً ما يحمله معه كأنّه حقيبة لا يمكن تركها، لكنه في الوقت نفسه مضطر لبناء ذاكرة جديدة تتناسب مع مكان جديد.
هذا التشابك بين الذاكرتين يجعل منه كائناً يعيش على حدود الأزمنة والأمكنة، والمفارقة هنا أن هذه الحدود التي أرادتها القوى السياسية خطوط فصل، تتحول بفعل الثقافة إلى جسور وصل. فمن خلال الذاكرة، يستطيع اللاجئ أن يربط المكان القديم بالجديد، وأن يبني سردية شخصية تتحدى السردية السائدة عن أنه كائن بلا جذور.
من الأزمة الإنسانية الى قضية سياسية
وعلى الجانب الأوسع، تُسهم الثقافة في تحويل قضية اللجوء من مجرد أزمة إنسانية إلى قضية سياسية بامتياز. فهي تكشف أسباب اللجوء، وتحلل البنى التي تسببت به، وتربطه بالاقتصاد والسياسة والهيمنة. كما تُظهر أن اللاجئ ليس فرداً معزولاً، بل جزء من حركة عالمية تعكس اختلال النظام الدولي. وفي هذا السياق، تصبح الفاعلية السياسية للاجئين جزءاً من فاعلية أكبر، تتعلق بما يمكن أن تسهم به المجتمعات في مقاومة الحروب، وفي إعادة التفكير في معنى الحدود، وفي نقد الأنظمة التي تنتج النزوح والتهجير.
فاعلية اللاجئين
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن الطريق نحو الاعتراف الكامل بفاعلية اللاجئين ما يزال طويلاً. فالعالم، رغم انفتاحه الظاهري، ما زال يضع عوائق قانونية وثقافية تحول دون مشاركتهم الفعّالة. لكن الثقافة، بفعلها المستمر والمتعدد الأشكال، تبقى قادرة على خرق هذه الحواجز، وعلى إبقاء السؤال حيّاً: من يملك حق الكلام؟ من يملك حق الظهور؟ ومن يملك حق تعريف ذاته؟
أخيراً، يمكن القول إن التحول من سردية المعاناة إلى الفاعلية السياسية ليس تحولاً بسيطاً أو خطياً.
إنه فعل مقاومة، وممارسة يومية، وتجربة طويلة من التفاوض بين الذات والعالم. لكنه يحدث، وتحدث معه إعادة تشكيل جذرية للخطاب حول اللجوء.
ففي اللحظة التي يصبح فيها اللاجئ قادراً على قول «أنا» بصوت واضح، ويستطيع فيها أن يروي حكايته كما يريد، لا كما يُراد له، تبدأ السردية الجديدة بالظهور؛ سردية لا تُنكر الألم، لكنها لا تُسلم له بالمطلق، وتمنح اللاجئ حقاً أساسياً: حق أن يكون ذاتاً، لا موضوعاً؛ فاعلاً، لا تابعاً؛ مواطناً في العالم، لا رقماً على قوائم النزوح.
وهكذا تتقاطع الثقافة والسياسة عند نقطة واحدة: إستعادة الإنسان، ومن هنا تبدأ الحكاية الحقيقية.


 البارزاني يلتقي في أربيل مبعوث ترامب إلى سوريا بحضور عبدي
البارزاني يلتقي في أربيل مبعوث ترامب إلى سوريا بحضور عبدي
 اتفاقيات الأمس وأزمات اليوم: من الجزائر 1975 إلى حدود إيران وباكستان
اتفاقيات الأمس وأزمات اليوم: من الجزائر 1975 إلى حدود إيران وباكستان
 الجبوري: من دجلة والطب والصيدلة إلى الكورال السويدي
الجبوري: من دجلة والطب والصيدلة إلى الكورال السويدي
 هل تود الهروب من قيود التكنولوجيا والعودة إلى حياة أكثر توازنًا؟
هل تود الهروب من قيود التكنولوجيا والعودة إلى حياة أكثر توازنًا؟
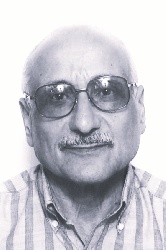 هل تؤدي سياسات ترامب إلى فوضى شاملة؟
هل تؤدي سياسات ترامب إلى فوضى شاملة؟
 بريطانيا ترفع سن إستدعاء العسكريين القدامى للخدمة إلى 65 عاماً
بريطانيا ترفع سن إستدعاء العسكريين القدامى للخدمة إلى 65 عاماً
 إلى الكاظمية.. حين تمشي القلوب قبل الأقدام
إلى الكاظمية.. حين تمشي القلوب قبل الأقدام
 من باريس إلى حلب.. كيف تدار معركة النفوذ ضد قسد ؟
من باريس إلى حلب.. كيف تدار معركة النفوذ ضد قسد ؟
