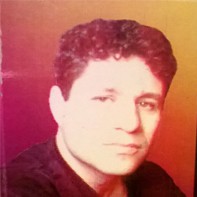
الشعر .. ثيمة فكرة و تقنية
سوران محمد
كثيرا ما يكتب الشعر والنقد والدراسات الشعرية هذه الأيام، بغض النظر عن رفضك أو أعجابك بهذه المحاولات، لكن نادرا ما نقرأ كتابا أو مقالا يتناول حيثيات الشعر و يتحدث عن ألف باء كتابته، لأن الذي يستطيع القيام بهذا الأمر هم الشعراء-النقاد، كـ (تي أس أليوت) و طه حسين و محمد اقبال وغيرهم على مر العصور وعلى سبيل المثال لا الحصر، ولكن ليس بوسع كل النقاد خوض هذا الغمار، وليس هذا تقليلا من شأنهم، بل لأن الشعراء-النقاد يعيشون تلك اللحظات الشعرية و يمرون بحلوها ومرها وهم أقرب الى نبض الشعر من غيرهم، لذا هم أدرى من غيرهم فيما يدور في جنباتهم منذ اتيان الالهام و حين ولادة الشعر من أعماق النفس الى ان يرى النور بنشره في الكتب أو الصحف الادبية والمنصات الاجتماعية، ويمكن للشاعر الحفيص ذو عين نقدية أن يحيط بتلك الحيثيات و يدونها لغيره من باب الاخذ بدروسها والاستفادة من خبراته الشخصية، وبعد انتاج العمل الشعري يمتلك القراء هذا الشعر، يتقاسمون و يتشاركون الشاعر في جوانبه الابداعية، يلتذون به و يطيرون معه في سماء الاخيلة الشعرية للوصول الى المبتغى الابداعي بالتمعن و تخيل الصور المجازية والغاية القصوى من النظم بالتعمق في معانيه وشعابه، وكما يقول القرطاجني في (منهاج البلغاء و سراج الادباء):” النظم صناعة آلتها الطبع. والطبع هو استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام، والبصيرة بالمذاهب والاغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحى به نحوها؛ فاذا أحاطت بذلك علما قويت على صوغ الكلام بحسبه عملا، وكان النفود في مقاصد النظم وأغراضه وحسن التصرف في مذاهبه وأنحائه انما يكونان بقوة فكرية واهتداءات خاطرية،/ تفاوت فيها أفكار الشعراء”.
على العموم؛ نادرا ما نجد هنا وهناك من يتحدثون عن حيثيات كتابة الشعر و فنونها العديدة، ربما يرجع السبب الى أهمية الموضوع في صنعة الشعر والذي يخص الشعراء دون غيرهم، والشعر يعتبر فنا أدبيا لغويا بحيث تختلف لغته عن الاستخدام اليومي، وقد قال الجاحظ في (البيان والتبيين): “شعر الرجل قطعة من كلامه، وظنه قطعة من علمه، واختياره قطعة من عقله. وقال ابن التوأم: الروح عماد البدن، والعلم عماد الروح، والبيان عماد العلم”.
فاذا اتفقنا جدلا بأن العمل الشعري الثري والمبدع هو توظيف خصائص المادة الأولية للغة، بشقيها الظاهري والمعنوي أي: الالفاظ والمعاني، فأن لهذا الصرح الانساني الخالد حاجيات أساسية تستوجب توفرها في أي قصيدة شعرية كي تكتمل مراحل بناءها و تجتاز طورها و تصبح نموذجا أمثل للأدب المنتج و نعطيها جزءا من وقتنا ونسميها عملا و نتاجا أدبيا معتبرا، بدءا بالموهبة ومرورا بالآليات المستخدمة بالعناية والوعي الى الاختيار الأمثل للموضوع واجتياز حواجز الثيمة الحية والأفكار المتجددة المبدعة، والا سنعيد أنفسنا والآخرين من أسلافنا مقلدا ودون تقديم أي منجز يذكر أو اضافة جديدة على ما أبدعوه من أبدعوا قبلنا...
لا يخفى على الدارس لفنون الشعر بشقيه الشكلي والمضمون، بأن كتابة الشعر هي موهبة قبل الرغبة، وليس للشعر أي جنسية تذكر أو انتماء ضيق الأبعاد، بل انه ينتمي الى الانسانية في المقام الاول، فهناك من السلف من اقتصروا وعرفوا الشعر بالوزن والقافية فقط، ولكن وحسب النظريات الحديثة ليس الوزن والقافية الا رداءا موسمية يلبسه النص الشعري لغرض انجاز بعض تحسينات جمالية، لكن البنية الاساسية والخفية في الشعر هو الجزء الذي يتبقى منه بعد ترجمته الى لغات أخرى، حيث نلاحظ بأن الشعر سرعان ما يفقد الوزن والقافية في اللغة الثانية مع الترجمة، لذا هنالك من رأوا غلوا بأن الشعر غير قابل للترجمة، لكنه بأعتباره عملا انسانيا ذات مضمون روحي يتقاسمه الجميع على وجه الخليقة، وبطبيعته يطرق أبواب وجدان الجميع، يخاطب القلب والعقل قبل أن يكون مصطلحات لغوية، فهو أقرب من الكل ودون الاستثناء.
قصيدة نثر
تكتب سوزان برنار في هذا الصدد عن قصيدة النثر كيف تمرد على السائد و في النتيجة لم تخرج عن دائرة الشعر بأخضاعها لقوانين أخرى مماثلة لكن في ثوب العصرنة، شكلا ولغة : «والمؤكد أن قصيدة النثر تنطوي على مبدأ فوضى و هدام، اذ نشأت من التمرد على قوانين الوزن والعروض، واحيانا على القواعد العادية للغة. لكن كل تمرد على القوانين الموجودة مجبر- فيما لو أراد تقديم عمل أدبي قابل للأستمرار- على أن يحل محل هذه القوانين قوانين أخرى، خشية الوصول الى ما هو غير عضوي وفاقد للشكل. وهي - في الواقع- ضرورة خاصة بالشعر”.
هنالك جوانب مهمة وركائز قوية يبنى عليها أي عمل شعري بغض النظر عن انتمائه الى أي مدرسة شعرية، لكننا قلما درسنا وقرأنا هذه المرتكزات؛ هنالك تفاصيل دقيقة تختزل نفسها في عمل شعري لا يلاحظها الا من يقرأ بأمعان و يتابع بتدبر، خاصة ان معظم النتاجات الادبية في وقتنا الحاضر يفتقد الى الاكتراث به من قبل طبقة النخبة ينظر اليها ويحكم عليها بشكلها الظاهري كوحدة واحدة دون التفكيك والتشكيل والتجزئة، لكنها في الأصل هي قطعة فنية يمكن لأي حرف من حروفها أن تنقلب موازين المعنى. فهناك من الشعراء من يحرص على تحسين مهاراته اللغوية في النصوص، وما يتطلبه ذلك من نحو و صرف وإملاء ونحو ذلك، لكن نصه في الأخير لا يؤدي دوره ، ولا يحدث أي رجفة أو اهتياج في النفس و بناء علىه لا نتأثر به ولا يهزنا من الاعماق كي نعتني به ونحفظه ونتعاطى معه.
بما لاشك فيه ان هنالك ترابط وثيق بين الكلمة والفكر لصياغة المعنى، فالمعنى ليس لوحده تتحرك داخل نص ما بمعزل عن الكلمات، فهما وجهان لعملة واحدة، يستحسن الشاعر المجيد استعمالها و ايجاد الترابط بين مجمل الكلمات والمعنى العام للنص وهذا ليس الا وليد الفكرة، فكل عمل أدبي دون الفكرة يكون شيئا مجوفا أو ربما ينظر اليه لا أكثر من زخرفة أو نسيج ذو ايقاع معين، فالانتقاء واختيار الدال المناسب واستعماله في موقعه الجغرافي الصحيح في النص ليس الا استجابة لمتطلبات الفكرة و خدمة لها. بل يوءكد و يعتبر ابن طباطبا ان أول مراحل ابداع شعري ما هو تجول الفكرة في الخاطر، اذ ان الفكرة هو المعنى والغرض الموحد للقصيدة، بل أبعد من ذلك يرى البعض الآخرون ان الأفكار هي التي تقوم بتشكيل القصيدة وصياغته ومن ثم يتخذ ويشكل اسلوبا معينا. وهنالك من ذهب أبعد من ذلك حينما قالوا بأن التفنن هو الذي يبتكرُ الأفكارَ ويُخفيها في الوقت نفسِه. لهذا ينحاز الشاعر والناقد الانجليزي شيللي الى الانسجام في الفكر أكثر من اخضاعه لنظام شكلي معين حيث يكتب في (دفاعا عن الشعر): “انطلاقا من وجهة نظر فلسفية دقيقة، لا يمكن التقسيم الشعبي الى نثر وشعر. فليس من الضروري أبدا أن يخضع الشاعر لغته لنظام معين من الأشكال التقليدية، وذلك بشرط أن يراعي الانسجام في فكره”.
اذن ايجاد فكرة مناسبة لنص شعري هو أول مرحلة انجاز العمل الانتاجي، وجدير بالذكر ان كل ماتقع تحت أصناف المعاني مثلما ذكره الجاحظ في (البيان والتبيين) يتحكم بها الفكرة و يوظفها في موقع صحيح في جغرافيا النص متماشيا مع النواة الاولى و الفكرة العامة والتشعبات المقطعية : “جميع اصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد، أولها اللفظ ثم الاشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة، والنصبة هي الحالة الدالة، التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات... والاشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ”. من الجانب الآخر هنالك من يعتبرون أن الفكرة هي مرادف للألهام، وهي بمثابة النواة في النباتات والثمار، لا يمكن الغنى عنها، فعلى سبيل المثال نرى من الشعراء المجيدين ينقصهم هذا العنصر لأدامة صنعتهم وهم بأمس الحاجة اليه، فلربما يكون هذا أحد المؤثرات السلبية والعوامل الفعالة للتثبط والعزوف عن كتابة الشعر لفترة ما، لغاية استعادة المادة الخامة والطاقة المعنوية اللازمة لأيجاد ولم الأفكار و نضجها من جديد كي تنفجر منها قصيدة متجددة مبتكرة، يمكن لهذه الافكار أن تأتي من العناصر الحياتية اليومية، كالعلاقات والاحداث والاسفار والمشاهدات، سواء أكان المؤثر صغيرا أم كبيرا، قريبا أم بعيدا.. ثم تتحول الى فكرة لنص ما، مع التشكل في أساليب شعرية عن طريق استخدام ادوات شعرية مناسبة لتَّشكيل نص ما: من تنظيمِ و ترىيب الألفاظِ والمفردات والمقاطع والاستعانة بعلوم البلاغة من التشبيه والمجاز والاستعارة والرموز وصور من الخيال واستكمال التكوين الشعري مجتمعة بعناصرها الأربع حسب تصانيف بعض النقاد: (المضمون، البناء، المعجم، الصور الشعرية) ولكي نتميزه عن الأصناف الأدبية الأخرى.
لقد أوضحنا مما سبق شيئا من أهمية ايجاد و ولادة الفكرة المناسبة لأي نص في داخل نفس الشاعر. ثم تأتي الدور على الثيمة فهي لا تقل أهمية من الأول، فهي ليس الموضوع بعينه ولا ينحصر دوره في كلمة واحدة أو عنوان النص فقط، بل كل ما يتعلق بالمعاني الرئيسية والفرعية تنصف تحت عنصر الثيمة، وهي مبنية على قواعد الفكرة، مستندا ظهرها الى تقنيات الكتابة الفعالة. فهناك من يصف الثيمة بمكانة القلب للجسد، وقد عرفت بأنها «عبارة عن صورة أو كائن أو فكرة يتم استخدامها لبيان سمات النص، فهي تعتبر الإطار الأساسي الذي يضيف عمقا و صدى إلى الأعمال الأدبية، أنها المنظار الذي يستطيع بواسطته القارئ تفسير النص”
أما ناقدتنا المتمكنة نادية هنداوي فهي تطرقت الى هذا البحث ووصفت الثيمة من وجهة نظرها وصفا دقيقا و شبهتها بالمحيط وأما الموضوع فهو كالبحر وأما الفكرة فهي القارب. أي ان الثيمة أشمل وأكبر من الموضوع، فاذا انحصر الموضوع في كلمة أو تعبير واحد، فان الثيمة تستوعب كل المتعلقات الفرعية للمعاني واحالاتها فيما تنطويها المقاطع النصية قاطبة، وهي كما يقول رولاند ب. توبياس: “نظام توجيه يعمل بالقصور الذاتي لخدمتك”.
مع ذكر ما سلفناه، لا يقتصر النص الجاد والناجح على هذين العنصرين فحسب، بل يبحث الشاعر عن تقنيات متميزة لصياغة الفكرة والثيمة لأيصال مبتغاه و اكتمال انجازه الشعري بتميز ونجاح.
تقنيات شعرية
تتضمّن التِّقنيَّات الشِّعريَّة المُختلفة عاملا مهما لأضفاء الطابع الجمالي على النصوص الشعرية بأنواعها الثلاث: الشعر العمودي و شعر التفعيلة أو قصيدة النثر، وهي مجموعة أدوات كالـ: التّكثيف، التّشكيل، الرموز، التعابير، التناص، الاستلهام، المجاز والتشبيه والاستعارة والخيال وغيرها. بحيث تبرز هنا دور اللغة واستخداماتها البلاغية وما تحتويها من فنونها لصياغة النص بما ينسجم مع ما اختاره الشاعر مسبقا و رسم خريطته في مخيلته، ثم ينجرف في شكل سيل جار يأخذ مجراه من منبعه الخام داخل النفس الى مصبه ثم البدأ بمرحلة المراجعة والتصحيح والحذف والاضافة قبل النشر.
كما يزيد البعض الصدق على هذه التقنيات كعامل مساعد لتقوية ثيمة النص متماشيا مع اختيار موضوع الشعر اختيارا أمثل، حيث يعتبر هذا الأمر في غاية الأهميّة؛ لأنّه هو الذي يُشعل الحِس الداخلي في الشاعر، لذا يجب الحرص على اختيار الموضوع بعناية، بأن يُعبر عن الشاعر نفسه أو يكون قريبا من عالمه و رؤاه ومبادئه وقناعاته الذاتية، هنا يبرز أداء الشاعر، سليقته و قريحته الشعرية وتلاعبه الفني للثيمة المتجددة المبتكرة التي اختارها و ترابطه بخيط غير مرئي بالمتلقي، فمثلًا لا يُمكن لرجل غني كتابة قصيدة عن معاناة الفقراء مثلما يكتبها رجل فقير، كما لا يُمكن لرجل غير محب كتابة قصيدة غزل أو حب مثلما يكتبها رجل عاشق.
يقول القرطاجني حول منازل الشعراء من المعاني: «فمراتب الشعراء فيما يلمون به من المعاني اذن أربعة: اختراع واستحقاق و شركة و سرقة، فالاختراع هو الغاية في الاستحسان، والاستحقاق تال له، والشركة منها ما يساوي الآخر فيه الأول فهذا لا عيب فيه، ومنها ما ينحط فيه الآخر عن الأول فهذا معيب، والسرقة كلها معيبة وان كان بعضها أشد قبحا من بعض”و “ان المعاني منها ما يقصد أن تكون في غاية من البيان على ما تقدم، ومنها ما يقصد أن تكون في غاية من الاغماض، ومنها ما يقصد أن يقع فيه بعض غموض، ومنها ما يقصد أن يبان من جهة وأن يغمض من جهة”
ختاما لا يسعني الا ان أذكر ما ذكرتها سوزان برنار عن أسباب مركزية دور رامبو في تأريخ حقبة ماقبل السوريالية الى يومنا هذا لأنه كان أول من أكد –بقوة- على علاقة الضرورة بين الصيغة الشعرية الجديدة وهذا البحث عن المجهول، الذي يجعل من القصيدة الحديثة محاولة ميتافيزيكية، أكثر من كونها شكلا فنيا. فلا ننسى الطبع السائد في الحقبة الجاهيلية من الشعر العربي عندما ربطوا الألهام الشعري بعوامل غير مرئية كالجن أو ما يسميه البعض بشيطان الشعر، لكنه في الأخير ان الشعر هو أقرب نوع أدبي من روح الانسان، لا دخل له لا بالشيطان ولا الجن، اذ تعتبر الجوانب الغيبية في الانسان بكينونتها الثلاث(النفس، الفكر، الروح) المصدر الحقيقي لنبع الشعر الصافي، وهذا هو حال الشاعر الماهر المجيد الذي سيصقله بتجاربه النظرية المعمقة في علوم الشعر و اللغة وبتجاربه الحياتية العملية.
* شاعر ومترجم وناقد
................................
المراجع:
The Use of Poetry and Use of Criticism، T.S. Eliot ،1986 by Harvard University Press١-
٢- القرطاجني، أبي الحسن حازم، (منهاج البلغاء و سراج الادباء)، تحقيق: ابن خوجة، محمد الحبيب. الطبعة الثالثة، دار العربي الاسلامي، السنة ١٩٨٦، بيروت. ص١٩٢
. ٣-أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، الجاحظ (البيان والتبيين)، تحقيق السندوبي، حسن ، دار أحياء العلوم،
ص٣١-٣٢.
٤-برنار، سوزان (قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن)، ترجمة: صادق، راوية، دار شرقيات للنشر والتوزيع، السنة ٢٠٠٠، الجزء الاول ص ٣٤
٥-المصدر السابق ص ٢٩
٦- مصدر رقم ٣/ ص ٣٢-٣٣
iraqpalm.com/ar/article/-Theme٧-مفهوم الثيمة في النص الأدبي، عباس،عبد الكريم حمزة (الناقد)
hindawi.org/books/41862715/12٨-هنداوي، نادية، «الثيمة» تلك البوصلة الخفية
٩- منصور، حسن عبد الرازق، الشعر والعقل- منهج للفهم، دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع ،٢٠١٤، ص١٠٣.
١٠-مصدر رقم ٢، الصفحة١٧٧، ١٩٨ .
١١-مصدر رقم ٤، ص ٣٤.


 إلهام الفلسفة في الشعر العربي : مدخل للتفكير العميق
إلهام الفلسفة في الشعر العربي : مدخل للتفكير العميق
 الشعر خلاص آثم.. ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﺛﯿﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﺎرة ﻋﻼم ﺷﻠﺘﻮت
الشعر خلاص آثم.. ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﺛﯿﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﺎرة ﻋﻼم ﺷﻠﺘﻮت
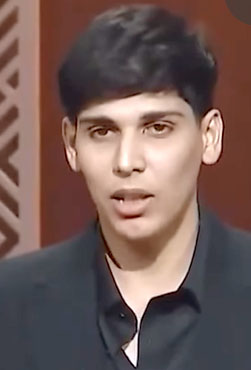 شاب عراقي يبتكر تقنية ذكية لتطوير الزراعة
شاب عراقي يبتكر تقنية ذكية لتطوير الزراعة
 شاذل طاقة.. حارس الضّوء في ممّرات الشعر الحديث
شاذل طاقة.. حارس الضّوء في ممّرات الشعر الحديث
 نمر سعدي في جديده الشعري ساعي بريدِ اللهفة شاعرٌ يواصلُ التحليق
نمر سعدي في جديده الشعري ساعي بريدِ اللهفة شاعرٌ يواصلُ التحليق
 قراءة في المجموعة الشعرية مرثية لرحيل الشمس لبهنام عطالله
قراءة في المجموعة الشعرية مرثية لرحيل الشمس لبهنام عطالله
 الى جواد الحطاب والشعر والزمن
الى جواد الحطاب والشعر والزمن
 امي النجف اميرا للشعر والشعراء
امي النجف اميرا للشعر والشعراء
