


المكان المعادي في روايات أمجد توفيق
صباح هرمز
يلعب المكان في الرواية دورا يفوق بوصفه حاضنا للأحداث، ليغدو عنصرا فاعلا في
إنتقال الشخصيات من فعل الى آخر، وتشكيل وعيها وتقرير مصائرها. فإذا ما تمثل المكان الأليف فضاء حاضنا للاحتواء والهدوء والاستقرار، فإن المكان المعادي يتبدى على النقيض، بوصفه فضاء للفوضى وزعزعة الاستقرار. أو كما ينطلق باشلار من النقطة الأساسية للمكان بشقيه المكان الأليف والمكان المعادي، في هذه العبارة المختزلة بدقة: (هنا هي أن البيت القديم، بيت الطفولة، هو مكان الألفة، ومركز تكيف الخيال، وعندما نبتعد عنه نظل دائما نستعيد ذكراه. .).1
والروايات الأربع لأمجد توفيق التي تناولت فيها المكان المعادي في هذا المقال، من مجموع رواياته الثماني الصادرة خلال تجربته السردية؛ ما من رواية منها تخلو من حضور هذا الفضاء. واللافت أنه في معظمها يتعرض للغربة، بعيدا شخصياتها عن الوطن، والطفولة توقا للعودة إليها، وهو بذلك يتصدى للمكان المعادي من منظور غاستون باشلار في كتابه الموسوم (جماليات المكان)، والمفارقة أن هذا الكتاب، كما يقول مترجمه الروائي غالب هلسا: (هو دراسة للمكان المألوف، ولم يتعرض فيه المؤلف للمكان المعادي، ويتساءل: (ولكن ألا يرى معي القاريء العربي والكاتب العربي أن هذا الطرح قد أثرى مسألة المكانية بمعطيات هامة وخصبة؟).2 أي أنه عبر دراسته للمكان الأليف، يدرس في الوقت ذاته، المكان المعادي أيضا.
1 -طفولة جبل:
مثلما المكان في (وحدها شجرة الرمان) لسنان أنطوان؛ أهم ما في الرواية، للمكان الأهمية ذاتها في طفولة جبل، حيث يشغل رقعة الفجوات التي تركتها التقنيات المتمثلة في الخارج والداخل.
في الخارج: بالجبل والكنيسة والنهر وبيت بهار وكوخ بارق، وفي الداخل: بيت المجنونة وبيت أبيه، ذلك أن كل تقنية من تقنيات المكان هذه تلعب تأثيرها على الكائنات الحية والأشياء التي تحيط بها وتستفيد منها.
اختلاف الاديان
فالجبل علّم الطفل على الصمت وقاده الى صداقة الكائنات الحية وغير الحية، والكنيسة الى المساواة بين البشر بالرغم من اختلاف أديانهم، والنهر الى الحفاظ على الكائنات التي تعيش فيه، وبيت بهار الى رحاب الحرية المديد من خلال كتم صوت بهار الصادح وخنقه، وبيت المجنونة الى الراحة تحت ظل شجرة التوت والتأمل والحوار مع نفسه.
إن دل كل هذا شيء فإنما يدل على هيمنة المكان وسطوته على مجمل شخصيات الرواية، من خلال حشرها في زاوية ضيقة، سعيا لعدم تجاوزها إطار حدوده، وبقائها ضمن دائرته التي تبعث روح الألفة والمحبة في نفوسها
لعل هذا الاستنتاج يقودنا الى أن نتساءل: ترى لماذا عنوان الرواية اقترن بالجبل وليس بالطفل، مع أن الطفل هو الشخصية المحورية لأحداثها؟ وبعبارة أخرى: هل أن للجبل طفولة؟ أم أن الطفل هو الجبل؟!
يبدو لي أن مرد ذلك، يعود بالدرجة الرئيسة – فضلا عن تشابههما حد التماهي - الى ربط الطفولة بالجبل، بوصفه مكانا، بما يمنح الطفل بعدين دلاليين، أولهما أن هذه المفردة تنسحب اليه، ليمسي هو الآخر مثله جبلا، وثانبهما بالرغم من أنهما صديقان، لكن لكل واحد منهما اهتماماته.
لم تقتصر صداقة الطفل مع الجبل فقط، بل أقام الصداقة نفسها مع النهر، لا ليتحدث معه، ويستمتع بمائه فحسب وهو يغوص بقدميه فيه حد الركبتين، وإنما ليتعرف على الكائنات الحية وغير الحية التي تعيش فيه، علاوة على رسم الحروف المنقطة التي كان يعاني في إيجاد الحلول لها لأنها تقطع الانسيابية أو الارتفاع الذي ترسمه قدماه. ولكنه كما استطاع أن يتجاوز توجسه في دخول بيت المجنونة، وكما استطاع أن يتحدى ضربات شقيقه، وينتصر عليه، كذلك فقد استطاع بتحديه لهذه المشكلة، أن يعلن عن انتصاره عليها، ليعيد الحروف المنقطة التي يرسمها في ماء النهر بقدميه الى انسيابيتها وإيقاعها المنتظم.
لتحقيق حلمه اللقاء بالجبل والنهر، يرسم هاتين المفردتين ويحاول الجمع بين الحرفين اللذين يأتيان في بداية كل مفردة منهما، وهما اللام والنون، ليشكل منهما كلمتي (لن) و (نل)، بقصد كما يقول السارد: (نفي كل ما من شأنه التأثير على الصفاء. . إنه يبغي المتعة لنفسه. . ويتمنى أن يأمر أو يطلب من الآخرين نيلها أيضا.).
2 -ينال:
ترى ما الذي يجعل السارد، أو أي شخص كان، أن يحس بفقدان شيء أو نقصانه، وهو في جولة بين أجمل جبال أسبانيا؟! وينعكس عليه هذا الهاجس من خلال الشخصية المحورية (ينال). أي شعور كليهما بالهاجس ذاته.
ولكن ما هو هذا الهاجس؟
لا يرد السارد على هذا السؤال، ويترك الإجابة للمتلقي. إنه هاجس الغربة. والحنين الى الوطن الذي اضطرته حكامه الجدد الموالين للدول المجاورة، أن يفقد أمل العودة اليه، وبالتالي ألا يموت على أرضه، مع أن الحيوانات عندما تشعر بدنو أجلها، تعود الى موطنها الأصلي. أو كما يقول ينال: (يا لها من صورة مفعمة بحزن يجرح القلب، أن يمضي الحيوان في رحلة العودة الى مواطن الطفولة ليموت. .).
في حنين العودة الى الوطن، وقراره بعدم العودة اليه، يكمن سر انتحار ينال، أثر بقائه وحيدا في الغربة. فأنىّ له أن يستمتع بجمال الطبيعة؟! وهو لا يقدر أن يبلغ مستوى ما بلغه الحيوان في الحنين الى مكان طفولته؟!
-كانت فكرة الكمال الغائبة تؤرقني. وفكرة النقصان الحاضرةتعذبني.
وبين هاتين الفكرتين، يطرح ينال مجموعة من الأفكار الفلسفية، ذلك أن الإنسان من خلالهما، يبدأ عذاب البحث عن المعنى المفقود. أو كما يقول: (حتى المتعة تعاني من النقصان). أو كما يطرح هذا السؤال: (هل النقصان دافع أو حاجز لجهد جديد)؟ ويرد عليه قائلا: (أشك في ذلك تماما، فالفكرة أعمق بكثير من محاولة سريعة للإحاطة بها، بل أستطيع القول بأن مزيدا من البحث والتفكير لا يقود إلآ لمزيد من الضباب والعتمة. .). وعبارة: (أتجهنا إلى الفيلا صعودا، ومن الواضح أن الثراء والذوق في البناء والأثاث وحسن التنظيم، وبرغم كل ذلك أشعر على نحو ما أن ثمة شيئا ينقص المكان، لا أعرف كنهه، أهو ما يتعلق بالزمن أم بالمكان)؟كالسؤال والإستفسارات السابقة لا يرد السارد على هذا السؤال أيضا.
مكان غريب
وقد تكمن الإجابة عليه في المفردتين الأخيرتين، في الزمن والمكان، أي برغم الثراء والذوق في البناء والأثاث، إلآ أنه لا ينجذب اليهما لأنهما في مكان غريب عليه وليس في موطنه لكي يستمتع بهما. وعلى ذلك فالوطن والشعور في الغربة، تتكرران بصورة غير مباشرة وعن طريق الإيحاء واللمز والغمز على امتداد الرواية.
أما اقتراح ينال على السارد في (إكمال الرواية التي كتبها)، تكمن سر المأساة التي يعاني منها أثر هروبه من العراق، ذلك أنه: (لم يخرج من العراق جسدا، بل أنه خرج جسدا وروحا وفكرا، ولا يحتمل فكرة أن يزوره يوما ما، ومن الطبيعي أنه لا يفكر في أن يدفن فيه.). هل من جرح أعمق من هذا الجرح؟ ألآ يفكر في أن يدفن في وطنه! وبالتأويل فإن هذا الجرح، هو جرح الشعب العراقي بأسره. أن يموت ويدفن خارج الوطن؟إن المكان المعادي في هذه الرواية، يكمن في خارج العراق، والمكان الأليف في داخله، أي في عدم قدرة الشخصية المحورية أن يتخذ من الخارج مستقرا له أو وطنا (الغربة)، لشعوره بأنه هناك يعاني من نقص ما، من مثلبة تنخر كيانه، لذلك فإن فرصة الحلم بالموت في وطنه كانت الهاجس الوحيد التي تشغل باله، وذلك عبر إعادة جثمانه الى حفنة التراب التي أنجبته.
مع أنه كان على يقين، بأن هذا الحلم لا ولن يتحقق، ليتحول حلم الدفن في أرض الوطن، الى أجمل للحظات الإنتماء الى المكان الأليف، وأسوأ كابوابيس الإنتماء الى المكان المعادي.
3- الحيوان وأنا :
تدور أحداث هذه الرواية، حول مجموعة من الحيوانات تعمل داخل مزرعة، صاحبها يتعامل معها بمنتهى الرقة، لا بل ينجذب اليها أكثر من إنجذابه الى الإنسان، ذلك للبراءة التي تتحلى بها، إضافة الى وفائها له، وعدم قدرتها على الكلام، وبالمفابل رعايته لها وخدمتها، على نقيض أحداث (مزرعة الحيوان) لجورج اوريل، حيث تعمل مجموعة من الحيوانات داخل مزرعة صاحبها رجل ظالم.
إن خطاب الرواية، ينبني ويتأسس بالإجابة على الأسئلة الثلاثة التي تتملثل في المفارقة، بالجمع بين مفردتي الحيوان والمزرعة، وهروب السارد من المدينة الى المزرعة، ومن ثم سفره الى خارج العراق. أي أنه ليس خطابا سياسيا فحسب، وإنما خطابا يقترن بالوعي الجمعي للفرد العراقي وثقافته أيضا، وإجابة السارد على السؤال الذي يطرحه بنفسه، قبل ختام الرواية بقليل، وهو يقول: (أين الخطأ؟)، ويرد : (لا خطأ هناك، إلآ إذا ما فتشت عنه، عندها يمكن أن تجد الأخطاء وستصطاد عيناك الخطأ في كل شيء.).
لذا فلم يعد له هدف، ولا أمل يسعى من أجل تحقيقه، وذلك بعد أن أصبح حرا، وجاهزا للموت، أي في الربع الأخير من حياته، وقد تجاوز السبعين، ودخل أعتاب الثمانين، ولم يعد نافعا لأي شيء، وبالتأويل لم يعد يخشاه النظام.
إن الأخطاء الكثيرة التي جاء بها غزو التحالف الدولي للعراق، لم يولد أخطاء كبيرة فقط، بل جعل
أبناء هذا الشعب المغلوب على أمره، أن يدع كل ما شيده، وكدّ بعرق جبينه لسنين طويلة، من أجل أن يعيش سعيدا في هذا الوطن؛ يغادره قاصدا موتا مؤقتا، أو كما يقول السارد: (أشعر أن الرحيل أو الغربة أو الهجرة يمكن أن تكون موتا مؤقتا وبوابة للإحساس بالفقدان.). وللتأكيد على ذلك، يستعين بهذه العبارة: (أنا عراقي في بغداد، صديقتي سويسرية، وأخي بريطاني، وعمي فرنسي، وأبنه أمريكي، وخالتي هولندية. .و. .و. .الخ).
غزو العراق، وملاحقة المدينة للسارد، صنوان، مثلما غزو العراق، عكر صفو روحه، ودفع مجموعة كبيرة من الشعب الى الموت المؤقت في المهجر، كذلك فإن ملاحقة المدينة، عكرت صفو روحه، من خلال لجوء (أبو رامي) الى مزرعته، لحماية ابنته (موج) فيها، لتسلمه رسالة تهديد تتضمن طلب مبلغ كبير جدا، وإذا رفض الدفع أو اخبار الشرطة، فإن ابنته تنتظر الاختطاف، وإن شئنا التأويل، صفو روح أغلبية الناس، لعدم استثنائهم من رسائل التهديد، والاغتيال، والاختطاف، والموت تحت التعذيب.
إذا كان غزو العراق، وملاحقة المدينة للسارد، صنوان، فإن مفردتي الهروب والاعتكاف، مختلفان، ذلك أن الاعتكاف يأتي برغبة، بينما الهروب اضطرارا، ودون رغبة.
وإذا عرفنا أنه استعان بها لكلا الأمرين، لفقدان بريق اهتمامات السارد القديمة، وعدم امكانية حدوث تطور كبير يتفق مع أبسط ما يتمناه، إذا ما عرفنا ذلك؛ فإن المفارقة الأخرى، تتجلى بينهما، في الاختلاف بين معنى المفردتين، وفي الوقت ذاته، التطابق بينهما، من حيث الغاية، وبمعنى آخر، أنه بقدر ما يهرب من المدينة، لقلقه وعدم اطمئنانه للوضع المستجد فيها، حيث يعمه الاختطاف، والحروب الطائفية، بعد سقوط النظام السابق، بالقدر ذاته، أن لجوئه الى المزرعة، ليعيش وحيدا مع حيواناته، هو ليس بقصد التأمل، سعيا لبلوغ مديات التأقلم بينه وبين مزرعته وحيواناته فقط، وإنما لإدانة كل ما يحصل في العراق من أحداث كارثية فيه بحق المواطن.
في رواية (طفولة جبل) مثلها مثل هذه الرواية لعب المكان، وعلى نحو خاص المزرعة؛ دورا كبيرا في منح أحداثها نكهة متميزة، وفضاؤها المفتوح على الحيوانات والأشجار، سحرا وجمالا، على العكس من المدينة تماما الضاجة بالفوضى، والأصوات النشاز، والمحكومة بالفضاء المغلق.
إن المكان من الأهمية في هذه الرواية، يكاد يبز شخصيتي السارد والحصان، فإذا كانت المدينة جحيما فيها، مقارنة بجحيم دانتي في ملحمته (الكوميديا الإلهية)، فإن المزرعة فردوسها، مقارنة بالملحمة نفسها، ذلك أن مدينة بغداد تقع تحت سماء تشهد سقوط العقد الاجتماعي التي ذهب اليها (أبو رامي)، والمزرعة ترمم ما تهدم من الصفاء التي لجأ اليها (دانيال)، الأول عبر الاخفاق الذي يعيشه الإنسان على أرضها، والثاني من خلال تعاطف الحيوانات مع الإنسان وإدراكهم للظروف التي يمر بها.
ولكن التحول الذي أحدثته (ذكرى) الأرملة، بقدومها الى المزرعة، بقدر ما فيه من أهمية، يمنح انطباعين مختلفين، سلبي وإيجابي، سلبيته تكمن في فشل مشروع السارد، وإيجابيته في سعادته المؤقتة، ليذكراني هذين الانطباعين، ببطلي رواية (الإغواء الأخير للمسيح) لكازانزاكي، ورواية (العزازيل) ليوسف زيدان، إذ بالرغم من اتفاقهما على عدم قدرة الإنسان على مواجهة الإغراء، يختلفان في نهاية روايتيهما؛ يختتمها الأول وبطله تحت غواية مؤقتة، والثاني برحيل (هيبا) حرا، وبالتأويل جاهزا للموت، شأنه شأن بطل روايتنا هذه، في عدم قدرته على مواجهة الغواية، وهو يقول: (هذا ما فعلته بي ذكرى في ليل المزرعة الذي لا يشبه أي ليل آخر)، رابطا ليلته الليلاء بالكلب الذي هو اسمه أيضا (ليل)، المعبر عن روح المكان الذي هو المزرعة، أو كما يقول في مكان آخر: (مشكلتي أنني في مرحلة بين مرحلتين، بين الوعي والرغبة، بين الهدف والوسيلة، بين أن أكون حرا وبين ضبط العبودية الذي تلف كياني.).
وإذا توخينا الدقة، فإن هذا التحول كان موجودا عنده، حتى قبل مجيء ذكرى الى البستان، وكذلك قبل ممارسة العملية الجنسية معها، بدليل أنه في المرة الأولى على الهانف، يطرح هذا السؤال على ابنه: (متى ستلتحق هذه الأرملة بالمزرعة؟)، وفي المرة الثانية، في منامه: (هل لحلمي هذا علاقة بوجود ذكرى في مزرعتي؟)، بالاشارة الى احتضانها، وشعوره بجسمها يسيل، وكأنه سائل بلوري.
إن تكرار عبارة: (لماذا تلاحقني المدينة) على امتداد الرواية، والتعبير عن المعنى ذاته في عبارات أخرى، كعبارة : (هذا ما فعلته بي المدينة)، أو (هربنا من المدينة) مثلا، يشي بأن السارد لم يتعرض الى إغواء ذكرى فحسب، بل الى الفساد المستشري في المدينة الذي جلبته معها الى المزرعة أيضا، ذلك لأن الكل، وهو جزء منه؛ يعيش في تصدع كامل، ولكي ينآى بنفسه عن الكل، ويتمرد عليهم، ويرفض هذا الواقع البائس، يسعى البحث عن التطهر بسلوك الحيوان. ولكن هل أفلح في مسعاه؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه الرواية، للإجابة عليه من قبل المتلقي، اتساقا مع أخطاء الحياة، والإخفاق المتعمدين فهمهما، وعدم إدراك الإنسان، حكمة وجوده في العالم.
وهذا الاخفاق، لا يتمثل في إغواء ذكرى للسارد فقط، وإنما أيضا في عدم فهم (موجة) لرغبة والدها في سفرها الى إحدى الدول الأوروبية، وإقامتها فيها، وعدم فهمها لزميلها في الكلية (سامي)، عندما أشار لها بالصعود في السيارة، لتسلم المصدر العلمي الذي كانت بحاجة اليه، وتجوزه عليه، إضافة الى محاولتها التخلص من الفتاة (أبو الشوال) التي كانت تحتضنها بقوة، وتقبل وجهها.
تعليقا على هذه الإخفاقات، يقول السارد: (أشياء كثيرة لا أفهمها، وحالات يصعب علي إدراكها، فهل يكمن الفشل في فهمي لها أم بالإنحدار والتداعي اللذين نشهدهما في حياتنا المعاصرة؟)
4-يرج المطر:
تتردد مفردتا (أنا أحب جسر الجمهورية) و(أنهم يؤلموننا بما نحب) على لسان السارد لأكثر من مرة، بوصفهما تعبيرا عن عمق وله الشعب العراقي بمعالمه القديمة، وحنينا للذكريات المؤلمة والمفرحة التي قضاها على هذ الجسر، وإطلاله على شارع أبي نؤاس الذي تمتد على جانبيه الحانات والنوادي والمقاهي والفنادق.
إنشاء على تكرار هاتين المفردتين؛ يستمد البناء الفني للرواية قوته من الزمن الغابر للشخصيات والحنين اليه وتشبثه به بقوة. ويشي بأن أمركا وحلفائها تعرف جيدا الأماكن التي يستهويها الشعب العراقي، لذا فهي تستهدفها في الصميم وبلا وازع ضمير، لا لكي تنتقم منه فحسب، بل لتمحي الذكريات والأحلام الجميلة التي عاشها مع هذه الأماكن. أيضا.
ليس الطبقة الطفيلية الجديدة التي جاءت بالحرب، استفادت منها فقط، متمثلة بالأشخاص الستة العفنين الذين يقضون أوقاتهم في شرب الكحول واللهو في أحد بيوت بغداد، وإنما حتى قاريء الآذان هادي الأعمى استفاد من تبعاتها، وذلك من خلال قيام الطبقة الطفيلية بتحويل البيوت الى مكان للهو والعربدة، بدلا من جعلها مكانا للراحة والاستقرار، وقاريء الآذان بتحويل الجامع الى مكان للفساد، بدلا من بث روح المحبة والتسامح بين مصليه، عبر إخافة الأثرياء بصوته في خطبه الذي يكشف فيها عن الأرباح التي تأتيهم بطرق غير مشروعة، ليتلقى المساعدة منهم، بهدف إسكات فاه، وعدم البوح بالطرق الملتوية التي غدوا فيها أثرياء، ولكن المفارقة أنه يدعو السارد بألا يقول لأحد ما سمعه منه.
أي أن الحرب بفعل الأموال التي تنفقها على الأسلحة والمعدات الحربية، والحصار الذي تفرضه على الشعب؛ تدفع شريحة الفقراء أيضا الى إيجاد الطرق الملتوية ذاتها التي سلكها الأثرياء واتبعوها، وذلك لسد النقص الذي خلفته الحرب، عبر تحايل بعضهم على بعض، وبالمآل جرى تدمير البلد اقتصادية واجتماعية وثقافيا.
وبمعنى آخر أن حرب الخليج الثانية على نحو خاص، وكل الحروب عامة، لا تجلب إلا الدمار والهلاك، كما لبلدها كذلك للبلد الذي تدخل معه في الحرب، أي (للمكان)، لا لأنه يمحو ويزول من وجه الأرض، بل لأنه يبقى في الذاكرة، ولكن دون أن يكون بوسع صاحب الذاكرة أن يراه أوحتى يلمسه كما كان في السابق، يستمتع برؤيته عن قرب أو بعيدا منه.
لعل ظهور الشخصية المحورية في أماكن عديدة، وقد بلغ مظهر الرجال؛ أثبت دليل على عودته الى طفولته، من خلال سيره على سطح البيوت المتصلة بعضها للبعض. كما أن ظهوره ثلاث مرات على امتداد الرواية، في الوحدة الرقمية الأولى، يضاعف من هذا الإثبات .
إلا أن السؤال الأهم، الذي يطرح نفسه، هو لماذا غادر الفتاة الصحفية واتجه الى مدينته؟
ترى هل لأنه ارتاب في كونها مرسلة من قبل دولة معادية للعراق؟ لجمع معلومات عن الظروف التي يمر بها بلده؟
إن لجوءه الى مكان الطفولة، هذا ما يوحي إليه المكان الذي تشرب منه روح النقاء والبراءة بعيدا عن الدجل والنفاق وكتابة التقارير، أمسى يرى مسالك السطوح كما براها الناس، وليس كما كانت رؤيته تختلف عنهم، عندما كان صغيرا، لذا ضاعت عليه مسالك تلك السطوح، فما كان عليه سوى أن يبحث عن طريقة لا تخطيء للوصول البها. أو كما يقول الصغير الذي كبر: (الى نقطة معلومة تقوده الى ما يألف. . تكمن في تتبع سواقي المياه باتجاه انحدارها، فيسيل معها للوصول الى نقطة معلومة لم تخطيء طريقته قط، وكان فرحا باكتشافه.).
ما يعني أن مكان الطفولة، يظل حاضرا في الذاكرة والوجدان ويتوق الإنسان اليه عندما يكبر، لما يحمله من دفء وبراءة وطمأنينة؛ لأن العفوية التي كان الطفل يعيش بها، ذلك المكان لم تعد موجودة، وبمعنى أدق أن الطفل يتماهى مع المكان بعفوية كاملة، دون وعي أو أحكام أو خيبات، بخلاف في الكبر، إذ بالرغم من أن المكان لا يفقد عفويته، بيد أنه يمنحها شكلا آخر، أكثر هدوءا وأشد التصاقا بالذاكرة .
المصادر:
1-جمالي المكان. غاستون باشلار. ترجمة غالب هلسا. 2006.
2-المصدر السابق نفسه.


 هجستُ نفسي في الظلامِ بعيدًا
هجستُ نفسي في الظلامِ بعيدًا
 الأنثروبولوجيا والحرب السلطة الثقافية للقوة وقدراتها التصنيفية
الأنثروبولوجيا والحرب السلطة الثقافية للقوة وقدراتها التصنيفية
 الحروب البحرية غير المتماثلة... إيران في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية
الحروب البحرية غير المتماثلة... إيران في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية
 المالية تبدّد مخاوف الموظّفين والمتقاعدين وتؤكّد تأمين الرواتب
المالية تبدّد مخاوف الموظّفين والمتقاعدين وتؤكّد تأمين الرواتب
 صحفيو العراق ينتخبون ممثليهم بإشراف قضائي
صحفيو العراق ينتخبون ممثليهم بإشراف قضائي
 إستهداف مسجد في إسلام آباد والضحايا 12
إستهداف مسجد في إسلام آباد والضحايا 12
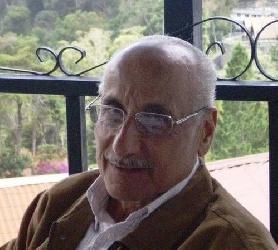 الأزمة العراقية الحاضرة في مواقع التواصل
الأزمة العراقية الحاضرة في مواقع التواصل
 أكثر من 3 آلاف دائرة حكومية تعتمد الكهرباء البديلة في ديالى
أكثر من 3 آلاف دائرة حكومية تعتمد الكهرباء البديلة في ديالى
