

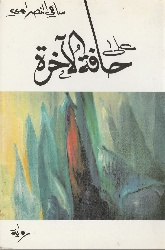
على حافة الآخرة لسامي النصراوي.. نصيحة من دفان لا تصاحب الميتين
فيصل عبد الحسن
تبدأ رواية “على حافة الآخرة” للروائي سامي النصراوي** بأمين، الذي احتفظ بجثة أمه في مكان دفن في قرية نائية من جنوب العراق، كوديعة، وذلك ما كان يفعله أجدادنا في جنوب العراق في بدايات القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر بسبب صعوبات نقل موتاهم ليدفنوا في مقبرة النجف، قريبا من ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، تبركا به ومحبة للدفن في أرض مباركة، لها في الوجدان الشعبي الكثير من المرويات والحكايات، التي تجعل من يسمعها يأمل بخير الآخرة من رب كريم.
من عادات أهلنا وقتها المتوارثة أن تقبر الجثة لسنوات في مكان قريب، حتى تتحول إلى عظام، وحين يأتي الظرف المناسب للسفر، وأيضاً حين يجمع أهل المتوفى المال الكافي لرحلة مكلفة مادياً، ويتحلل الذي يزمع القيام بها من أية التزامات أخرى، فهو يفرغ نفسه لما نذر نفسه له، فهو ذاهب إلى مكان بعيد، وستمتد رحلته إلى أسابيع، يضطر خلالها للسفر في عربات تجرها الخيول، ويمر على محطات محددة بين كل مرحلة ومرحلة، ما يضطره طول السفر إلى الإقامة في خانات على الطريق، ومعه الصندوق الذي جمع فيه عظام ميته، حتى يجد القافلة المناسبة التي سيصاحبها في رحلته.
ويمرّ في رحلته الضاجة بالمخاوف من قطاع الطرق، والأمراض بقرى ومدن عراقية في غاية البؤس والفقر تغرق في الظلام، وأسراب البعوض ليلا، والذباب نهارا ولا يرى فيها غير أصحاب الملابس المرتقة، والفلاحين الحفاة الجائعين الفارين من ظلم سراكيلهم، وشيوخهم، وأسراب الجراد، وجيوش النمل، التي تجتمع في أي مكان يضع فيه صندوق عظام ميتة لساعة أو ساعتين أو أقل من ذلك!!
النجف قبل قرنين
الكاتب أبدع في سرد علينا ما كان يدور في مدينة النجف المقدسة من أحداث في القرن الثامن عشر، وخلال فترة الاحتلال العسكري البريطاني المباشر للعراق بعد الحرب العالمية الأولى فقد وضعنا بذلك بموازاة حدث رئيس، هو محاولة بطله “أمين” دفن عظام أمه في” باحة الضريح حيث موطن الشفاعة “وحسبما جاء في وصية الأم المتوفاة، والتي لا يستطيع أن يخالفها، بينما الظروف لا تسمح له بهذا، فهو ليس غنيا، وليس من الوجهاء المعروفين، ولا يمتلك أي سلطة تؤهله لشرف دفن عظام أمه في سرداب الضريح.
أما أرض مقبرة النجف الواسعة، فهي متاحة لأمثاله من أبناء الشعب العاديين، ولا يمنعه أحد من الدفن فيها، تلك كانت نصيحة “نعمة الدفان” له، الذي كان قريبا من الناس ومحبوبا في المجتمع النجفي المحدود في تلك الأيام، التي يصفها الروائي قائلا في متنه: “مدينة ينتهي عند حدودها العالم، تبدو وحيدة تنأى بنفسها عن أية دلالات حضارية، رقعة من الأرض معزولة لا علاقة لها بما يجاورها من مراكز سكانية، فهي بكيفية ما لا تقع على ملتقى الطرق أو مفترقها، كما أنها لا تنطرح على مجرى ماء أو نهر أو مصبه، وإن كان ثمة نهر صغير كخيط من الفضة يسقي بساتينها، ولا يوجد أثر لها على الخريطة يشير إلى ما يوصلها بالعالم المحيط بها، تبدو لمن يتمعن في موقعها أن ولادتها تمت بعملية قيصرية على يد أناس هبطوا عليها من السماء، شيدوها ثم سلموها دون مقابل لأول قادم إليهم من البشر ورحلوا عنها لينجوا بأنفسهم من عزلتها !!».
في هذه المدينة المعزولة يعيد الكاتب تشييد مجتمعها المقام على مثلوجيات وفولكلور قديم رسخت معالمه في كل ثنيات المدينة، فنعيش فصول حياة “السادن حسن”، وولده محمد ومدير شرطة المدينة العقيد زكي، وحسده الدائم لسادن الضريح كونه يعيش رفاهية لا تتوفر له، فهو يفرش السجاد الإيراني من نوع”نايين”المصنوع من الحرير الخالص ويعتبر الكاشان بالنسبة إليه دون المستوى الذي يعيشه، وينادم ليلا الجميلة “خانم شريفة” ويؤمن بمبدأ” لا تصادق شرطيا ولا تعادي شرطيا «.
شاه حسين
نقرأ في فصول الرواية عن سيارات الجيش الإنجليزي، وهي تمرُّ متباطئة أمام البيوت النجفية، محملة بجنود السيخ بعمائمهم الخاكية، ووجوه الضباط الإنجليز الحمر، وعلوان اليساري الذي سجن في سجن الفاو بسبب نشاطه السياسي في المدينة، وجابر الانتهازي ابن المختار، الذي” لا يرى مندوحة من ممالئة المستعمر القوي حتى يرحل” وحلمه من الزواج من “خديجة” التي يحبها “ نعمة الدفان “ وهي أبنة خالة “ مجيد “ المتعاون مع المحتل الإنجليزي، والذي يتعيش من شراء وبيع الحبوب للجيش البريطاني، ونقرأ عن” السراكيل والشيوخ وهم يديرون اقتصاد المدينة” وفي هذا الفضاء يحاول أمين تحقيق حلمه بدفن عظام أمه حيث يعده نعمة الدفان بتحقيق ذلك الحلم من خلال معارفه واصدقائه” ومن دون علم حرس الروضة وسادنها ويوصيه أن لا يصاحب الميتين بعد هذه المرة، ولا يحقق رغبات من مات، لأنهم سيتعبونه بلا طائل».
الروضة المطهرة
تفشل محاولتهم الأولى في دفن عظام المتوفية داخل باحة الضريح، ويتعرف القارئ من خلال ذلك على أبواب الصحن الأربعة وعلى اللواوين حول الضريح، و”جغرافيا الروضة المطهرة”والتشابيه التي تجري في المدينة خلال أيام محرم العشرة، فيرى أمين المطبرين بقاماتهم وهم يصيحون” شاه حسين .. شاه حسين”. فيسأل نعمة عما تعنيه تلك العبارة فيقول له أنها تعني “الملك حسين”، يقصدون الأمام الحسين عليه السلام، وتنتهي الرواية بمصرع “نعمة” دعسا بقوائم الجواد الذي كان من المفروض أن يؤدي فوقه دور القاسم عليه السلام في التشابيه، التي يزاحمه عليها جابر ابن المختار، الذي ينافسه أيضا في الحياة اليومية على الزواج من حبيبته، وأبنة خالة خديجة، فبعث عددا من الأجراء وأصحاب السوابق من يدس له في أذن جواده لفافة تبغ مشتعلة مما أصاب الجواد بالهيجان، فأسقط فارسه” نعمة” من فوق ظهره، وأصابته العديد من ركلات الجواد الهائج، وهو على الأرض مما أدى به إلى الموت. نهاية نعمة، تشير إلى التشابه بين الدور الذي كان يريد تمثيله في المأساة الحسينية، والحياة الفعلية، من خلال حدث تاريخي “أن القاسم عليه السلام كان عريسا مقتولا أيضا”، والشخصية الروائية كانت كذلك، فهي مقتولة غيلة للحيلولة من تحقيق حلم اقترانه بخديجة.
رواية النصراوي تضع قارئها على حافة الآخرة حقا، فهي تعيد تشكيل مدينة النجف المقدسة، ومجتمعها الصغير في منتصف القرن الثامن عشر، وبدايات القرن التاسع عشر من خلال محاولة لتحقيق أمنية مواطنةعراقية بدفن عظامها في سرداب الروضة المطهرة. ولكن لم يتمكن ولدها من تحقيق تلك الأمنية، فلا مكان فيما يبدو لعظام أم أمين في الروضة المطهرة، وبدلا من ذلك قادنا الكاتب لنطلع على ما عاشه الأجداد في مدينة النجف المقدسة في القرن التاسع عشر من صعوبات، من حوادث وأحوال معيشية متردية في ظل سلطات عسكرية أجنبية، ومتعاونين مع تلك السلطات، ومجتمع بدائي لا يزال يعيش في الماضي ويخاف من كل جديد يظهر في الأفق.
التقنيات الفنية التي استخدمها الروائي تشير إلى أن الكاتب كتب قبل هذه الرواية العديد من التجارب الروائية، لكنه لم ينشر وقتها أيا منها إلا بعد نشر روايته الأخيرة، فهي رواية اجتمعت فيها جميع تجارب الكاتب لكتابة رواية، فقد استخدم السرد الروائي بمهارة، والمنلووجات الشخصية، المؤدية للكشف عن الكثير من الأحداث التي لا يمكن للكاتب سردها، وكذلك اختزل الكثير من السرد باستخدام الدايلوجات (الحوارات) المباشرة بين الشخصيات، وهو بذلك استخدم جميع التقنيات الروائية التي مارسها روائيو القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ليقرب لقرائه ما حدث لأبطاله في تلك الحقبة البعيدة زمنيا.
لقد ترك لنا د.سامي النصراوي رواية عراقية مبدعة في غاية العذوبة، والروعة والعمق والشاعرية بالرغم من موضوعها الذي يعني بالموت وما بعد الموت، وهو موضوع يمثل سمة رئيسية في اهتمامات العراقيين منذ ملحمة جلجامش إلى يومنا الحالي.
** النصراوي روائي عراقي عاش في المغرب منذ السبعينيات ونشر العديد من الروايات، وتوفي ودفن فيها. أنشأ النصراوي في مدينة الرباط دار نشر بابل، وهي الدار التي نشرت هذه الرواية، لوحة الغلاف للفنان العراقي المرحوم حسني ابو المعالي.


 التصويت الخاص .. اختبار مبكر لنبض الانتخابات العراقية 2025
التصويت الخاص .. اختبار مبكر لنبض الانتخابات العراقية 2025
 بعد الانتخابات المقبلة.. كيف تتعامل الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة إزاء الضغوط الأميركية
بعد الانتخابات المقبلة.. كيف تتعامل الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة إزاء الضغوط الأميركية
 الانتخابات، صناديق الخوف والطائفية
الانتخابات، صناديق الخوف والطائفية
 الناخب بين العقل والعاطفة: مقاربة أنثروبولوجية في الوعي السياسي والثقافة الانتخابية
الناخب بين العقل والعاطفة: مقاربة أنثروبولوجية في الوعي السياسي والثقافة الانتخابية
 من باب الدرب إلى القصيدة.. سيرة وطنٍ في القلب
من باب الدرب إلى القصيدة.. سيرة وطنٍ في القلب
 العراقيون يدلون بأصواتهم على أمل ولادة برلمان يلبي طموحاتهم
العراقيون يدلون بأصواتهم على أمل ولادة برلمان يلبي طموحاتهم
 البارزاني والحسان يبحثان الإنتخابات وعلاقات أربيل وبغداد
البارزاني والحسان يبحثان الإنتخابات وعلاقات أربيل وبغداد
 المالية تنفي قطع رواتب الاعانة
المالية تنفي قطع رواتب الاعانة
