

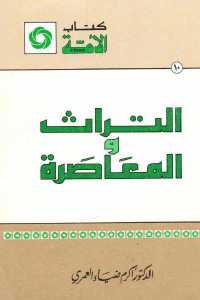
أكرم ضياء العمري بكتابه التراث والمعاصرة.. هوية ثقافية للامة لولا مشكلة التصحيف والتحريف
راجي العوادي
المقدمة
يعد مفهوم التراث واحدا من أهم المفاهيم التي اعتنى وانشغل بها الباحثون فقد طرحوا مفاهيمه ومصطلحاته ورصدوا قضاياه الفكرية والمنهجية وإبراز اشكالياته.
لقدد تعددت تعاريف التراث نسبة الى رؤية الباحثين فيعرفه الجابري بأنه : الموروث الثقافي والفكري والأدبي والفنوعرفه أحمد العلوي بأنه: القرآن وكلام محمد صلى الله عليه وسلم لا غير., ويعرفه آخرون أيضا بأنه : بمثابة امتداد الماضي فينا وعلى هذا الاساس , فالتراث هو آلية دفاعية ذات جذور ماضية ترسم لنا صورة جميلة ويعرفه غيرهم: إذ التراث هو الذاكرة الممتدة حتى الحاضر، والمنتج الثقافي الذي تنجزه اليوم سيكون للأجيال القادمة تراثا وذاكرة . إن التراث هو المخزون الثقافي الذي خلفه السلف للأجيال القادمة، معناه أن التراث هو بقايا ثقافة الماضي ونحن ما زلنا نحفر في ثنايا هذه البقايا سواء ماديا أو معنويا، وبعبارة أخرى هو كل ما ورثته الأمة وتركته من إنتاجات حضارية أو فكرية , ومن خلال ما سبق من تعريفات أو غيرها مما ضاق المقام عن ذكره، يمكن القول أن التراث: عبارة عن إرث خلفه السلف وهذا الإرث وصلنا عبر العصور والأزمنة المتعاقبة والتي لا يزال البحث والنبش جاريا في بعض مخلفاتها التراثية، والتي أنتجتها عقول الأجيال السابقة من علوم وفنون وآداب،كما نجد التراث في حياتنا اليومية مثل العادات والتقاليد والمأثورات الشعبية التي لا تزال المجتمعات تمارسها إلى اليوم .كما أن التراث يمثل روح الأمم وتاريخها. أما عن مصادر التراث فيرى علماءه أن له مصدرين أساسيين هما المادي والفكري.وإذا انتقلنا إلى أنواع التراث فقد قسم العلماء التراث الى قسمين
التراث الديني : والمقصود به القواعد التي ينبني عليها دين الأمة ومثاله لدينا في التراث الإسلامي: القرآن الكريم والسنة المشرفة، ويمكن المحافظة على هذا الموروث بتنفيذ أوامرهما والعمل بمضمونهم
التراث الثقافي : ويشمل : العلوم والفنون والعادات والتقاليد والمراسيم التي تسمى بالتراث الشعبي والأمثال التي ينفرد بها كل مجتمع عن غيره و تتناقلها أجياله جيلا بعد جيل ويعتبر العمود الفقري للأمم والشعوب لأنه يختلف باختلافها. بقي لنا ان نتحدث عن الحداثة وعلاقتها بالتراث , فتعريفها العلمي يعنى الأخذ بكل معطيات العصر الحديث من علوم طبيعية ومعارف إنسانية والانفتاح على كل ثقافات العالم اي يقصد بها ما استحدثه الناس من أشياء مادية، وأخرى فكرية روحية؛ وهي بذلك المقابل الموضوعي للتراث, فإذا كان هذا الأخير يرتبط بما أنتجه الإنسان في الماضي سواء كان ماديا أو معنويا، فإن الحداثة متعلقة بما أبدعه الإنسان في الحاضر. ويمكن النظر إليها باعتبارها فعلا تاريخيا يجد جذوره في القرون الماضية وتداعياته المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقيميا, وعلاقة التراث بالحداثة علاقة جدلية .
اخيرا نحن في حاجة كبيرة إلى وعي كاف بالتراث وبأسباب الحداثة يؤهلنا إلى عدم نكران ماضينا، والسير نحو الفعل في حاضرنا ومستقبلنا.
الفصل الاول
احياء التراث المعاصرة
حدد المؤلف مفهوم التراث لغة واصطلاحا وفق النظرة الدينية المستندة الى الكتاب والسنة ربما للخلفية التي يرجع لها المؤلف وبين ان القران الكريم حذر من الانتقاء من التراث او توظيفه لمصالح خاصة لكن المؤلف لم يتطرق الى ان القرآن الكريم قد نهانا عن أن نقف من التراث موقف الانصياع الأعمى والتقديس {ما سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ} (*) {بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مهتدون} (**) كذلك المؤلف لم يبن لنا مفهوم الحداثة والتي تعني بشكل بسيط تفاعل الإنسان المعاصر مع النتاج المادي والفكري ايضا المؤلف فاته ان يذكر العلاقة الجدلية بين التراث والحداثة والتي هي سبب ت فكرة “القطع “او الانتقاء (1)
وعليه فالتراث” بصفة عامة يمكن تعريفه من “زاويتين: تراث السلوك والعادات والقيم غير المكتوبة؛ وتراث الإبداعات الفكرية والفنية والأدبية، المكتوبة أو المسجلة والمرئية المحفوظة (2)
أما “التراث الإسلامي” فيقصد به: “الجانب الفكري في الحضارة العربية الإسلامية: العقيدة، والشريعة، واللغة، والأدب، والفن، والكلام، والفلسفة، والتصوف (3)
مصطلح التراث في الحضارة الغربية المؤلف حذر من اعتبار الدين تراث كما يراه الغرب بسبب اللبس وعدم التميز بين الدين والارث الحضاري اي بين كلام الخالق وكلام المخلوق وبالتالي كلام الخالق عندهم يتعرض للنقد كما هو حال كلام ونتاج المخلوق , ورغم ان حديث المؤلف عن هذا الموضوع لا يتعدى 10 اسطر الى انه كفى ووفى في ايصال الفكرة بشكل جلي .
الاحتراز يقتصر على الكتاب والسنه دون غيرهما بين المؤلف ان الاحتراز في الكتاب والسنة لوحدهما وليس بالفقه التي يجوز الانتخاب والنقد فيه واوضح ان ماضينا يعاني من الوهن والضعف بسبب الاضمحلال الحضاري وضعف التواصل الثقافي بسبب نفوذ الحضارة الغربية لكن المؤلف لم يتطرق الى هناك من يريد أن يعامل نصوص الوحي: قرآنًا وسنة، بمثل ما يعامل به النصوص التراثية الأخرى.. متأثرًا بالتجربة الغربية في قراءتِها نصوصَها الدينية وتراثَها عمومًا.. غيرَ آخذٍ في الحسبان الفوارقَ المفصلية الأساسية بين مفاهيم الوحي والدين ومالاتهما في التجربتين: الإسلامية والغربية كتابات نصر حامد أبو زيد، ومحمد أركون، وأدونيس , لكن هذا الراي نرى فيه بطلان وتعسف لانه يحاول تطبيق قواعد تأويل الكتاب المقدس في التجربة الأوروبية- خصوصًا في فترة الحداثة وما بعد الحداثة- على التراث العربي الإسلامي، ومنه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
ما جدوى حركة احياء التراث
الهدف الاساس الذي بينه المؤلف هو الاعتزاز بتراث الاباء على الحضارة العالمية وهذا الاعتزاز قد يخلق عندنا روحية لتجاوز انجازات الغرب اليوم لكن هناك اهداف اخرى لم يتطرق لها المؤلف ومنها :
هي أحدى أهم الوسائل للحفاظ على هويتنا.في الحفاظ على تراثنا الثقافي يمكننا التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم لمشاركة تراثهم الثقافي والتاريخي مما يعود بالمنفعة الثقافية والاقتصادية على بلدنا من خلال المؤسسات الكبيرة التي تعنى بالتراث العالمي.كما انه يضمن كتابه كيفية الحفاظ على التراث من خلال الآباء والأمهات الأسرة في سنوات التنشئة والتربية الأولى وأيضاً المدارس حيث أن الإنسان شديد التمسك بتراثه وبمعرفته والاندماج فيه يكون من الصعب اجتذابه إلى ثقافات رديئة وسيئة أو دخيلة أو الثقافات الرديئة أما الإنسان غير الملم بثقافته وتراثه فمن السهل اجتذابه والإيقاع به في تلك الثقافات الرديئة الغريبة مما يسهل فيما بعد القضاء على هويته الحضارية والتراثية وبعده عن ثقافته الأصلية وأيضاً يأتي دور الدولة في الحفاظ على التراث وتنميته والتأكيد عليه لأنه جزء لا يتجزأ من امنها القومى ومن منظومة الحفاظ على وجودها والتأكيد على أصالتها وعلى منع أفرادها من الانزلاق في ثقافات بعيدة عنها أو سيئة من الممكن أن تؤدى في النهاية إلى تلاشيها وفقدها تراثها الاجتماعي والثقافي أو تقويض المجتمع فيها أو العبث بأركانه الأساسية من مفاهيم وعادات اجتماعية وحياتية .
حركة احياء التراث
الاختلاف الواضح بين حركة الاحياء في الغرب بعصر النهضة الاوربية وبين حركة الاحياء الاسلامية الحديثة بينه المؤلف كما يلي :فالعلماء بالغرب وثقوا علاقتهم النفسية والفكرية بتراث اليونان والرومان ولم يلتفتوا الى تاريخ النصرانية ودور الكنيسة وقد بدى هذا التوجه واضحا بالقرن التاسع عشر في ادبهم الكلاسيكي فقد كان يغلب عليه التحلل من الدين والتقاليد حتى ان المدرسة الجمالية اعلنت عدم الالتزام بقيم المجتمع الدينية لكن المؤلف لن يعرض دور العرب في هذا الاحياء .
فقد ادى تأثر اوربا بالحضارة العربية واختراع الطباعة وازهار التجارة الى تغير اسس الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها فاطلق مصطلح عصر النهضة على فترة التنقل من العصور الوسطى الى العصور الحديث فاذا كانت الحضارة العربية الإسلامية قد استفادت من الحضارات التي سبقتها ، فأنها اعطت بسخاء الحضارة الاوربية فكانت حجر الزاوية في التقدم الاوربي حيث وصلت العربية الاسلامية تزحف الى اوربا اواخر القرن الحادي عشر والثاني عشر ولم يحل القرن الثالث عشر الا وبصمات الحضارة العربية الاسلامية مميزة في نهضة الغرب بكل المجالات
القرن العشرين وسيطرة العبثية1-5
استطاعت حركة الاحياء الاوربية بعزل الاجيال الصاعدة عن النصرانية مما ساعد على سيطرة العبثية وفقدان اليقين الديني فقد كانت تنقد القيم الدينية من خلال المسرح , ورغم ان المؤلف بين السبب (العبثية) لكنه لم يوضح مفهومه والذي يعني ان الانسان يجتر أفكاره لأنه فقد القدرة على رؤية الأشياء بحجمها الطبيعي نتيجة للرغبة في سيطرة الآلة على الحياة لتكون في خدمة الإنسان، حيث انقلب الأمر فأصبح الإنسان في خدمة الآلة, وظهرت أول جذورها على يد الفيلسوف الدنماركي سورن كيركگارد في القرن التاسع عشر
اهمية التراث
على حد تعبير المؤلف ان ’ التراث هو الهوية الثقافية للامة والتي تتفكك وتضمحل من دونه ’ المسلمون يتعرضون لهذا التفكك فيندفعون الى الاندماج العالمية المختلفة , وقد يلمس هذا في طبيعة التراث والافادة منه علاوة على ذلك في عملية التفاعل معه , فمعظم التراث الاسلامي التي يمتد تاريخها الى القرن الاول والتي استخدمت للتدوين وانتهت الى التصنيف في القرن الثالث وازدهرت في القرن الرابع.
كما ان الاعراف والتقاليد والقيم الخلقية اكتسبها اللاحقون من الاولين , اما الاثار فقد بارزة تعكس مدى التطور والتقدم , ان نقل الافكار عبر الزمن يواجه مشاكل شتى فهو عرضة للتحريف المتعمد لذا اقتضت الحاجة الى اناس نزيهين ومحصنين بالعقيدة الاسلامية ..هذه افكار المؤلف باقتضاب في هذا العنوان وكانت وكانت وافيه الا انه لم يعرج على طرق الحفاظ على التراث واعني مسؤولية الدولة اولا والمواطن ثانيا وكذلك الكيفية في تطوير التراث من خلال تضمينه وعرضه في المناهج الدراسية لمختلف المستويات والاهتمام بالأثار التاريخية وتشجيع السياحة لها لكي تفهم الناس تراثها التاريخي كما يجب ان تعرض الاثار عبر وسائل الاعلام عالميا لكي يفهما ويطلع عليها الشعوب الاخرى فمثلا الزقورة وبيت ابراهيم الخليل في مدينة الناصرية بالعراق .
ضرورة ترشيد حركة التحقيق العلمي للمخطوطات 1-7
اظهر المؤلف مشكلة التصحيف والتحريف والاخطاء الطباعية وحذف اسم المحقق في كتب التراث نتيجة طمع تجار المطابع , بنفس الوقت المؤلف اقترح الحل من خلال الترشيد العلمي وتبني النشر ثم التكفل بالتوزيع بحيث لا يتدخل المحقق في اعمال الطباعة والتسويق ويقتصر عمله في التحقيق العلمي للكتاب كما شدد على ان يتم التعامل مع دور النشر وفق شروط وضوابط والعمل وفق اللوائح القانونية لحفظ حقوق المؤلف والمحقق كما اكد المؤلف بضرورة التعريف بالمخطوطات من خلال العلماء المختصين لتكون رؤية واضحة للتراث المخطوط واجراء مفاضلة بالمخطوطات التي تحتاج تحقيق وتسويق وفق الاهمية .
رغم ان المؤلف اغنى العنوان لكننا نرى ضرورة ان نبين مفهوم التحقيق والمخطوط وشروطهما .
المخطوط : اسم مفعول من الخط ويطلق في اصطلاح الباحثين على كل كتاب أو وثيقة كتبت بخط اليد , اما
التحقيق: مصدر الفعل حقق وأصله الحق و في مختار الصحاح “ تَحَقَقَّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ صَحَّ، وحَقَّقَ قَوْلَهُ، وَظَنَّهُ تَحْقِيقًا: أَيْ صَدَّقَهُ. وَكَلَامٌ مُحَقَّقٌ: أَيْ رَصِينٌ (4)
رأيت الإشارة في هذا العدد إلى أهم الشروط الواجب توافرها في المشتغل بالتحقيق، وهي خمسة شروط تحقيق المخطوطات
(* )
الشرط الأول : الخبرة في قراءة الخط العربي القديم
الشرط الثاني : الإحاطة بموضوع الكتاب المراد تحقيقه ، ومعرفة مسائله
الشرط الثالث : الأمانة العلمية، فإن المشتغل بالتحقيق إذا فقد الأمانة لم يكن مؤتمنا على أصول الكتاب
الشرط الرابع: التواضع وعدم اغترار الباحث بقدراته، وما حازه من علوم ومعارف
الشرط الخامس : الصبر والأناة
ا,.د. عياض بن نامي لسلمي , تحقيق المخطوطات- المفهوم والأهداف والخبرات اللازمة-مقالة في الانترنيت*
خطوات مقترحة
رغم ان المؤلف اشار الى حصر المخطوطات في سائر مكتبات العالم وتصويرها والقيام بتصنيفها ودعوة العلماء المختصين لدراستها وتشكيل لجان من كبار المحققين المختصين لانتقاء المخطوطة المرشحة للتحقيق الا اننا احببنا ان نضيف تحت هذا العنوان (5)
- اختيار المخطوط من حيث العلم الذي يحتوي بين لوحاته ا 1
جمع النسخ أصلية كانت أم فرعية.2-
الرمز للمخطوط وترقيمه .3-
تحقيق النص، وهي أهم مرحلة يتضح فيها جهد المحقق وفيها عد عمليات.4-
5-فهرست المخطوط
الفصل الثاني : التراث والمشكلات المعاصرة
المشكلة الاجتماعية 2-1
بين المؤلف ملامح المشكلة الاجتماعية في الغرب خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين تحت مبرر وعنوان الحرية الشخصية للفرد ومنها اختراق الحرية الجنسية للأعراف والقيم
عدم تحريم العلاقات الجنسية بين الاشقاء في سن البلوغ
معاقبة الزوج بعقوبة هتك العرض اذا رفضت زوجته المعاشر لهذا شاع بينهم ظاهرة الولادات الغير شرعية
ونحن نضيف هنا بان هذه المجتمعات الغربية باتت تعاني من فقدان عاطفة الابوة والفقر والجريمة والمخدرات والتفرقة العنصرية , اما ملامح المشكلة في المجتمعات العربية فهي شيوع ظاهرة الطلاق وتفشي الجريمة وتقليد الغرب بالمظهر
بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسـية والثقـافية
دور التراث في مواجهة المشكلة الاجتماعية 2-1-1
ابرز حلول المؤلف للمشكلة الاجتماعية تمثل في ضرورة العمل بالكتاب والسنة لمعرفة الحلال من الحرام , كما يجب احياء القيم الاخلاقية التي تربينا عليها كعرب ومسلمين.
اما المعالجة فقد تاتي من خلال دور الإعلام بنشر ثقافة حب الوطن والتزام المواطن بسلامة مجتمعه وتجنب السلوكيات والممارسات المشـينة (6)
المشكلة السياسية 2-2
المؤلف كفى ووفى تحت هذا العنوان فابرز ما بينه بان ضعف العقيدة كانت سببا للتمزق السياسي , ولكن هنا نضيف
مسألة المشكلات السياسية والتوترات العرقية والمذهبية في بعض دولنا العربية، سببها الرئيسي هو الفشل في كيفية التعامل مع التنوع الثقافي والديني والمذهبي والعرقي (7)
المشكلة التشريعية2-3
نحن بحاجة الى استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنه والاجماع والقياس وكذلك التراث الفقهي لكن الفهم القاصر والتشويش الظاهر يؤثر على ذلك , كما ان الاجتهاد في الدين دون علم يؤدي الى نتائج سلبية , هذا بعض وليس كل ما اوضحه المؤلف في المشكلة التشريعية .
ان اشتغال كل قاضٍ شرعي بالاجتهاد والاستنباط لما يُعرض عليه من مسائل، من شأنه أن يجعل عجلة الاجتهاد الفقهي والتجديد التشريعي الإسلامي مستمرة، تواكب العصر ومستجداته أولًا بأول ولا تتوقف، إذ يواجه القضاة الفقهاء مستحدثات جديدة تُعرض أمامهم، ويُطلب منهم أن يحكموا فيها بين الناس، فيُلزمهم هذا الأمر بالاجتهاد والتجديد، وإبقاء الشريعة نضرة تؤتي ثمارها بين الناس (*).
المشكلة الثقافية2-4
فكرة موفقة للمؤلف بالمقارنة بين منهج البحث الغربي في دراسة الاسلام قران –حضارة – تاريخ ومنهاج البحث في الكتب المقدسة توراة وانجيل ويمضي بالتساؤل لو عكسنا الامر وحكمنا منهجنا الاسلامي في تراث الغرب لدراسة التورات والانجيل طبعا هذا لم يحدث بسبب انتكاسة الحضارة العربية .
ويدعوا المؤلف الى احياء منهج البحث الاسلامي لان القران الكريم نهى عن رمي الناس بمجرد التهم والظن والوهم والشهادة عليهم بغير حق فالقران سعى الى التحقق وطلب الدليل والبرهان وهناك اكثر من اية تؤكد على هذا الامر وهذا كان سببا في ظهور منهج البحث العلمي التجريبي.
كيف ولد الاسلوب العلمي 2-4-1
ينقل المؤلف راي المفكر (رسل) بان الاسلوب العلمي ولد من زواج تنظير الاغريق واختيار العرب فالإغريق تبنوا الفرضيات والعرب كانوا يقيسون ويفحصون ويشاهدون ويدونون وخلاصة لذلك فالأسلوب العلمي ولد من تزاوج هذان المذهبان .
كان بودنا ان المؤلف يحدد مفهوم الاسلوب العلمي قبل حديثه عن ولادته , فالأسلوب العلمي يعني الطريقة العلمية هي تقنية بحثية تقوم على تطوير النظريات، وصياغة الفرضيات القابلة للاختبار، والاختبار التجريبي، وتعديل النظرية إذا ثبت أن الفرضية خاطئة (**)
القران الكريم ومنهج البحث التجريبي2-4-2
على قدر تعلق الامر بهذا فان المؤلف بين ان الذي لفت نظر العلماء المسلمين للطبيعة وحتهم على الكشف عن اسرارها هو القران الكريم عن طريق استخدام الاختبار والتجريب باستخدام الحواس .
كذلك المسلمون هم من اسس منهج البحث التاريخي قبل علماء الغرب , لكن علماء العرب تخلفوا وعلماء الغرب تقدموا بسبب الاهتمام بطريقة الاستقراء وتخليهم عن منهج الاستنباط والقياس اليوناني.
ان منهجية القرآن المعرفية ـ ونظراً لتلك النسبية التي تحكم الحسـ تدفع إلى تكامل كل من الحس والعقل معاً، بحيث يعمل كل منهما في مجاله المناسب، من غير أن يستغني أحدهما عن معطيات الآخر،فيحدث التفاعل الإيجابي بينهما (8)
* صالح مصطفى , لماذا لا يمكن تطبيق الشريعة في الدولة المدنية الحديثة- مقالة. في الانترنيت.
** مفهوم الأسلوب العلمي, ايمان عبد الحميد , مقالة بتاريخ 3 اكتوبر 2022
تطور الفكر الغربي 2-4-3
استعرض المؤلف بتطور الفكر الغربي بدءا من الايمان بالهة اليونان والرومان الوثنية الى الايمان بالنصرانية فقد كانت الكنيسة حليفة للأقطاع والرجعية ومناهضة للعلم ثم تحول الفكر الى الالحاد الذي يؤمن بالعالم المادي المحسوس والذي يعتبر الانسان حيوان راقي حسب نظرية داروين وسلوكه الجنسي فسرها بنظرية فرويد .
عجز منهج البحث العلمي الغربي وانحرافه2-4-4
المؤلف اجاد في تحديد سبب عجز المنهج العلمي الغربي في احتواء الانسان كروح ونفس وعقل حيث هذه الصفات لا تخضع للاختبار ومشاعره لا يمكن حصرها بالقياس المادي لذا ظهر التفسير التاريخي والاقتصادي والحضاري والجغرافي .
ونتيجة لظاهرة الاستعلاء عند الغربين اتجاه الحضارات الاخرى وخاصة العربية الاسلامية حيث تنكروا لدورها في بناء حضارتهم .
لا نبالغ إن قلنا أن ما من علم تطور وتقدم ليصل إلى ما وصل إليه في زمننا الحاضر إلا وللعرب يد وبصمة في ما وصل إليه، وكان العرب والمسلمين ينطلقون من تعاليم الدين الإسلامي في اختراعاتهم ولذلك اتهم العرب بعلم الفلك لاهتمامهم بمواقيت الصلاة وقدوم شهر رمضان ورصد الهلال فقد بنى العرب المراصد الجوية، كمرصد الخليفة المأمون في دمشق (*))
موقف علماء المسلمين من منهج البحث العلمي الغربي الان 2-4-5
اوضح المؤلف ان علماء المسلمين يقرون بمنهج علمي يركز على الايمان بالله ويقوم على الموازنة بين المؤثرات الروحية والاقتصادية والمناخية والحضارية ويراعي الفطرة والغرائز ويتسم بالموضوعية بعيدا عن العصبية والاستعلاء .
علماءنا يقرون بمنهج علمي يستمد من الكتاب والسنه ومناهج الأصوليين والفقهاء ويرفضون المنهج الغربي بسبب دعوته للألحاد وجذوره المادية .
المشكلة اللغوية 2-5
رغم ان المؤلف تحدث عن اللغة العربية تاريخيا وكيف ان القران الكريم نزل بلغتها وارتفع الاسلام من خلالها ودخلت امم للإسلام فتعلمت اللغة العربية وزاد انتشارها , لكن كان من الواجب على المؤلف إبراز ما تواجهه اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين من تحديات متعددة وفي مقدمتها في هذه الأيام منافسة اللغة الأجنبية (الإنكليزية) لغة هذا العصر التي تهدد الهوية القومية والانتماء للأمة العربية؛ بإضافة إلى ظاهرة الضعف المستشري بين طلبة أبناء الأمة العربية وتفشي اللهجات المحلية على ألسنتهم (9) .
اهمية مراقبة تطور اللغة 2-5-1
شدد المؤلف على اهمية مراقبة تطور اللغة حيث بين انه لا يمكن ترك اللغة تتطور دون المحافظة على لغة القرون الهجرية الاولى , فلغتنا لاتزال بالفصحى والتراث اللغوي يرفدها بالمفردات.
ان التراث القديم هو من يؤثر بارتقاء لغتنا الادبية والحفاظ على اصالتها عليه فالدعوة مرفوضة الى تغير القواعد النحوية والصرفية والبلاغية لدراسة العلوم الشرعية.
زيغريد هونكه , شمس العرب تسطع على الغرب، ، صفحة 131.*
مشكلة البحث العلمي 2-6
على ضوء معيار عدد السكان قارن المؤلف بين قارة اسيا واوربا وبين افريقيا والاتحاد السوفيتي بموضوع انتاج الكتب والتي كانت اوربا والاتحاد السوفيتي هي الاكثر رغم قلة عدد السكان معللا ان الدول المتقدمة ثقافيا هي التي حققت نسبة عالية من الانتاج الثقافي .
المفكر والاستاذ الجامعي 2-6-1
الاستاذ الجامعي هو من يحمل شهادة عليا بعد الدراسة الجامعية وهنا المؤلف يدعوا الى دراسة الانفصال في تحصيل العلم والعطاء العلمي على ان لا يهمل تحقيق التراث في الرسائل الجامعية ويوصي بكتابة البحوث الصغيرة المتنوعة في مصادرها وموضوعاتها ويحصر المؤلف مهمة الاستاذ الجامعي بالإضافة المعرفية والعطاء المستمر لان المهمة هنا تربوية وليس تعليمة فقط .
حقوق المفكرين الادبية والمادية2-6-2
طالب المؤلف بحماية انتاج الاستاذ الجامعي من السرقات في الرسائل الجامعية والكتب الادبية اسوة بحقوق التاليف في الدول المتقدمة واقترح المؤلف بضرورة تشريع القوانين والعقوبات على من يسرق الافكار والمؤلفات.
اعمال مكررة وجهود ضائعة2-6-3
المؤلف يسلط الضوء على ضياع الجهود بالأعمال المكررة للباحثين ويقترح بضرورة تنسيق الجهود وتنوع المواضيع التي تلامس الحياة للحصول على مكتبة تراثية متكاملة .
ويركز الباحث على ان الالتزام الاسلامي يفتح بصيرة الباحث ويحصنه من التفكير بالسرقة الادبية .
البحث والتأليف والحاجة الى دراسة نقدية2-6-4
اقترح المؤلف على ضرورة اعداد دراسة تقويمية شاملة تجيب على الاسئلة التالية :
مدى اهتمام الدراسات بالمشاكل العملية , الجوانب التي تركز وتشبعها والجوانب التي تغفلها ,هل الدراسات مواكبة للحركة الفكرية ومدى التزامها بالمنهج العلمي , كمية النشر المطبوع والمخطوط , ما هو اثر كتب التراث الاسلامي بالناس .
التراث ومشكلة هجرة العقول2-7
بين المؤلف مكانة العلماء في الاسلام بالقرون الاولى وانهم كانوا احرار بالتجوال لطلب العلم وزيادة الاطلاع وهذا ما جاء به القران الكريم والسنة النبوية .لقد كان اجماع العلماء فيما بينهم يولد فيضا من الافكار الجديدة في مختلف العلوم لذا حصل تقدم في الزراعة والصناعات اليدوية ...اما الان فنعاني من هجرة العقول الكفؤة الى الغرب فمثلا 35% من اطباء لندن هم عرب وهناك اعداد كبيرة من اساتذة الجامعات في اوربا وامريكا ولمعالجة هذه الظاهرة يقترح المؤلف بضرورة تقوية الجذور بالحضارة والثقافة العربية وزيادة الوعي والولاء للامة .
الفصل الثالث -3
التراث ومسؤولية الجامعات في العالم الاسلامي -3-1
بين المؤلف ان الجامعات التي انشات في العالم الاسلامي على اساس علماني بحكم تسلط القوى الاستعمارية فانتهجت طابع الحضارة الغربية لاسيما كادر هذه الجامعات هم خريجو جامعات اجنبية لذا لم يكن للإسلام وجود في المناهج العلمية واهتموا بارطو وافلاطون وسارتر وتركوا علماء المسلمين مما ولد فراغ لا يمكن شغلة لغياب المنهج الاسلامي في المنهج .
المؤلف يقترح ما يلي :
تكوين هـيئة تدريس جامعية تكفي لسد احتياجات التعليم الإسلامي، وإعادة صياغة أو تأسيس العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل النظرة الإسلامية الكلية للكون والحياة والإنسان، وتقديم الأدب العربي المعاصر ونظرياته النقدية في إطار إسلامي، وعرض الدراسات الإسلامية الشرعية بالاستفادة من الوسائل التعليمية المتقدمة.
ومن المهام الاساسية دراسة ماضي وحاضر الثقافة الإسلامية، دراسة نقدية لاستجلاء مواطن القوة والضعف، والإفادة من الإيجابيات والتخلي عن السلبيات و دراسة خصائص الثقافة الإسلامية، ومدى ملاءمة طرق التدريس المعاصرة له
والإفادة من تكنولوجيا التعليم على نطاق واسع في التعليم الإسلامي ومراكز البحوث الإسلامية
وضع ضوابط محددة للانفتاح على الثقافات العالمية للاستفادة من تجربة المجتمع الإسلامي الأول في مواجهة الحضارات العالمية.
نحن نقول: جامعة القرويين في المغرب سبقت أوروبا بقرنين وتحتوي على أكثر من 4 آلاف مخطوطة و24 ألف كتاب.
وجامع الأزهر ثاني أقدم جامعة» في العالم ..انهما مساجد للصلاة تحولت الى جامعات .
تلازم التربية والتعليم 3-2
المؤلف بين انه ليس هناك تلازم بين التربية والتعليم بل هناك تلازم بين الهدف التربوي والهدف التعليمي في الجامعات الاسلامية , فمدرسة الحديث في الكوفة كان الرائد فيها ابن مسعود ومدرسة البصرة فيها ابو موسى الاشعري وداب التابعون على نشر العلم كالحسن البصري وابن سيرين ولا ننسى دور احمد بن حنبل في مواجهة الانحرافات في العقيدة .
ان دور العلماء في بناء المجتمع الاسلامي اساس وفعال واليوم نتعرض الى اعتى انواع الغزو في ثقافتنا وحضارتنا ومطلوب من العلماء وقفة مشهودة لمنع انحراف الاجيال عن الاسلام عقيدة وتشريع .
بقي ان نقول وبعد تطور وسائل الاتصال يعد دور المعلم في التعليم الإلكتروني من الأهمية بمكان من حيث كونه المسؤول والمبادر الذي يتدخل بصورة ذكية في المعرفـة لإعـادة تشـكيلها وتوظيفها بصورة بناءة ، تسهم في خلق تعلم حقيقي ، دائم ومتطور في سياق بيئة الصف الدراسي ، إنه المعلم الذي يمتلك عقيـدة منهجيـة تتسـق مـع المستجدات المعرفية والتربوية والتكنولوجية (10)
التربية بالقدوة3-3
المؤلف اوضح وظيفة القدوة التي اتبعها النبي ص واصحابه والتابعين , ففي عصرنا هذا فان الاستاذ الجامعي هو داعية وقدوة للأخرين وليس مجرد موظف وان بالتدريس تتحقق الاهداف التربوية والعلمية معا , كما بين المؤلف ان الثقافة عبارة عن تفاعل بين الانسان والعقيدة والفكر ليظهر اثره في السلوك , فقد يكون الانسان متعلم لكن سلوكه غي سوي , فالتاريخ يحدثنا اول من دعى الى ربط العلم بالسلوك هي ام سفيان الثوري فقد اوصت ابنها به


 لولا العبيد
لولا العبيد
 رازونة متنفس العائلة البصرية لذكريات المدينة التراثية والثقافية
رازونة متنفس العائلة البصرية لذكريات المدينة التراثية والثقافية
 فيرستابن يتوّج بسباق الولايات المتّحدة للفورمولا 1
فيرستابن يتوّج بسباق الولايات المتّحدة للفورمولا 1
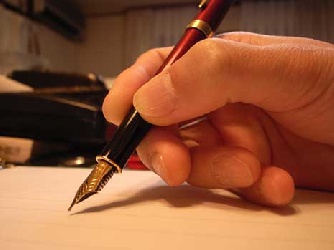 مفاهيم تعيين مارك سافايا ما بين تداعيات الوضع في العراق وتداعيات الوضع في الولايات المتحدة
مفاهيم تعيين مارك سافايا ما بين تداعيات الوضع في العراق وتداعيات الوضع في الولايات المتحدة
 السوداني يقترب من الولاية الثانية
السوداني يقترب من الولاية الثانية
 الفئات العمرية .. الدرس الأول يجب أن نحفظه
الفئات العمرية .. الدرس الأول يجب أن نحفظه
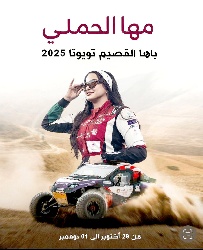 الحملي تشارك في باها القصيم وتشيد بمعالمها التراثية
الحملي تشارك في باها القصيم وتشيد بمعالمها التراثية
 شاناز ابراهيم: المتحف البغدادي نافذة مضيئة على التراث
شاناز ابراهيم: المتحف البغدادي نافذة مضيئة على التراث
