
حين تنظر بغداد إلى مرآتها
فراس عبد الحسين
لم يكن عمر غريبًا عن مدينته، ولا هي غريبة عنه، لكنه كان يشعر دومًا أن شيئًا ما أنكسر بينهما، كأن بغداد التي ولد فيها ليست تلك التي يعيشها الآن. شيء في ملامحها تغيّر، نهرها، هوائها، وجوه الناس، تفاصيل الحياة التي تسير بثقل وجمود. كأنه يمسك بجثة الماضي، لن يتمكن من أعادته للحياة، ولم يجرؤ على دفنه والبكاء عليه.
في مساء شاحب، جالسًا في غرفته الصغيرة، فوق سطح بيت قديم في حي الكرادة. هناك خلف الجدران، كان الضوضاء يتهامس بما تبقّى من حياة. أصوات المؤذنين بدأت تتنازع فيما بينها على مواقيت الصلاة، صخب العائلات المتزاحمة في بيوت ضيقة، وضجيج شوارع تحتضن أناس بملامح متشابهة، قاسية، كأنهم نُحتوا من الخوف ذاته.
سحب دُرجًا صغيرًا من تحت سريره، مسح الغبار من عليه بيد مرتجفة كأنه يمسك شيئًا مقدسًا أخرج منه ألبومًا. ثم، بحذر، قلب صفحاته. كانت هناك، في الصورة الأولى، تبتسم له من عمق الزمن: أمه، ليلى، في ربيعها العشرين، واقفة في ساحة الجامعة وسط زملاء وزميلات. ترتدي قميصًا أبيضًا وتنورة رمادية بالكاد تصل إلى ركبتيها، وشعرها الكثيف يطير مع الريح بحرية، كأن النسيم حينها لم يكن يحمل رهبة. وفي عينيها بريق حياة حقيقية، لا ادعاء فيه، ولا خوف. وخلفها بغداد أخرى، بألوانها، بصخبها المتحرر، بحضورها الذي لا يشبه شيئًا مما تبقّى. بشباب وجهها الذي شاخت ملامحه، مثل وجه أمه.
قلب الصفحة. صور أخرى: حفلة تخرّج، نزهة على ضفاف دجلة، تجمعات أصدقاء ضاحكين، أمه تضحك في كل واحدة منها، كما لو أنها لا تعرف معنى الخوف. هي لم تكن امرأة منفلتة، بل كانت امرأة حرّة ضمن مجتمع صحي، قبل أن يصاب بالأمراض الخبيثة التي منعت الكثيرين اليوم حتى من استيعاب ما كان يحصل.
عمر لم يكن يبحث عن حنينٍ عابر، ولا عن ذكريات فاتنة. كان يفتش عن إجابة: متى تغيّر كل شيء؟ كيف استبدلت المدينة حرّيتها بالخضوع؟ كيف تعلمت المرأة أن تنكمش. ومتى صار جسد الإنسان مشروع خطيئة يجب تغطيته، بدلًا من أن يكون مرآة للجمال والكرامة؟
خارج الغرفة، كان الصمت أثقل من أن يُحتمل. أخته الصغيرة، نور، لم تتجاوز الثانية عشرة، لكنها كانت ترتدي الحجاب منذ عامين. لم يكن ذلك قرارها. لقد قيل لها إن الزمن تغيّر، والحجاب صار ضرورة، والتي لا تلتزم به تخسر احترام الناس وربما أكثر!
لم يكن الخوف وليد اللحظة، بل تراكمٌ طويل لبناء اجتماعي متين، عرف كيف يزرع الطاعة في روح الطفولة، دون أن يُتهم بشيء قبيح.
تأمل وجه أمه في الصور، ثم تمعن وجه أخته في الواقع. ليس بينهما عمر بأكمله فقط، بل بون شاسع من الشجاعة وأثبات الوجود. الأولى عاشت كما أرادت، فضحكت. والثانية تتعلّم كيف تُخفي ضحكتها، لأن صوتها عورة.
المجتمع الذي نشأ فيه عمر، كان يُحسن ارتداء الأقنعة. يتحدّث عن الفضيلة ويغتصب الفرح، يقدّس الحياء ويبرّر القمع، يتغنّى بالشرف ويغط بالخطأ. يرى في كل حرية تهديدًا، وفي كل اختلاف جريمة. وها هو يقطف ثماره: خوف ينساب من خلال الجدران، في الأجساد، وفي العيون التي صارت تعرف متى تمعن النظر ومتى تغض البصر.
لم يكن عمر قديسًا، ولا ثائرًا. كان فقط شخصًا يريد أن يعيش حياة عادية بلا رقابة. أن يلبس ما يحب، ويسمع الموسيقى دون أن يُتَّهم بالكفر. ويكتب أفكاره وما يدور في ذهنه دون أن يُراقب اسمه أحد. الحلم بعيش حياة طبيعية صار شكلًا من الرفاهية.
كان يعرف أن المجتمع لا يكره الحريّة، بل يخشاها. وأن ما يُروَّج من أخلاق هو في جوهره هندسةٌ للخوف، تتوارثها الأمهات عن جروحهن، وتغرسها في بناتهن كما تُغرس الأشجار في أرضٍ عقيمة.
في داخله، كانت تتصارع صورتان: صورة أمه الشابة، وضحكتها التي تشبه حريّة الطير، وصورة أخته الصغيرة، بعينين تُدرَّبان على الحذر، وجسدٍ يُلقّن منذ الآن كيف يكون "مقبولًا" لدى الآخرين. كان يشعر أن مهمته ليست في إقناع أحد، بل فقط في ألّا يخذل ذلك الجزء من نفسه الذي لا يزال يؤمن أن الجمال فضيلة، وأن الله يحب الجمال.
خرج إلى شارع المتنبي. وجلس في المقهى القديم، الشابندر، الذي ما زال يحمل بقايا الزمن الجميل. جلس على الكرسي الخشبي، أخرج دفتراً وقلماً. كتب عنواناً كبيرًا: "حين تنظر بغداد إلى مرآتها". وبدأ يكتب: كيف أن المدينة، حين تنظر إلى صورها القديمة، تخجل من ذاتها.
لم يكن عمر يحكي قصة شخصية، بل كان يرسم خريطة الاغتراب العام. عن الجسد الذي لم يعد ملك صاحبه. عن الضمير الذي صار يُدار بجهاز تحكم خارجي. عن النساء اللاتي يقتنعن تدريجًا أن العار في أجسادهن، لا في أعين المتحرشين. عن الأطفال الذين يتعلّمون أن الفرح مريب، عن الابتسامة التي يجب أن تمر من بوابة الخوف والحذر.
كان يكتب ويحفر في ذاكرة مدينة تنسى نفسها يومًا بعد يوم. عن أمه التي خضعت في النهاية، ارتدت الحجاب وأجبرت أبنتها على ارتداه؛ خوفًا من "كلام الناس". لا لأن إيمانها زاد، بل لأن خوفها قد تضاعف.
وكتب عن نفسه، ولم يصف ذاته بالبطل، بل شاهد على عصر جميل قد مات: شاب يريد فقط أن يعيش كما عاش أهله في زمن كان يراه جميلا يُسمى "حرية"، قبل أن يُعاد تصنيفه اليوم بأنه "فساد"
وعن أخته.. تلك الفتاة الصغيرة التي لم تختر شيئًا بعد. والتي يراها تترنح بين صورتين: صورة طفولتها التي هي في طريقها للتلاشي، وصورة المجتمع الذي يصنع منها نسخة باهتة، لتنضم لبقية نساء الحذر.
وفي اللحظة التي بلغ فيها السطر الأخير، أدرك عمر أن التغيير لا يبدأ بالشعارات، ولا بالمعارك الكبيرة، بل بفكرة صغيرة تُزرع في قلبٍ واحد.
عاد إلى البيت، ولم يقل شيئًا. في المساء، رآها تقف أمام المرآة، ترتب من حجابها، وتتحقق من ستر يديها. وقف في الباب بصمت، لم يعارض، لم يعظ، لم ينبس ببنت شفة. نظر إليها فقط كأنه ينظر إلى زهرة زُرعت في قفص.. ثم تركها.
وفي الليلة التالية، حدث ما لم يتوقعه. طرقٌ خفيف على بابه. ثم دخولٌ هادئ.
رآها تدخل، وفي يدها صورة من الألبوم. جلست بصمت. وضعت الصورة أمامه.
كانت الصورة لأمه، بفستانها الرمادي، وسط زملائها. لم تتحدث. لكن عينيها قالتا كل شيء.
لم يكن في الموقف أي بطولة. لم تخلع الحجاب. لم تصرخ في وجه أحد. لكنها نظرت إلى الصورة، هي من تاريخ مضى ومستقبل ممكن. وهنا، أدرك عمر أن كل ما كتبه، وكل ما أصر عليه، لم يكن عبثًا.
في صباحٍ لاحق، وقفت نور أمام المدرسة. ترددت. يدها تمسك بطرف الحجاب. قلبها يرتجف، لا خوفًا من الناس، بل خوفًا من نفسها. ثم، فجأة، تركته يسقط.. ودخلت المدرسة.
لم يرها عمر، لكنه شعر بذلك. كأن شيئًا في المدينة قد تنفّس.
عاد إلى الألبوم. قلب صفحاته من جديد. في كل صورة، لم يرَ ماضيًا. بل رأى احتمالًا.
بإمكانية أن تكون الحياة شيئًا آخر، إذا تجرّأ أحد أن يعيشها كما يجب.
كتب جملة أخيرة في دفتره: بغداد، حين تنظر إلى مرآتها، لا تبكِ.. بل تتذكّر.


 إستحداث كليتي التميز والذكاء الإصطناعي في بغداد
إستحداث كليتي التميز والذكاء الإصطناعي في بغداد
 عمليات بغداد: خطة الأربعينية لا تتضمن أي قطوعات
عمليات بغداد: خطة الأربعينية لا تتضمن أي قطوعات
 دعوات إلى منح الصحافة دوراً فاعلاً في مجال التثقيف الصحي
دعوات إلى منح الصحافة دوراً فاعلاً في مجال التثقيف الصحي
 عندما تتحوّل اللعبة إلى أسلوب حياة
عندما تتحوّل اللعبة إلى أسلوب حياة
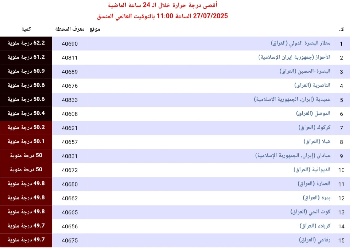 موجة حر قاسية تخيّم على الأجواء ودعوات إلى تعطيل الدوام
موجة حر قاسية تخيّم على الأجواء ودعوات إلى تعطيل الدوام
 عراقي من أربيل يتبرع إلى غزة بـ 110 ألف دولار
عراقي من أربيل يتبرع إلى غزة بـ 110 ألف دولار
 العتبة العباسية تنظم برامجاً لإستقبال وفود أكاديمية من بغداد
العتبة العباسية تنظم برامجاً لإستقبال وفود أكاديمية من بغداد
 حين يضل المثقف طريق التحرير
حين يضل المثقف طريق التحرير
