
الفجوة الابستمولوجية.. تلاقي اللسانيات الأدبية وما بعد النقد
عادل الثامري
مقدمة
خلال العقدين الأخيرين، برز ما بعد النقد كتحدٍّ موجَّه إلى النقد الأدبي التأويلي، بالتزامن مع تطوّر أدوات تحليلية تهتم بخصائص اللغة المادية وأساليب معالجة النصوص على مستوى البنية السطحية. ورغم هذا التطوّر المتوازي، ظلّ هناك نوع من العزلة الغريبة بين الدراسات اللسانية من جهة، ودراسات ما بعد النقد الأدبية من جهة أخرى، على الرغم من التوافق النظري الملحوظ بينهما. فكلا المجالين يُبدي شكوكًا تجاه نماذج العمق في تحليل النصوص ويُفضّل مقاربات تُركّز على الظاهر والمادي في اللغة، كما يتشاركان في تجاوز مركزية الوظائف المرجعية للنص لصالح دراسة آثاره وملامحه الأسلوبية والتداولية. يثير هذا الغياب أسئلة نقدية حول الفرص التي يتيحها الجمع بين مناهج ما بعد النقد والأدوات اللسانية لتحليل النصوص خارج الأطر التأويلية، بما يفتح إمكانات جديدة لفهم النص الأدبي عبر مقاربات غير نفسانية أو أيديولوجية تُعيد الاعتبار إلى سطح النص وعلاقاته المادية بوصفها موقعًا للإنتاج والمعنى في آن واحد.
عندما قدّمت شارون ماركوس وستيفن بيست مفهوم "القراءة السطحية" عام 2009، دعوا إلى تبنّي أساليب نقدية تُركّز على ما هو واضح وملموس وقابل للرصد في النصوص، بديلاً عن النزعات التأويلية التي تسعى إلى الكشف عمّا يُفترض أنه مخفي أو مضمر. وفي السياق ذاته، طوّرت لسانيات النص أدوات تحليلية متقدمة لوصف الأنماط اللغوية والبنى السطحية للنصوص دون الحاجة إلى ادعاءات تأويلية، بينما أتاح علم الصوتيات تحليل الخصائص المادية للغة المنطوقة، وقدّم التحليل البروسودي خرائط دقيقة للإيقاع والنبر كنظم يمكن قياسها وتحديد وظائفها داخل الخطاب. ومع ذلك، ظلّت هذه الابتكارات المنهجية تسير بمعزل عن بعضها البعض، إذ لم تُترجم إلى تكامل عملي بين الدرس اللساني والدراسات الأدبية ما بعد النقد، حتى مع تطوّر علم الدلالة والتداولية في تقديم مقاربات معقدة لآليات نشوء المعنى من خلال التفاعل اللغوي والعوامل السياقية المحيطة. إن هذا التوازي المنفصل يكشف عن إمكانية إعادة التفكير في العلاقة بين الدراسات اللسانية وما بعد النقد، بما يسمح بصياغة مقاربة جديدة تتناول النصوص بوصفها أحداثًا لغوية مادية دون الانزلاق نحو تفسيرات عمق تتجاوز ما يتيحه النص نفسه.
تحاجج هذه المقالة بأن غياب الحوار المستدام بين ما بعد النقد واللسانيات لا يعكس مجرد فجوة مؤسسية أو تباين في التخصصات، بل يكشف عن انقسام إبستيمولوجي أعمق حول طبيعة المعرفة النصية وحدودها. فقد أعاق هذا الانقسام أي إمكانية لتوليف منهجي مثمر، على الرغم من الاهتمامات المشتركة والرؤى التكاملية التي يتبناها كلا المجالين بشأن كيفية عمل اللغة بما يتجاوز النماذج المرجعية البسيطة. إذ تظل الدراسات ما بعد النقد حذرة من الادعاءات العلمية أو التفسيرية الكلية، بينما تميل اللسانيات إلى الحياد الوصفي الذي يتجنب الانخراط النقدي مع النصوص بوصفها ممارسات ثقافية وأيديولوجية في آن واحد. ومن خلال دراسة الالتزامات الإبستيمولوجية التي أبقت هذين المجالين منفصلين، يمكننا أن نبدأ في تصور شكل "اللسانيات ما بعد النقدية" بما هي إطار يتجاوز حدود التخصص التقليدي، إذ لا يمثّل هذا التوليف مجرد تعاون متعدد التخصصات، بل يعيد التفكير في أسس إنتاج المعرفة النصية نفسها، ويعيد موضعة النص كحدث لغوي ومادي مفتوح على تفاعلات القراءة، دون أن يخضع لأفق تفسيري واحد أو عمق نظري مطلق.
المشروع الإبستيمولوجي لما بعد النقد
انبثق ما بعد النقد من أزمة تأويلية طالت الدراسات الأدبية، تجسدت في شكوك متزايدة تجاه المعرفة التأويلية كأسلوب أساسي لفهم النصوص الأدبية. وقد بلور كتاب ريتا فيلسكي حدود النقد (2015) هذا الاستياء بوضوح، مجادلًا بأن المناهج النقدية السائدة منذ ستينيات القرن الماضي باتت ارتيابية بشكل منهجي، تنزع إلى الكشف المستمر عن الأيديولوجيات الخفية أو البُنى اللاواعية التي يُفترض أنها تستتر خلف سطوح النصوص. وترى فيلسكي أن هذه النزعة التأويلية قد قيدت ممارسات القراءة الأكاديمية، مختزلة إياها إلى نشاط متكرر يهدف إلى الكشف عن المعاني المستبطنة بدلًا من الانخراط الحر مع إمكانيات النص المتاحة.
ولا تقتصر الرهانات الإبستيمولوجية لما بعد النقد على التفضيلات المنهجية، بل تؤسس لعلاقة جديدة مع المعرفة النصية نفسها. فعندما يدافع شارون ماركوس وستيفن بيست عن مفهوم “القراءة السطحية”، فإنهما يطرحان تصورًا بديلًا جذريًا، يرفض فكرة اختراق السطوح سعياً خلف عمق مزعوم، لصالح الاهتمام بما هو ظاهر وظاهر فحسب. ويؤشر هذا التحول إلى انتقال من المعرفة التأويلية إلى المعرفة الوصفية، ومن العمق إلى السطح، ومن منطق الشك المستمر إلى فضاء الانتباه والملاحظة الدقيقة. ووفقًا لهذا المنظور، تصبح القراءة السطحية ممارسة تركز على الواضح والملموس والقابل للفهم، بدلًا من الغوص وراء ما يُعتقد أنه خفي ومضمر.
وقد عززت هيذر لوف هذا المشروع الإبستيمولوجي عبر كتابها قريبًا لكن ليس عميقًا، مستفيدة من مناهج العلوم الاجتماعية القائمة على الملاحظة كنموذج للقراءة الأدبية. جادلت لوف بأن الوصف نفسه يمكن أن يشكل نمطًا من التفاعل الأخلاقي مع النصوص، تفاعلًا لا يخضع الظواهر النصية مباشرة للأطر التأويلية، بل يمنحها فرصة للتجلي بوصفها ظواهر لغوية وثقافية قائمة بذاتها. يشير هذا التوجه الوصفي إلى أن المعرفة الأدبية قد تنبع من الاهتمام الدقيق بأسطح النصوص وتفاصيلها المادية واللغوية، بدلًا من السعي الدائم إلى تعميق التأويل أو الكشف عن بنى خفية خلف النص.
ومن الجدير بالذكر أن تحدي ما بعد النقد لنماذج العمق التأويلي يفتح تساؤلات إبستيمولوجية ضمنية حول طبيعة عمل المعنى في النصوص الأدبية. فبدلًا من افتراض أن النصوص تحتوي على محتوى دلالي ثابت في انتظار فك شفرته عبر الممارسات التأويلية، تشير مناهج ما بعد النقد إلى أن الدلالة النصية قد تنبثق من التفاعلات السطحية بين القرّاء والمواد اللغوية للنصوص، بما في ذلك بنيتها الأسلوبية، وإيقاعها، وإشاراتها الظاهرة. يتوافق هذا المنظور مع بعض النظريات التداولية للمعنى التي تركّز على الظهور السياقي لا على المحتوى الدلالي المستقر، رغم أن هذه الصلة ظلّت غير مستكشفة إلى حد بعيد في النقاش النقدي المعاصر.
إن التداعيات الإبستيمولوجية لهذا التحول عميقة، إذ يدفع ما بعد النقد إلى التساؤل عما إذا كان التأويل هو الشكل الوحيد أو الأكثر قيمة لإنتاج المعرفة المتعلقة بالنصوص الأدبية. ومن خلال اقتراح بدائل للمعرفة التأويلية، يفتح ما بعد النقد المجال لعلاقات جديدة مع مادية النص، علاقات تقوم على الانتباه للوحدات اللغوية الملموسة، وللشكل والإيقاع والأسلوب، دون الاضطرار إلى إخضاع هذه الظواهر لأفق تفسيري سابق. ويمثل هذا التحول إمكانًا للتقاطع مع المناهج اللسانية، التي تهتم بوصف خصائص اللغة الشكلية ووظائفها الدلالية وتأثيراتها التداولية، بما يتيح تصور مشروع "لسانيات ما بعد نقدية" تسعى إلى دراسة النصوص الأدبية بوصفها ظواهر لغوية مادية، منفتحة على سياقات القراءة والتلقي، دون فقدان الدقة التحليلية أو الوقوع في اختزالات تأويلية أحادية .
اللسانيات الأدبية: ثبات الأطر التأويلية
على الرغم من تبنّي اللسانيات الأدبية لمنهجيات علمية وتحليلية دقيقة، إلا أنها ظلت، بشكل لافت، ملتزمة بالأطر التأويلية التقليدية حتى في أكثر تطبيقاتها حداثة. فعلى سبيل المثال، تُعد الأسلوبية—بوصفها أحد أكثر فروع اللسانيات الأدبية رسوخًا—نموذجًا واضحًا لهذا الارتباط؛ إذ تُوظف التحليلات الصوتية والنحوية والدلالية لرصد كيفية تحقيق المؤلفين لتأثيرات معينة أو لتوضيح معاني النصوص. وحتى حين يركّز التحليل الأسلوبي على ظواهر لغوية قابلة للقياس—كالأنماط الصوتية، والبنى النحوية، والاختيارات المعجمية—فإن هذه التحليلات غالبًا ما تُسخّر لخدمة أغراض تأويلية تُعيد النص إلى أفق المعنى الثابت أو إلى مقاصد الكاتب المفترضة.
يتضح ذلك عند تحليل الشذوذ الدلالي في قصيدة، حيث تُفكك الأسلوبية التقليدية التعيينات المجازية، والمزج التصوري، وتفاعلات المجالات الدلالية، لكنها تنتهي إلى استعمال هذه الظواهر كأدلة لدعم ادعاءات تأويلية حول مضمون القصيدة أو نوايا الكاتب، ليظل التحليل الدلالي أداة مسخرة لأهداف التأويل بدلًا من أن يُنظر إليه بوصفه شكلًا من أشكال المعرفة في حد ذاته.
أما التحليل التداولي فيطرح تحديات أكثر تعقيدًا أمام إمكانات التفاعل ما بعد النقدي مع النصوص. إذ تدرس التداولية الأدبية كيفية تشكيل السياق للمعنى، وكيفية عمل أفعال الكلام ضمن الخطاب الأدبي، ودور القرّاء في إنتاج المعنى عبر عمليات تأويلية، وهي اهتمامات تبدو، للوهلة الأولى، متوافقة مع تركيز ما بعد النقد على الظواهر السطحية واستجابات القارئ. غير أن التداولية الأدبية تظل، في معظم الأحيان، ملتزمة بتأويل كيفية مساهمة العوامل السياقية في إنتاج معنى النص، بدلًا من اعتبار هذه التأثيرات التداولية بوصفها ظواهر نصية تستحق الدراسة في حد ذاتها دون الانخراط في تفسيرات ما وراء نصية.
وتُقدّم لسانيات النص حالة أكثر تركيبًا، إذ قد تبدو أساليبها الكمية وقدرتها على الكشف عن الأنماط على نطاق واسع منسجمة مع اهتمام ما بعد النقد بالسطوح النصية. ومع ذلك، تبقى هذه المناهج مرتبطة غالبًا بالتأويل الدلالي؛ فعندما يرصد علماء لسانيات النص أنماطًا غير مألوفة في التراكيب أو الترابطات الدلالية أو العلامات التداولية في نصوص أدبية، فإنهم عادةً ما يفسرون هذه الأنماط باعتبارها تُسهم في بناء المعنى العميق للنص، بدلاً من دراستها كأحداث لغوية تستحق الانتباه لذاتها.
وحتى المناهج الإبستيمولوجية التي تدرس دلالة الأدب—من خلال تحليل كيفية معالجة القرّاء للغة المجازية أو بناء النماذج الذهنية استجابة للإشارات النصية—تنتهي عادةً إلى وظائف تأويلية، إذ يُوظف التحليل الدلالي الإدراكي أو المعرفي لإثبات الكيفية التي تحقق بها النصوص تأثيرات محددة أو كيفية بناء القرّاء لمعاني النصوص، لتبقى العمليات المعرفية خاضعة للأطر التأويلية حول أهمية النص.
يعكس هذا التوجه التأويلي ما يمكن تسميته "البقايا الوضعية" داخل اللسانيات الأدبية، أي ذلك الافتراض القائم على أن التحليل اللساني قادر على تقديم معرفة موضوعية حول خصائص النصوص، تُستخدم بدورها لدعم الادعاءات التأويلية اللاحقة. وحتى مع استخدام نماذج تجريبية معقدة تراعي التعقيد الدلالي والسياقات التداولية، تظل اللسانيات الأدبية تفترض أن وظيفتها الأساسية هي تفسير الظواهر النصية، لا مجرد وصفها أو الاهتمام بها بوصفها أحداثًا لغوية قائمة بذاتها.
المواجهة الإبستيمولوجية
يعكس غياب الحوار بين ما بعد النقد والتحليل اللساني تضاربًا في الالتزامات الإبستيمولوجية ثبتت صعوبة التوفيق بينها، خصوصًا فيما يتعلق بمسائل المعنى والمرجعية والتأويل السياقي. فبينما يشكك ما بعد النقد في أولوية المعرفة التأويلية بوصفها الشكل الوحيد للفهم النقدي، تفترض اللسانيات التقليدية أن الوصف المنهجي الدقيق ينبغي أن يؤدي إلى التأويل باعتباره الغاية النهائية للتحليل. وبينما يدعو ما بعد النقد إلى الانتباه إلى الظواهر السطحية للنصوص والاهتمام بتفاصيلها الظاهرة، تسعى اللسانيات إلى تحديد البنى والأنظمة الكامنة وراء هذه الظواهر. وفي حين يتبنى ما بعد النقد تواضعًا منهجيًا يقر بحدود المعرفة النقدية، غالبًا ما تدّعي اللسانيات الدقة العلمية والموضوعية في نتائجها.
تتجلى هذه المواجهة الإبستيمولوجية بطرق متعددة، وتزداد تعقيدًا عند النظر إلى الأبعاد الدلالية والتداولية. أولًا، هناك اختلاف جوهري حول طبيعة المعرفة المشروعة بالنصوص الأدبية: يرى بعض منظّري ما بعد النقد أن التحليل اللساني موضوعي على نحو ساذج، ولا يتمتع بقدر كافٍ من التأمل في افتراضاته النظرية، خصوصًا فيما يخص طبيعة المعنى والسياق. وفي المقابل، قد يرى اللسانيون أن مقاربات ما بعد النقد تفتقر إلى الدقة المنهجية والصرامة التحليلية، ولا توفّر إجراءات منظمة لتحليل الظواهر النصية، خصوصًا فيما يتعلق بالتأثيرات الدلالية والتداولية.
ثانيًا، يختلف المجالان في مقاربتهما لوظائف اللغة في صنع المعنى؛ إذ يمتد تشكيك ما بعد النقد في العمق التأويلي إلى الشك في التحليل الدلالي ذاته، معتبرًا إياه شكلًا آخر من أشكال الاختراق التأويلي لما وراء سطوح النصوص. بينما تنطلق الدراسات الدلالية، حتى في أكثر أشكالها تعقيدًا، من افتراض أن المعنى موضوع مشروع للتحليل، سواء بوصفه محتوى دلاليًا ثابتًا أو تأثيرات تداولية ناشئة سياقيًا.
ثالثًا، يطرح التحليل التداولي تحديات خاصة أمام إمكانية التفاعل ما بعد النقدي، رغم تقاطع الاهتمامات أحيانًا في التركيز على السياق واستجابة القارئ. إذ تدرس التداولية كيف يُشكّل السياق المعنى، وكيف تعمل أفعال الكلام في الخطاب، وكيف يساهم القراء في إنتاج المعنى عبر عمليات تأويلية. ومع ذلك، عادةً ما يلتزم التحليل التداولي بتفسير كيفية مساهمة العوامل السياقية في المعنى النصي، بدلًا من دراسة التأثيرات التداولية بوصفها ظواهر قائمة بذاتها تستحق الوصف المستقل دون إخضاعها للتأويل.
رابعًا، ثمة تباين منهجي واضح حول مقاربات التحليل الدلالي والتداولي؛ إذ تميل مقاربات ما بعد النقد مثل "الوصف الدقيق" و"القراءة السطحية" إلى مقاومة المنهجية الصارمة، وغالبًا ما تتحاشى الانخراط في عمليات بناء المعنى، في حين تعتمد المناهج اللسانية على إجراءات تحليلية منظمة قابلة للتكرار، تتطلب غالبًا تحليلات دلالية وتداولية دقيقة. يمثل هذا الفارق عائقًا عمليًا أمام إمكانات التوليف: كيف يمكن للباحث الجمع بين الالتزامات الإبستيمولوجية لما بعد النقد والدقة التحليلية اللسانية، خصوصًا عند دراسة كيفية نشوء المعنى من التفاعل النصي؟
وأخيرًا، تُكرّس العوامل المؤسسية هذه الانقسامات الإبستيمولوجية؛ إذ يعمل دارسو الأدب واللسانيون عادةً في أقسام أكاديمية منفصلة، وينشرون في مجلات علمية مختلفة، ويشاركون في مؤتمرات تخصصية متباينة. تساهم هذه الحدود المؤسسية في إعاقة تطوير الخبرة المتعمقة في كلا المجالين، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار المواجهة الإبستيمولوجية حول الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالمعنى والتأويل والمنهج التحليلي في دراسة النصوص الأدبية.
نحو توليف إبستيمولوجي
يتطلب سد الفجوة بين ما بعد النقد والتحليل اللساني تطوير أطر إبستيمولوجية جديدة قادرة على الجمع بين الاهتمام الدقيق بالخصائص المادية للغة والتشكيك في النزعات الشمولية للتأويل. وتزداد تعقيدات هذا التوليف عند تناول الأبعاد الدلالية والتداولية، لما لهذين المجالين من ارتباط وثيق بالممارسات التأويلية في الدراسات الأدبية واللسانية على حد سواء.
يمكن لهذا التوليف أن يبدأ بما يمكن تسميته "اللسانيات ما بعد الوضعية"، أي تحليلات لسانية تحافظ على الصرامة المنهجية مع إقرار صريح بموقفها النظري وافتراضاتها المسبقة. وتشمل هذه المقاربة مناهج "ما بعد الدلالة"، التي تدرس عمليات إنتاج المعنى وانتشاره وتلاشيه في التفاعلات النصية دون إخضاع هذه العمليات مباشرة لأطر تأويلية مغلقة. بدلًا من التساؤل المستمر عن “معنى” النصوص، يركز تحليل ما بعد الدلالة على كيفية ظهور المعنى كظاهرة سياقية، وعلاقته بالإيقاع والأسلوب والبنى السطحية.
وبالمثل، يمكن لتحليل "ما بعد التداولية" دراسة التأثيرات السياقية دون تحويلها إلى ادعاءات تأويلية قاطعة، من خلال وصف الكيفيات التي تُنتج بها العوامل السياقية تجارب تفاعلية محددة وتشكل عمليات القراءة، وتولّد تأثيرات معرفية وعاطفية دون افتراض احتوائها على معنى ثابت ينتظر الكشف. ومن شأن هذا التوجه أن يعيد النظر في وظائف السياق والعوامل التداولية بوصفها ممارسات مادية في النصوص، وليس فقط كوسائط لتمرير دلالات مضمرة.
وتُقر اللسانيات ما بعد الوضعية بأنه لا وجود لتحليل محايد إبستيمولوجيًا، وأن جميع الأوصاف اللغوية تنطوي على عمليات انتقاء وتأكيد قائمة على موقف نظري محدد. ومع ذلك، لا ينبغي أن تُقوّض هذه الانعكاسية صرامة التحليل، بل تُعزّز من صدقه المنهجي عبر إقراره بحدوده وافتراضاته المسبقة، خصوصًا في قضايا المعنى والتأويل والتحليل السياقي.
في المقابل، يمكن لما بعد النقد أن يطوّر اهتمامًا أكثر استدامة بالخصائص المادية الفعلية للغة، بما في ذلك أبعادها الدلالية والتداولية، بدلًا من الاكتفاء بالنقد المنهجي للمقاربات التأويلية دون تقديم بدائل تحليلية. قد يتبنى "ما بعد النقد المادي" أدوات لسانية لدراسة سطوح النصوص وظواهرها المادية، محافظًا على شكه الإبستيمولوجي تجاه الادعاءات التأويلية، ودون تحويل الظواهر الدلالية والتداولية إلى مجرد مشكلات تأويلية.
وتقدّم المادية الجديدة أطرًا نظرية داعمة لهذا التوليف؛ إذ طوّرت باحثات مثل كارين باراد مناهج "الظواهر المادية" التي تتجنب الثنائية بين الموضوعية الساذجة والمثالية اللغوية، وتقترح إمكانات لتحليل مادي لا يدّعي الوصول إلى حقيقة موضوعية مطلقة. وبالمثل، يتيح اهتمام الأنطولوجيا بوجودية الأشياء وإمكاناتها الذاتية دعم تحليل لساني يعترف بوجود الظواهر المادية للنصوص دون إخضاعها مباشرة لأطر تأويلية بشرية قسرية.
لن يؤدي هذا التوليف الإبستيمولوجي إلى إزالة التوتر بين الوصف والتفسير، أو بين الانتباه السطحي والتحليل الدلالي، لكنه قد يجعل هذه التوترات مثمرة. وبدلًا من النظر إلى ما بعد النقد واللسانيات كمنهجيات متعارضة، يمكن لهذا المشروع أن يطوّر "لسانيات ما بعد نقدية" تتسم في آنٍ واحد بالصرامة المنهجية دون شمولية تأويلية، وبالاهتمام الدقيق بالخصائص المادية للغة مع الانعكاسية النقدية، لتصبح دراسة النص الأدبي ممارسة تحليلية لا تضيّع مادّيته ولا تختزل معناه في التأويل وحده.
كيف يمكن أن تبدو اللسانيات ما بعد النقدية؟
قد تطور اللسانيات ما بعد النقدية عدة برامج بحثية متميزة، تقدم بدائل للمناهج التأويلية التقليدية مع الحفاظ على الاهتمام الدقيق بالخصائص المادية للغة ووظائفها الدلالية وتأثيراتها التداولية.
تدرس "الظاهراتية الصوتية" كيفية تأثير الخصائص الصوتية على التجربة المتجسدة دون تحويل هذه التأثيرات مباشرة إلى ادعاءات تأويلية. وقد يشمل ذلك تحليلاً صوتيًا مفصلًا لقراءات الشعر، مع التركيز على كيفية خلق الخصائص الصوتية لتجارب زمنية محددة، وتأثيرها على أنماط التنفس أو توليد استجابات عاطفية خاصة. يُنظر إلى الصوت كظاهرة مادية تتفاعل مع المحتوى الدلالي دون إخضاع هذه التفاعلات لأطر تأويلية مغلقة.
تتناول مقاربة "الأسطح الدلالية" عمليات بناء المعنى بوصفها ظواهر نصية قائمة بذاتها، لا كمشكلات تأويلية. وقد يشمل ذلك رسم خرائط لكيفية خلق الشذوذ الدلالي لتجارب إبستيمولوجية معينة، وكيف تُولّد الخيارات المعجمية استجابات عاطفية محددة، أو كيف تحدث اللغة المجازية اضطرابات زمنية في عمليات القراءة. يتركز الاهتمام على كيفية عمل الظواهر الدلالية كأحداث مادية تشكل التجربة النصية، لا على معناها فقط.
يحلل "النسيج التداولي" التأثيرات السياقية كظواهر سطحية، لا كبنى تأويلية عميقة. وقد يشمل ذلك دراسة كيفية خلق علامات أفعال الكلام لتجارب تفاعلية محددة، وكيف يولّد الغموض السياقي تأثيرات إبستيمولوجية معينة، أو كيف تؤدي الإخفاقات التداولية إلى لحظات توقف تأويلي. يُنظر إلى الظواهر التداولية كأحداث نصية قائمة بذاتها لا كمشكلات تواصلية يُراد حلها.
أما "الأسطح النحوية" فتتناول البنى النحوية كطوبولوجيات نصية وليست كأعماق تولد المعنى. ويشمل ذلك رسم خرائط لكيفية خلق الأنماط النحوية تجارب قراءة مميزة مثل تسارع أو تباطؤ الإيقاع، سهولة أو صعوبة الإدراك، استمرارية زمنية أو انقطاع. يتحول التركيز من معنى البنى النحوية إلى كيفية عملها كقيود مادية على تجربة القراءة، مع مراعاة تفاعلها مع العوامل الدلالية والتداولية.
يركز بحث "العروض العاطفية" على التأثيرات الجسدية للإيقاع دون أي ادعاءات تأويلية عن الدلالة الشعرية، مثل دراسة تأثير الأنماط العروضية على معدل ضربات القلب أو التنفس والإدراك الزمني، مؤكدًا الإيقاع كقوة مادية تشكل التجربة المتجسدة، مع مراعاة تفاعله مع المحتوى الدلالي والسياق التداولي.
تعتمد "مادية النص" مناهج كمية لفحص النسيج اللغوي دون تحويل الأنماط إلى أدلة تأويلية، بما في ذلك رسم خرائط للأنماط الأسلوبية، الشذوذ في التراكيب اللفظية، التفضيلات النحوية، الارتباطات الدلالية، والعلامات التداولية كظواهر نصية تستحق الاهتمام بذاتها. يركز التحليل الحوسبي على وصف السطوح اللغوية بدلًا من تفسير المعاني النصية.
يتطلب كل برنامج بحثي تطوير مناهج جديدة تجمع بين الدقة التحليلية والتواضع الإبستيمولوجي، مع التركيز على الخصائص المادية للغة ووظائفها الدلالية وتأثيراتها التداولية، متجنبًا التعميمات التأويلية.
خاتمة
إن غياب الحوار بين ما بعد النقد والتحليل اللساني لا يعكس فجوة تخصصية فحسب، بل يكشف انقسامات إبستيمولوجية أعمق تتعلق بالعلاقة بين الوصف والتفسير، وبين السطح والعمق في تحليل النصوص الأدبية. إن الانخراط اللساني في مشروع ما بعد النقد يتيح إمكانات لتطوير مناهج تحليلية دقيقة وغير تأويلية، تراعي الخصائص المادية للغة وتعقيد عمليات صنع المعنى، متجاوزة الاستعارات السطحية التقليدية باتجاه بناء تحليل مستدام للظواهر اللغوية.
ويمثل هذا التوليف فرصة لإعادة التفكير في طبيعة المعرفة النصية والمعنى داخل البيئة الأكاديمية المعاصرة المعتمدة على البيانات، بما قد يساهم في بلورة أشكال جديدة من التحليل الأدبي أكثر دقة وصدقًا وإنتاجية.


 الاعلام وخطاب ما بعد الاصطفاف
الاعلام وخطاب ما بعد الاصطفاف
 إصلاح السياسة النقدية من الإستهلاك إلى الإنتاج
إصلاح السياسة النقدية من الإستهلاك إلى الإنتاج
 تغيير مجرى نهر ديالى لإنتشال جثتي طفلين غرقا منذ 19 يوماً
تغيير مجرى نهر ديالى لإنتشال جثتي طفلين غرقا منذ 19 يوماً
 محور النقد في جلسة ملتقى جيكور الثقافي
محور النقد في جلسة ملتقى جيكور الثقافي
 رحيل خميس الجبارة بعد مسيرة حافلة
رحيل خميس الجبارة بعد مسيرة حافلة
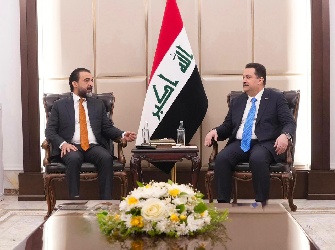 حراك متصاعد للقوى يرسم خارطة المرحلة بعد إنتخاب رئيس الجمهورية
حراك متصاعد للقوى يرسم خارطة المرحلة بعد إنتخاب رئيس الجمهورية
 ميسان: وفاة تلميذ بحادث دهس بعد أدائه الإمتحانات
ميسان: وفاة تلميذ بحادث دهس بعد أدائه الإمتحانات
 سوريا ما بعد الإندماج القسري.. تسوية أمنية أم تصفية سياسية ؟
سوريا ما بعد الإندماج القسري.. تسوية أمنية أم تصفية سياسية ؟
