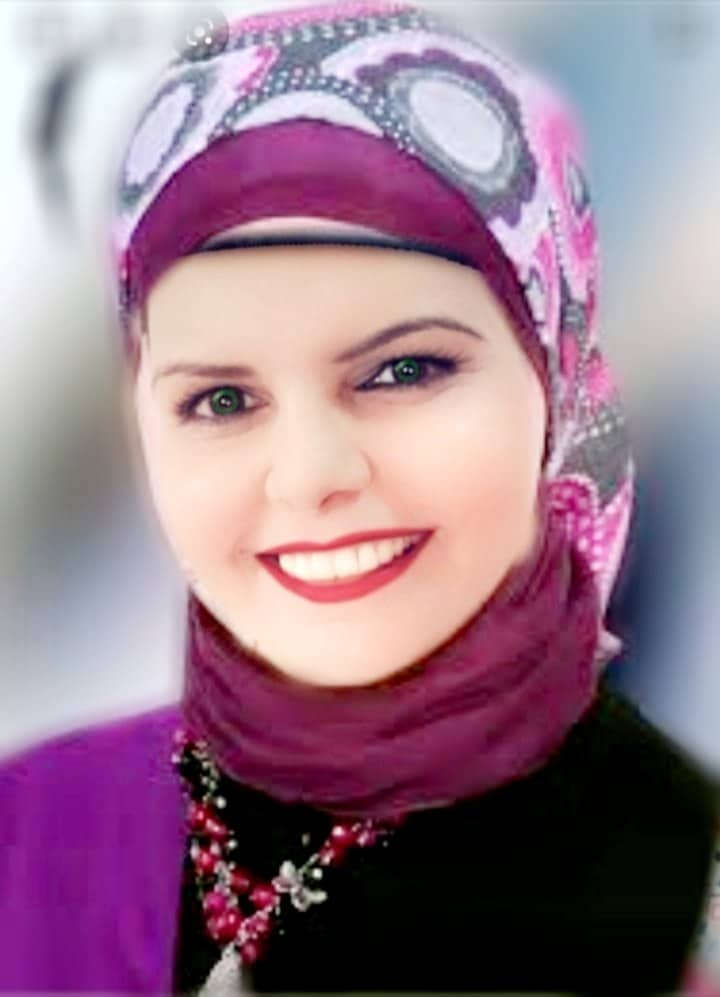
ورقة بحثية تحت عنوان: سياسات المنظومة التعليمية العربية وفلسفة التربية أمام تحديات المستقبل.
رسالة الحسن
تواجه المنظومة التعليمية في الوطن العربي تحديات متشابكة ومعقّدة تفرض على صُنّاع القرار التربوي مراجعة سياساتهم التعليمية، وإعادة صياغة فلسفة التربية بما يتلاءم مع متغيرات الحاضر واستحقاقات المستقبل. فمع تسارع الثورة الرقمية، والتحولات الاقتصادية العالمية، وتزايد البطالة، والاضطرابات السياسية، بات من الضروري أن تنتقل التربية من كونها مجرد نقل للمعرفة إلى أداة للتحرر
الفكري، وبناء الإنسان الفاعل.
القادر على الإبداع، النقد، والتكيّف. ومن هذا المنطلق .
١-فلسفة التربية والسياسات التعليمية هل هي أزمة تأمل
أو رؤية إصلاح تربوية أو أوراش مدرسة المستقبل بين التنشئة الإجتماعية و تدريس تجربة الالتزام من خلال أثر تفكيك جدلية التربية والسياسة؟
إن العلاقة بين فلسفة التربية والسياسات التعليمية علاقة جدلية تقوم على التفاعل بين الفكر النظري والرؤية التطبيقية. حين تغيب الفلسفة التربوية الواعية التي تؤطر السياسات، نجد أنفسنا أمام ما يمكن وصفه بـ "أزمة تأمل"، أي غياب التفكير العميق في الغايات والوسائل، مما يؤدي إلى سياسات تعليمية عشوائية أو مستوردة بلا تأصيل.
لكن في المقابل، إذا ما تم استحضار هذه الفلسفة كأداة نقدية وإصلاحية، فإننا نتحول إلى مشروع رؤية تربوية إصلاحية تسعى لإعادة بناء المدرسة والمجتمع على أسس جديدة، قوامها الإنسان الواعي، القادر على الفعل والمبادرة والالتزام.
فمدرسة المستقبل ليست مجرد مؤسسة لنقل المعارف، بل هي فضاء اجتماعي وثقافي يعمل على تحقيق أمرين رئيسيين:
????التنشئة الاجتماعية: أي إعداد المتعلم للاندماج في محيطه القيمي والثقافي والاجتماعي، دون السقوط في التلقين والانغلاق.
????تدريس تجربة الالتزام: أي تكوين المواطن الفاعل، الذي يمتلك وعياً نقدياً، ويستطيع اتخاذ مواقف مسؤولة تجاه قضاياه ومجتمعه.
وهنا تتجلى أهمية تفكيك جدلية التربية والسياسة، لأن الفهم السطحي لهذه العلاقة قد يؤدي إلى تسييس التعليم أو تسطيحه، بينما الفهم النقدي العميق يسمح ببناء تربية تحررية تؤسس للالتزام لا للتلقين.فالتربية ليست تابعة للسياسة، بل يجب أن تكون قوة نقدية موجهة لها، وإلا فقدت المدرسة دورها الأساسي كمختبر للتفكير الحر، ومساحة لزرع قيم الالتزام، لا الخضوع.
إن السياسات التعليمية حين تنفصل عن فلسفة التربية، تتحوّل من مشروع إنساني إلى إدارة أزمة. وما نحتاجه اليوم هو تأملٌ عميق في معنى التربية، ودور المدرسة، ووظيفة المعلم، لتتحول السياسات من تكيّف مع الواقع إلى فعل تغييري واعٍ.
فالأزمة الحقيقية ليست أزمة تعليم... بل أزمة تفكّر في معنى التعليم ذاته.
فالأزمة ليست في نقص الموارد فقط، بل في غياب الوعي التأملي الفلسفي الذي يُعيد صياغة التعليم كفعل إنساني وجودي لا مجرد وظيفة اجتماعية.
ففي كثير من الأنظمة التعليمية، هناك انفصال واضح بين فلسفة التربية وسياسات التعليم؛ فبينما تقتضي الفلسفة التربوية التفكير في الإنسان ككائن ناقد، حر، قادر على الإبداع والمساءلة، نجد السياسات التعليمية غالبًا ما تُبنى على معايير بيروقراطية، وتُهيمن عليها نزعة الأداتية والاختبارات والتصنيفات.
مثلا:
☄غياب الرؤية الكلية: السياسات تُعالج ظاهر المشكلات (الاكتظاظ، ضعف المخرجات، التقييم) دون الغوص في الأسس الفلسفية للتعليم.
☄الهوة بين النظرية والتطبيق: الفلسفات التربوية تُدرّس في كليات التربية، ولكن لا تُترجم إلى استراتيجيات وسياسات فعلية.
☄التوتر بين الحداثة والتراث: لا تزال كثير من الأنظمة حائرة بين مرجعية تراثية غير مجددة، ونماذج غربية تُطبّق دون تمثل سياقي عميق.
2- هل توجد رؤية سياسية للتربية تعتبر شرطا مسبقا لكل تفكير في الشروط الضرورية التي يجب أن تحدد تربية الذات و الآخرين؟
أن تفكير في تربية الذات والآخرين لا يمكن أن يكون محايداً، بل يحتاج إلى وعي سياسي سابق يُحدد ماذا نريد من التربية، لأي نوع من المواطنين ولمصلحة من. ومن هنا تصبح الرؤية السياسية للتربية ضرورة فكرية وأخلاقية لأي مشروع تربوي حقيقي.
فهنالك رؤية سياسية للتربية تعتبر شرطاً مسبقاً وأساسياً لكل تفكير في الشروط الضرورية التي يجب أن تُحدّد تربية الذات والآخرين، وهي تتجلى في العلاقة الجوهرية بين السياسة والتربية باعتبارهما مجالين متداخلين في صناعة الإنسان والمجتمع. وذلك من خلال:-
????تحديد الغايات الكبرى للتربية: فالسياسة هي التي تحدد نوع المواطن المطلوب في الحاضر والمستقبل، وبالتالي ترسم السياسات التعليمية والتربوية التي تهدف إلى تكوين هذا المواطن.
توجيه المناهج والمعارف: القرارات السياسية تؤثر في اختيار المحتوى التعليمي، القيم المراد ترسيخها، وطبيعة الخطاب التربوي. فالتربية ليست محايدة، بل تعكس اختيارات المجتمع وموقعه من الحداثة، الدين، السلطة، والهوية.
????ترسيم أدوار الفاعلين التربويين: السياسة تحدد مكانة المعلم، المتعلم، الأسرة، والمؤسسة التعليمية، بل وتؤثر في العلاقة بين هذه الأطراف، بما يتماشى مع الأيديولوجيا السائدة.
????إنتاج وعي جماعي: تربية الذات والآخرين ليست مسألة معرفية فقط، بل هي فعل سياسي يسهم في تشكيل الوعي، سواء أكان وعياً ناقداً أم خاضعاً. وبالتالي، من لا يتحكم في التربية، لا يتحكم في مستقبل الوعي المجتمعي.
المفكرون الذين أشاروا إلى ذلك:
ميشيل فوكو: رأى أن التربية أداة لإنتاج الذات ضمن شبكات السلطة والمعرفة.
أنطونيو غرامشي: تحدث عن المدرسة كفضاء للصراع بين الهيمنة الثقافية والتحرر.
باولو فريري: أكد على أن التربية لا تنفصل عن النضال السياسي والاجتماعي.
????توجيه المناهج والمعارف: القرارات السياسية تؤثر في اختيار المحتوى التعليمي، القيم المراد ترسيخها، وطبيعة الخطاب التربوي. فالتربية ليست محايدة، بل تعكس اختيارات المجتمع وموقعه من الحداثة، الدين، السلطة، والهوية.
3- إلى أي مدى سيساهم التفكير في إطاره العام في إرساء أسس اكتساب وتبليغ مختلف أنواع المعرفة، فضلا عن الغايات الكبرى التي ينتظر منها توجيه العمل التربوي؟
إن التفكير في إطاره العام ليس مجرد أداة تعليمية، بل هو شرط بنيوي لأي مشروع تربوي هادف، إذ من خلاله تُكتسب المعرفة، وتُبنى المعاني، وتتحدد الغايات، ويُعاد تشكيل الوعي الجمعي للفعل التربوي.
فالتفكير يساهم في إطاره العام بشكل عميق في إرساء أسس اكتساب وتبليغ المعرفة، كما يوجه الغايات الكبرى للعمل التربوي من عدة زوايا:
???? التفكير كإطار مرجعي لفهم المعرفة:
عندما يُعتمد التفكير كإطار عام، فإنه يسمح بوضع المعارف ضمن سياقاتها الفلسفية، والاجتماعية، والثقافية. وهذا لا يقتصر فقط على المحتوى، بل يشمل أيضًا كيفية التعلم والتفاعل مع المعرفة، أي "تعلم كيف نفكر"، لا "ماذا نفكر".
????تحقيق التكامل المعرفي:
الفكر المنهجي يعزز التكامل بين المعارف العلمية والإنسانية، ويمنع التجزيء أو الانغلاق. فالتربية لا تقتصر على التخصصات المعرفية، بل تسعى إلى بناء إنسان قادر على الربط بين المعارف، وتوظيفها لحل مشكلات واقعية.
???? تعزيز الكفايات النقدية والتأويلية:
عبر التفكير التأملي والنقدي، يتعلم المتعلمون كيف يشككون، ويفهمون، ويعيدون بناء المعنى. وهذا يُعد أساساً في التبليغ الواعي للمعرفة، وفي تكوين مواطنين قادرين على اتخاذ قرارات عقلانية.
???? توجيه الغايات الكبرى للتربية:
التفكير العام يُسهم في تحديد الغايات التربوية الكبرى مثل:
بناء الإنسان الحر والمستقل.
ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية.
تحقيق العدالة المعرفية والتكافؤ التربوي.ومواكبة التحولات الحضارية والرقمية.
???? مأسسة الفعل التربوي على أسس فلسفية وإنسانية:
الفكر يؤطر الفعل التربوي بحيث لا يتحول إلى مجرد ممارسة تقنية أو إدارية، بل يصبح مشروعًا إنسانيًا يروم بناء الفرد والمجتمع وفق رؤية شاملة تتجاوز مجرد الكفاءات التقنية نحو الإنسان الكلي.
واخيرا
فأن المنظومة التعليمية في الوطن العربي تواجه تحديات كبيرة تفرض ضرورة مراجعة السياسات التعليمية وفلسفة التربية. التعليم التقليدي لا يزال قائمًا على الحفظ والتلقين، بعيدًا عن متطلبات سوق العمل، والتفكير النقدي، والتكنولوجيا الحديثة.وتتطلب فلسفة التربية الجديدة التحول نحو تعليم يركز على تنمية المهارات، والتعلم مدى الحياة، والمواطنة الرقمية، مع تجاوز النمط التلقيني إلى تعليم تفاعلي يحفّز الإبداع.
وان أهم التحديات المستقبلية تشمل: الذكاء الاصطناعي، التحولات البيئية، العولمة، والفجوة الرقمية.
ولمواجهتها، يجب إصلاح المناهج، تدريب المعلمين، تعزيز التعاون العربي، واستخدام
تقنيات حديثة في التعليم.
فلا بد من بناء منظومة تعليمية عربية مرنة، حديثة، تصنع إنسانًا قادرًا على الإبداع والتكيف مع متغيرات المستقبل.


 التعليم يفّتتح التقديم أمام خريجي إعداديات الإسلامي
التعليم يفّتتح التقديم أمام خريجي إعداديات الإسلامي
 إستئناف دوري المحترفين بإقصاء النجف أمام ديالى من بطولة الكأس
إستئناف دوري المحترفين بإقصاء النجف أمام ديالى من بطولة الكأس
 الثقافة التوثيقية في مواجهة تحديات الرقمنة
الثقافة التوثيقية في مواجهة تحديات الرقمنة
 التعليم العالي في العراق.. حين يصبح تتويج العلم مرادفاً لعبث الأوراق البحثية
التعليم العالي في العراق.. حين يصبح تتويج العلم مرادفاً لعبث الأوراق البحثية
 الإتحاد الآسيوي يطلق برنامجاً جديداً للإرتقاء بمعايير البنى التحتية
الإتحاد الآسيوي يطلق برنامجاً جديداً للإرتقاء بمعايير البنى التحتية
 العراق ثانياً في البطولة العربية للدرّاجات الهوائية بالسليمانية
العراق ثانياً في البطولة العربية للدرّاجات الهوائية بالسليمانية
 صراع الذات والهوية في كتابات المرأة العربية والغربية .. في السياق التاريخي و الأدب المعاصر
صراع الذات والهوية في كتابات المرأة العربية والغربية .. في السياق التاريخي و الأدب المعاصر
 أبورغيف يقدّم ورقة بحثية في مؤتمر المثقّفين
أبورغيف يقدّم ورقة بحثية في مؤتمر المثقّفين
