
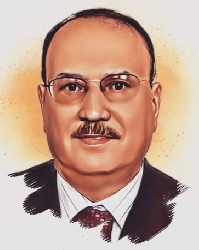
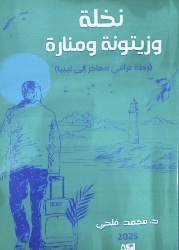
نخلة وزيتونة ومنارة: قراءة في الذاكرة والهوية داخل غضب الغربة
ياس خضير البياتي
صدر عن دار الورشة الثقافية في بغداد عام 2025 كتابٌ لافت بعنوان «نخلة وزيتونة ومنارة» للدكتور محمد فلحي، الإعلامي والأكاديمي المعروف، ليقدّم نصًا مركبًا يتقاطع فيه أدب الرحلة مع السيرة الذاتية، ويغوص في عمق التجربة الإنسانية بين قسوة الغربة وجراح الوطن. هذا ليس كتابًا يُقرأ على عجل، بل هو رحلة في الزمان والوجدان، ومرآة للذاكرة التي لا تنام.
لقد كان من حظي أن أعمل مع المؤلف في صحيفة الجامعة عام 1989، عندما كنت رئيس تحريرها، وشاهدت عن قرب مهنيته، وأخلاقه، وموهبته الصافية.»لم يكن يسعى إلى توهّج زائف، بل كان يضيء من الداخل: من دقته، من احترامه للكلمة، من صمته العميق»
وحين قرأت هذا الكتاب، لم أفاجأ، بل وجدت فيه الامتداد الطبيعي لذلك الصحفي المبدع، الذي حوّل المعاناة إلى أدب، والغربة إلى معنى.
الغربة: منفى أم ولادة جديدة؟
الغربة في هذا الكتاب ليست مجرّد خريطة بديلة أو عبور جغرافي من أرضٍ إلى أرض، بل هي انتقال داخلي يزلزل البنية النفسية والروحية للإنسان. هي لحظة تشظٍّ، وسؤال وجودي يتكرر دون إجابة: هل نحن الذين غادرنا المكان؟ أم أن المكان هو الذي غادرنا؟
في كتاب «نخلة وزيتونة ومنارة», لا تُروى الغربة كحادثة عرضية، ولا كقرارٍ اختياري، بل كمسارٍ إجباري يُعاد فيه اكتشاف الذات بين أنقاض الوطن، وصمت الغريب، وظلال المدن التي لا تشبه دفء الطفولة.
«الغربة ليست ظرفًا عابرًا، بل قدرٌ عربيٌ تشكّل في قلوبنا قبل أن ترسمه الجغرافيا.»هذا التعبير لا يُطلقه الكاتب للتأمل فقط، بل ليؤسس رؤية فكرية تقول إن الغربة ليست طارئًا في حياة العربي، بل صارت امتدادًا شبه طبيعي لتاريخٍ مثقل بالخذلان والهجرة القسرية.
فالغربة في النص ليست فقدًا للمكان، بل تآكُلٌ تدريجي في ملامح الهوية: من أنت حين لا أحد ينطق اسمك؟ من أنت حين تصبح لهجتك غريبة؟ حين تنظر إلى المرآة، وتشكّ أن هذه الملامح ما زالت تعبّر عنك؟
إنها تجربة شطب وانمحاء، لكنها أيضًا لحظة اكتشاف: فكما يقول الكاتب، الغربة تُكسِرُك كي تُعيد صياغتك. إنها المنفى الذي يُعرّي الإنسان من الامتيازات المؤقتة، ويتركه وحيدًا مع جوهره العاري، متسائلًا: من أكون؟ وما الذي ينجو مني حين يسقط كل شيء؟
لكن في المقابل، لا يكتفي النص برثاء المنفى، بل يطرح الغربة كإمكانية للبعث. كأنها رحمٌ آخر يولد فيه الإنسان مرة جديدة، لا بجواز سفره أو جنسيته، بل بكلماته، وذاكرته، وحلمه بأن يكون أكثر حرية.
فالغربة هنا ليست فقط منفى جسدي، بل مختبر روحي يُنقّى فيه الإنسان من الزيف، ليُدرك أن الوطن الحقيقي قد يكون كلمة تُكتب، أو ذاكرة تُصان، أو صورة نخلة تلوّح في الخيال ولا تسقط.
وهكذا، فإن الغربة في «نخلة وزيتونة ومنارة» ليست نهاية، بل عتبة ولادة ثانية، يُولد فيها الإنسان أكثر وعيًا بضعفه، وأكثر احترامًا لذاكرته، وأكثر إصرارًا على أن المنفى لا يقتل من يحتفظ بجذوره، حتى لو حُمِلَ بعيدًا عنها.
السرد بين التوثيق والتأمل
ينقسم الكتاب إلى فصول تحمل عناوين ذات كثافة رمزية ودلالات مزدوجة، مثل: «هاوية الحرية»، «طيور الليل»، «العربة المقطوعة»، «الحافلة رقم ٤»، «الثورة على زعيم الثوار»، «ليلة سقوط العقيد». هذه العناوين لا تُقدَّم كمجرّد عناوين فرعية أو إشارات زمنية، بل كعتبات نفسية تمهّد لدخول عوالم متعددة من الألم والتأمل والتوثيق.
فكل عنوان يختزل لحظة شعورية مشحونة بالتوتر الداخلي، تتقاطع فيها الأسئلة الوجودية مع الأحداث الكبرى. إنها ليست فصولًا تقليدية، بل محطّات وجدانية تكشف التحوّلات في وعي الكاتب، مثلما تكشف تحوّلات العالم من حوله.
يكتب محمد فلحي بضمير المتكلم لا لأنه يريد أن يفرض ذاتيته، بل لأنه يريد إشراك القارئ في وجعه، لا كمتفرج، بل كشاهد حيٍّ يسير في درب الذاكرة. وهذا السرد الشخصي يُعزَّز بتقنية الاسترجاع، حيث لا يمضي الزمن في خط مستقيم، بل يتكسّر كما تتكسّر المرايا القديمة، ويعود الماضي لينير الحاضر، ويطرح أسئلته على المستقبل.
السرد يتأرجح إذًا بين دقة التوثيق وحرارة التأمل. فهو يسجّل الأحداث بوعي المؤرّخ، لكنه أيضًا يقرأها بوجدان الإنسان المجروح. وبين السطور، ينبض النص بحس فلسفي يرى في التفاصيل اليومية إشارات إلى مأساة أكبر: مأساة الانتماء في زمن الغربة، ومأساة الوطن حين يُختصر في طائرة مغادرة، أو شارع فقد ملامحه.
لغة تجمع بين الشعر والتوثيق
يتميّز أسلوب محمد فلحي بلغة ذات طبقتين: طبقة واقعية توثّق الأحداث، وطبقة رمزية تشحن النص بالعاطفة والتأمل. فهو لا يكتفي بأن يكتب «ما جرى»، بل يكتب «كيف شعر» به، وكيف انعكس الخارج على داخله.
تأتي اللغة أحيانًا مثل عدسة صحفية تسجل الوقائع بحيادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مرآة شعرية تعكس وجع الغربة، وقلق الهوية، وحنين الذاكرة. في لحظات كثيرة، تغدو المفردات كأنها تمشي على حافة الشعر والنثر، حيث تمتزج الدقة بالدهشة، والمعلومة بالصورة.
فقوله مثلًا: «الكلمات ليست وصفًا للمكان فقط، بل هي محاولة لفهم الذات وسط العواصف»، يعكس هذا التوازن البديع بين لغة تبحث عن المعنى ولغة تصنع المتعة الجمالية.
وهكذا فأن اللغة في هذا النص ليست مجرّد وسيلة سرد، بل وسيلة مقاومة ضد النسيان، وضد القبح، وضد التهشيم النفسي. وهي في قدرتها على الجمع بين البساطة والعمق، تجعل من التجربة الفردية صالحة للعبور نحو وعي جماعي، يُحسّ ويُفكّر معًا.
رموز لا تموت
يشكّل العنوان الثلاثي لكتاب «نخلة وزيتونة ومنارة» أكثر من مدخل لفظي أو زخرفة شعرية؛ إنه مفتاح تأويلي يفتح للقارئ بوابات النص على اتساعها. كل رمز يحمل طبقات من الدلالة، تتقاطع فيها الجغرافيا بالوجدان، والتاريخ بالذاكرة، والذات بالمصير الجماعي.
النخلة لا تمثل العراق بوصفه وطنًا فحسب، بل بوصفه جذرًا في الروح، يقاوم الاجتثاث، ويظل واقفًا رغم التصحّر والغربة. النخلة في سرديات فلحي ليست شجرة، بل شخصية مقاومة، تشهد على انكسارات الزمان وتحفظ كرامة المكان.
بينما الزيتونة ترمز إلى السلام، لا كواقع بل كحلم يتآكل. إنها صورة من الانتماء العابر للحدود، حين كان البحر المتوسط جسراً حضاريًا لا خندقًا فاصلًا. الزيتونة تمثل امتدادًا روحيًا وثقافيًا، بين المشرق والمغرب، بين المنفى والهوية.
أما المنارة، فهي ليست مجرد برج يشع بالنور، بل هي رمز للمعرفة كخلاص فردي وجمعي. هي ما تبقى حين تسقط الأوطان وتنهار المؤسسات: بصيص الوعي، ونور العقل، ومصباح الثقافة حين يخفت كل شيء.
في هذا العنوان الثلاثي، تتحول الرموز إلى أعمدة سردية تربط بين التجربة الفردية والمعنى الجمعي، وتصوغ من حكاية الغربة رؤية تأملية لوضع الإنسان العربي في زمن التشتت والقلق. وكما يقول الكاتب: «هذه الرموز ليست زينة بل بناءٌ فِكري يحوّل النص من حكاية إلى رؤية». فالنص ليس فقط ما كُتب، بل ما توهّج خلف الكلمات.
وطنان تحت النار
الكتاب يسجل شهادة حيّة على واقعين متصدعين: في ليبيا، عاش الكاتب أكثر من عقد في مدينة البيضاء، وكان شاهدًا على انهيار نظام القذافي، وعلى فوضى ما بعد الثورة، حيث تفتّت الدولة، وضاع الإنسان بين الميليشيات والشعارات.
في العراق، بغداد، كما يرسمها الكاتب، لم تعد تلك المدينة التي نعرفها، بل مدينة تائهة، تشرب من نهرين، لكنهما يفيضان بالألم: الاحتلال، والطائفية، والفساد. في هذه الفصول، لا يُخفي الكاتب ألمه وهو يرى الوطن يُغتال يوميًا أمام عينيه.
في كتابه «، لا يكتب المؤلف سيرته الذاتية بوصفها مشروعًا فرديًا أو اعترافًا شخصيًا، بل يكتبها كـ مرآة مكسورة تعكس وجوهنا جميعًا. الذات هنا لا تنعزل عن الجماعة، بل تذوب فيها، تُروى لتتكلم عن «نحن» لا عن «أنا».
لذلك يتحوّل السرد الشخصي إلى سيرة وطن متناثرة بين الأمكنة، من بغداد إلى البيضاء، من الجامعة إلى المخيم، من التفاصيل اليومية إلى الأسئلة الوجودية. الغربة، الخوف، الطموح المجهض، البحث عن المعنى — كل ذلك يُعاد ترتيبه داخل حكاية تتكلم بصوت واحد: صوت الإنسان العربي المنكسر وهو يحاول أن يقف من جديد.
يحوّل فلحي السيرة إلى ذاكرة جمعية، والذاكرة إلى فعل مقاومة. فهو لا يستعرض أحداث حياته كوقائع ثابتة، بل يعيد تأملها كأحداث تهمّ الجميع، كأن كل قارئ يجد نفسه في لحظة ما من تلك الحكاية: في مطار الانتظار، أو لحظة الانفجار، أو عند النظر إلى وطن بعيد لا يعود. وكما يقول:»لم يكن المنفى نهاية الرحلة، بل بداية لسؤال كبير: كيف نعيد تشكيل ذواتنا حين تُكسر مرآتنا؟»
بلاغة الألم وجمالية السرد
ليس الجمال في هذا الكتاب متأتياً من زخرفة اللغة أو بهرج الأسلوب، بل من الصدق المؤلم الذي يسيل بين السطور. في «نخلة وزيتونة ومنارة»، لا يصوغ المؤلف نصًّا لتأريخ الغربة، بل نصًّا لمقاومتها. إنّه يوثق المعاناة لا ليستعرضها، بل ليحيلها إلى معنى، إلى سؤال، إلى دهشة فكرية وجمالية لا تهدأ.
الجمالية هنا تتجلّى في عدة مستويات متراكبة:
المزج بين الواقعي والرمزي: فحين يصف اللحظة السياسية أو المشهد الحياتي، يتكئ على الرمز كي يعمّق الأثر ويمنح التجربة بُعدًا تأويليًا. كل مشهد يحمل ظاهرًا ماديًا وباطنًا معنويًا، كأن الحياة تُروى مرتين: مرة كما هي، ومرة كما يجب أن تُفهم.
البناء الدرامي المتقاطع زمنيًا: يستخدم الكاتب تقنية التقطيع الزمني والتنقل بين لحظات متباعدة ليصنع تشظيًا سرديًا يعكس تشظي الذات. فالمنفى لا يسير على خط مستقيم، بل يتقاطع داخليًا، كما تتقاطع الذكريات في عقل من يتألم.
اللغة العميقة المشبعة بالصور البلاغية: ليست البلاغة في هذا النص ترفًا لغويًا، بل وسيلة للنجاة، محاولة لتجميل القبح عبر تعريته. كل استعارة هنا هي بوح، وكل صورة هي محاولة لرؤية الواقع من زاوية جديدة.تحويل الحكاية الشخصية إلى وثيقة إنسانية: لا تظل التجربة حبيسة الذات، بل تتسع لتصبح سيرة عن جيل، عن فكرة، عن وطنٍ تكسّرت على أعتاب الغربة. ومن هنا، لا يُقدَّم النص كمذكرات فقط، بل كـ شهادة وجدانية على عصرٍ فقد بوصلته.
يكتب فلحي بحبر الألم وشفافية الذاكرة، ويجعل من تجربته الفردية صوتًا جمعيًا لجيلٍ تشظي بين الأيديولوجيا والاغتراب، بين المنفى والمنفى الداخلي. وبين هذه التقاطعات، تولد بلاغة نادرة: بلاغة من نوع خاص، لا تزخرف الحقيقة بل تُكاشفها، ولا تتعالى على الواقع بل تُغنّيه بأبعاده المأساوية والوجودية.
خاتمة: الكلمة وطن لا يُحتل
إن «نخلة وزيتونة ومنارة» ليس كتابًا عابرًا في أدب الرحلة أو السيرة، بل هو وثيقة ذاكرةٍ تنبض بالحياة رغم الغياب، ومرافعة وجدانية ضد النسيان. إنه لا يُقرأ فقط، بل يُستعاد في كل لحظة بحث عن المعنى، وفي كل خيبة وطنية، وكل غربة تسرق الإنسان من جذوره.
هذا الكتاب هو غرسٌ مضاد للقلع، كأن الكاتب يقول لنا إن المنفى لا يستطيع أن ينتزع من الإنسان قدرته على السرد، ولا أن يغلق فمه عن قول الحقيقة. بل إن أشد لحظات الضياع تُولد فيها الكلمات الأكثر ثباتًا.
النخلة قد تُحرق أو تُغتال، لكنها تقف كظلٍ راسخ في القلب، تذكّرنا أن الأصل لا يُمحى.
الزيتونة قد تُقتلع من الأرض، لكن زيتها، رائحتها، سلامها، تعيش في الذاكرة، تلمّ شتات الانتماء.
المنارة، وإن خُذلت بالحصار، تظل مشتعلة، تفتح للغريب درب العودة إلى ذاته، وتمنحه قبسًا في الظلام.
في زمنٍ عربي يتهدّم فيه البيت، ويضيع فيه الاسم، ويُختطف فيه الوطن من خرائطه وأهله، يجيء هذا النص ليقول لنا إن الكلمة، حين تُكتب بصدق التجربة ونزف الوعي، تصبح وطنًا لا يُحتل، وذاكرة لا تُنسى، ورسالة لا تموت.
فإذا كان التاريخ قد خان الحقيقة، والسياسة قد شوّهت البلاد، فإن هذا الكتاب يعيد للإنسان مكانته كراوٍ للحقيقة، لا كضحية للواقع. ولأن الوطن تأخر، فإن الكتابة أصبحت شكلًا من أشكال العودة، وجسرًا إلى الخلود.
لذلك فأن هذا الكتاب لا يغلق الباب، بل يفتحه على أسئلة جديدة. وعلى ضوء المنارة، وفي ظل النخلة، وتحت سلام الزيتونة، سنظل نبحث عن أنفسنا... لا لنجدها فقط، بل لنرويها من جديد، بالحبر، بالصبر، وبالذاكرة.


 إلى أين تتجه الفنون المعاصرة في العالم الآن
إلى أين تتجه الفنون المعاصرة في العالم الآن
 البارزاني وفيدان يبحثان أوضاع سوريا والتطوّرات الإقليمية
البارزاني وفيدان يبحثان أوضاع سوريا والتطوّرات الإقليمية
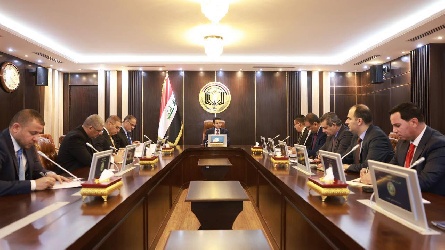 رفع توصية بشأن مكافحة تجنيد العراقيين في الخارج
رفع توصية بشأن مكافحة تجنيد العراقيين في الخارج
 رمضان في الضفة الغربية بين روح العبادة وضيق المعيشة
رمضان في الضفة الغربية بين روح العبادة وضيق المعيشة
 ضبط دجاج مجمّد معد للتهريب في ديالى
ضبط دجاج مجمّد معد للتهريب في ديالى
 الدرّاجات غير المرقّمة فوضى ومخاطر مضاعفة في الشوارع
الدرّاجات غير المرقّمة فوضى ومخاطر مضاعفة في الشوارع
 الشؤون الثقافية تحتفل بيوبيلها الذهبي
الشؤون الثقافية تحتفل بيوبيلها الذهبي
 مربات في معرضه الثاني على قاعة كلية الفنون بابل
مربات في معرضه الثاني على قاعة كلية الفنون بابل
