
القمم العربية.. بين الطموحات الجماعية والنتائج المحدودة
مهند الخزرجي
اعتُبرت القمم العربية، منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، إحدى أبرز أدوات العمل العربي المشترك، حيث تجمع القادة العرب لمناقشة القضايا المصيرية التي تواجه الأمة. ومع أن هذه القمم جاءت في سياقات سياسية واقتصادية وأمنية مختلفة فرضتها مواقف وتوقيتات معينة، إلا أن تقييم مخرجاتها يكشف عن فجوة بين القرارات المتخذة والطموحات الجماعية للشعوب العربية.
وبمراجعة تاريخية سريعة، نجد أن أول قمة عربية رسمية عُقدت في القاهرة عام 1964 بدعوة من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، والتي نظمت لغرض مواجهة التهديد الإسرائيلي بعد إعلان تحويل مجرى نهر الأردن، ودعماً للقضية الفلسطينية من خلال تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.
هذه القمة كانت مفتاح ما تلا ذلك من قمم، وأرست تقليداً لتنسيق المواقف العربية إزاء القضايا الكبرى، لكن سرعان ما بدأت الانقسامات الإقليمية تظهر في القمم التالية.
مراحل تطور القمم: من الوحدة إلى الانقسام
تميزت قمم السبعينيات والثمانينيات بأنها قمم الصراع والتضامن، مثل قمة الجزائر (1973) التي أعقبت حرب أكتوبر، وأقرت استخدام النفط كسلاح سياسي، وقمة بغداد (1978) التي شهدت انقسامًا حادًا بسبب اتفاقية كامب ديفيد، وعلّقت عضوية مصر لاحقاً. إضافة إلى قمة فاس (1982) التي طرحت مبادرة عربية للسلام مع إسرائيل، لكنها لم تنفذ فعلياً .
أما ما يؤشر على قمم التسعينيات، أنها جاءت في ظل التحولات العالمية؛ فمع نهاية الحرب الباردة وغزو العراق للكويت، بدأت القمم تعكس واقعاً عربياً جديداً يتسم بالانقسام الحاد، وخير دليل على ذلك قمة القاهرة عام (1990) التي أيدت تدخل التحالف الدولي لتحرير الكويت، مما عمق الشرخ بين بعض الدول.
الانقسامات والأزمات توسعت مع الألفية الجديدة، لأن القمم العربية بعد عام 2003 شهدت تحولات تعكس التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، مروراً بالربيع العربي، وانتهاءً بتحديات التطبيع، ونفوذ بعض دول الجوار، والصراعات الداخلية في عدد من الدول.
ومن السمات العامة للقمم بعد 2003: الانقسام العربي الواضح بين محاور متباينة، وتراجع مركزية القضية الفلسطينية لصالح قضايا الأمن الداخلي والصراعات الإقليمية بعد تعدد الأزمات في العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، ولبنان، والسودان، يرافق ذلك تصاعد النفوذ الإقليمي والدولي في القرار العربي (إيران، تركيا، روسيا، والولايات المتحدة).
ما الذي ترتب عن هذه القمم؟
من الناحية الإيجابية: استطاعت القمم الحفاظ على إطار الحوار العربي المشترك رغم الخلافات، والتنسيق في بعض الملفات مثل محاربة الإرهاب والعمل الإنساني، وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على مستوى الخطاب.
أما الجانب السلبي أو المحدود ؛ فتمثل في غياب آليات تنفيذ حقيقية لمعظم القرارات، واستمرار الصراعات العربية دون تدخل فعال لحلها، وتراجع الثقة الشعبية في فعالية القمم، إضافة إلى ضعف القدرة على التأثير الدولي مقارنة بالتكتلات الأخرى (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي…).
القمة العربية الرابعة والثلاثون 2025 في بغداد!
تُعقد هذه الايام في بغداد القمة العربية الرابعة والثلاثون، وسط تطلعات كبيرة بأن تكون محطة فارقة في مسار العمل العربي المشترك، نظرًا للظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتحديات التي يمكن إيجازها في: استمرار الأزمات في فلسطين، وسوريا، واليمن، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتحديات اقتصادية وتنموية تواجه العديد من الدول العربية.
إلا أن هذه القمة شهدت اعتذارات من بعض القادة العرب عن الحضور، مما قد يؤثر على مستوى التمثيل والمخرجات المتوقعة، بالرغم من أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الموضوعات المتوقعة على جدول الأعمال تمثل ملفات رئيسية، منها: القضية الفلسطينية، الأزمات الإقليمية، التعاون الاقتصادي، وكذلك الأمن الغذائي والمائي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية.
وبالنظر إلى التحديات الراهنة، من المتوقع أن تخلص القمة إلى إصدار بيانات تضامن، وتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مبادرات مشتركة، إضافة إلى دعم جهود الاستقرار في الدول التي تشهد أزمات.
إجمالا .. لقد عكست القمم العربية بعد 2003 واقعًا عربيًا هشًا، يتسم بالتشرذم وتغليب المصالح الوطنية على القومية. ومع ذلك، فإن استمرار عقد القمم رغم كل الانقسامات، يؤكد أن الإطار العربي لا يزال قائماً كضرورة سياسية ورمزية، لكن تفعيله يتطلب إرادة سياسية جماعية، وإصلاحاً حقيقياً لآليات اتخاذ القرار وتنفيذ المخرجات.


 بين الإنجاز السياسي والإستهداف الممنهج
بين الإنجاز السياسي والإستهداف الممنهج
 فجوة السياسة الكلية بين القطاعين المصرفي والاقتصادي
فجوة السياسة الكلية بين القطاعين المصرفي والاقتصادي
 انسانيتنا بين نسخ ولصق
انسانيتنا بين نسخ ولصق
 ساحة الميدان..بين عبق التاريخ وتحديات الحاضر
ساحة الميدان..بين عبق التاريخ وتحديات الحاضر
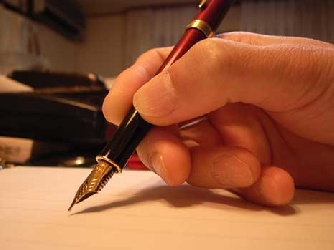 جنون يتجول بيننا وصمت يلفت الضمير
جنون يتجول بيننا وصمت يلفت الضمير
 هدوء حذّر في خبات عقب إشتباكات بين عشيرتين على أراضٍ زراعية
هدوء حذّر في خبات عقب إشتباكات بين عشيرتين على أراضٍ زراعية
 التريند .. بين الشهرة والتأثير
التريند .. بين الشهرة والتأثير
 بين الإحتلال ومشروع الدولة
بين الإحتلال ومشروع الدولة
