
الإعتذار لا يُقاس بحجم الخطأ
فاروق الدباغ
في إحدى قاعات جامعة دالارنا في السويد ، لم يطلب منا أستاذ علم النفس السلوكي أن نحلّل حالة، ولا أن نطبّق أداة تشخيصية، بل طرح سؤالًا بدا لي حينها أكثر إرباكًا من أي امتحان:
تدرّبوا على طلب الاعتذار من أبنائكم.
لم تكن الصدمة في السؤال، بل في ما كشفه داخلي.
أنا ابن بيئة ترى الاعتذار ضعفًا، وتعتبر التبرير مهارة، وتُتقن لعب دور الضحية حين تُحاصَر بالخطأ. وفي ثقافتنا، يبقى أصعب الاعتذارات على الإطلاق: أن يعتذر الأب من ابنه، أو الأم من ابنتها.
حينها كان ابني قد تجاوز الطفولة ودخل مرحلة البلوغ. ثمانية عشر عامًا من العمر، وثمانية عشر عامًا من الذاكرة.
قاومت الفكرة طويلًا. قلت لنفسي: أنا اختصاصي في العلاج المعرفي السلوكي، قطعت مع القسوة والعنف التربوي الذي نشأت عليه، ذلك العنف الذي كان طبيعيًا في المدارس، حين كنا نُضرَب بالمسطرة الخشبية لأننا لم نحفظ جدول الضرب أو أخطأنا في حوار باللغة الإنكليزية (الدايلوك).
عن أي أذى يمكن أن أعتذر؟
ومع ذلك، طلبت من ابني جلسة حوار خاصة.
استغرب كثيرًا. نظر إليّ بدهشة، ثم ابتسم ابتسامة حذرة. وعندما قلت له بهدوء إنني أطلب منه أن يسمح لي بالاعتذار عن أي خطأ ارتكبته بحقه في طفولته، مقصودًا كان أو غير مقصود، ضحك وقال:
لماذا الآن؟
شرحت له السبب. لم أبحث عن طمأنة، ولم أطلب مجاملة. كنت حادًا في طلبي، لأنني أردت الوصول إلى المعنى العميق لكلمة الاعتذار.
في البداية أنكر تمامًا وجود أي شيء يُسمّى Childhood trauma. قال بثقة: لا أذكر شيئًا.
ثم، بعد صمت قصير، قال:
”في الحقيقة… إذا كان لا بد من شيء، فأنا أحمل في داخلي أمرين، لا أمرًا واحدًا”.
توقّف الزمن لحظة.
بدأ بالأول.
قال إنه كان يتذكر تلك اللحظات التي كنت أقرأ له فيها قصة قبل النوم، بالعربية، لأنني أردت أن يعتاد سماع اللغة. كان في سريره، ينظر إليّ بنصف عين مفتوحة، ولاحظ أنني أقلب صفحتين بدل صفحة واحدة.
كنت أسأل نفسي: لماذا بابا يخدعني؟ لماذا يريد إنهاء القصة ولا يقرؤها كاملة؟
ضحكت بدهشة، لا استخفافًا. واعتذرت فورًا عن الشعور الذي زرعته فيه دون قصد. شرحت له أنني لم أكن أخدعه، بل كنت أختصر القصة عمدًا، أُجمّلها بجمل أبسط، حتى لا تُثقله مفردات عربية صعبة، وهو يعيش يومه كاملًا باللغة السويدية، اللغة السائدة في المدرسة والحياة.
ثم انتقل إلى الأمر الثاني، بهدوء أكبر، وكأنه يتحدث عن شيء ظلّ معه طويلًا.
قال:
”أتذكر يوم كنا في أحد مطاعم الوجبات السريعة. طلبتُ وجبة محددة، وأنت رفضت، واخترت لي وجبة على ذوقك، وأجبرتني على أكلها. منذ ذلك اليوم… أنا لا أحب تلك الوجبة”.
تجمّدت.
لا أتذكر الحادثة إطلاقًا. لا المكان، ولا الحوار، ولا الوجبة. بالنسبة لي، لم تكن موجودة أصلًا.
لكنها بالنسبة له كانت حاضرة، كاملة التفاصيل، محفوظة في ذاكرته كإحساس بالإجبار، لا بالطعام.
لم أناقش. لم أبرر. لم أقل إن الأمر تافه.
اعتذرت.
وهنا كانت المفارقة المؤلمة والضرورية:
الأذى لا يُقاس بذاكرة من ارتكبه، بل بذاكرة من تلقّاه.
في تلك اللحظة، لم يكن المهم إن كنت أتذكر أم لا، ولا إن كنت محقًا أم لا. المهم أنني سمعت، واعترفت، وأغلقت ملفين صغيرين، لكنهما كانا مفتوحين بصمت بيني وبين أقرب إنسان إليّ.
ومن هنا يتسع السؤال:
كم من المواقف المشابهة ارتكبناها بحق الزوجة، الأبناء، الأقارب، زملاء الدراسة والعمل؟
كم من كلمات قلناها على عجل، واعتبرناها عابرة، بينما تحولت في ذاكرة الآخر إلى شعور دائم بالإهانة أو الإلغاء؟
وماذا عن الاعتذار عندما لا يكون فرديًا؟
عندما يكون مطلوبًا من سياسي فاسد تجاه شعب كامل، أو من قاضٍ ظالم، أو من محقق أساء استخدام سلطته، أو من رجل دين خدع من وثقوا به واتخذوه قدوة؟
هنا لا يعود الاعتذار مسألة أخلاق شخصية، بل مسؤولية اجتماعية.
فالاعتذار العام ليس بيانًا، بل اعترافًا، وتحملًا للمسؤولية، وضمانًا بعدم التكرار.
علميًا، الاعتذار ليس نوعًا واحدًا. هناك اعتذار شكلي لامتصاص الغضب، واعتذار دفاعي مملوء بالتبرير، واعتذار ناضج يعترف بالفعل والأثر دون شروط.
النوع الأخير فقط هو الذي يُحدث أثرًا نفسيًا حقيقيًا: يخفّض التوتر، يعيد التوازن الداخلي، ويمنع تراكم الغضب الذي يتحول لاحقًا إلى عنف أو قطيعة.
أما التربية، فهي البداية الحقيقية.
عندما نعلّم أطفالنا الاعتذار، لا نعلّمهم الانكسار، بل نعلّمهم تحمّل المسؤولية.
نزرع فيهم وعيًا بأن الخطأ لا يُلغي القيمة، وأن الاعتذار لا يسقط الهيبة، بل يبني الضمير.
فالاعتذار، في جوهره، ليس كلمة تُقال…
بل شجاعة نادرة.
تبدأ من البيت، وقد تنقذ علاقة، أو مجتمعًا كاملًا، من ميراث طويل من الصمت وسوء الفهم


 النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للإنضمام إلى مجلس السلام
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للإنضمام إلى مجلس السلام
 الأمثال والاستشهادات لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي
الأمثال والاستشهادات لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي
 لا إصلاح اقتصادي من دون عدالة اجتماعية
لا إصلاح اقتصادي من دون عدالة اجتماعية
 الازمة المالية تحت مبضع الجراح
الازمة المالية تحت مبضع الجراح
 حينَ يتلاشى التعلّقُ تتجلّى الحقيقةُ
حينَ يتلاشى التعلّقُ تتجلّى الحقيقةُ
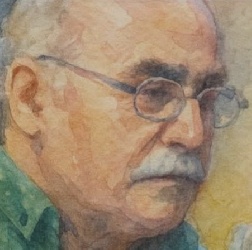 تأملات في الحرب بعصر الاتصال
تأملات في الحرب بعصر الاتصال
 عشائر ميسان تواصل محاربة المخدّرات ودعم حصر السلاح
عشائر ميسان تواصل محاربة المخدّرات ودعم حصر السلاح
 إزدواجية المعايير .. تظاهرات العراق وايران مثالاً
إزدواجية المعايير .. تظاهرات العراق وايران مثالاً
